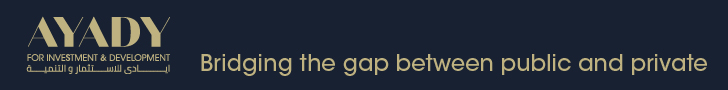عن الاقتصاد السياسي لمشروع مارشال
بقلم ـ د. محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي
نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط

مرت سبعون سنة منذ تدشين خطة التعافي الأوروبي من آثار الحرب العالمية الثانية، والتي اشتهرت بمشروع مارشال.
ومنذ ذلك الحين كلما حلت أزمة اقتصادية طاحنة في بلد أو مجموعة من البلدان حول العالم، نادى منادٍ أنْ نفّذوا مشروعاً مماثلاً لمارشال يقيل الاقتصاد من عثراته، ويعيد هيكلته ويضعه على مسار التقدم. ولعل كثيراً من أولئك المنادين بمثل هذا المشروع قد وصلت شهرته إليهم، ولكنهم يعلمون القليل عنه، إلا تصوراً بأن هذا المشروع رمز للمساعدة الخارجية مُحكمة التصميم إيجابية النتائج.
ولعل إخفاق كثير من مشروعات المساندة الخارجية يستوجب التدقيق في أسباب بلوغ مشروع مارشال ما عجزت عنه مشروعات وخطط لاحقة عليه.
ففي الخامس من يونيو من عام 1947 ألقى جورج مارشال، وزير الخارجية الأميركي وقتها، محاضرة في جامعة هارفارد الأميركية لتكريم دفعة من الطلبة المتخرجين.
حدد مارشال في هذه المحاضرة ملامح خطة لإنقاذ أوروبا من مزيد من التردي الاقتصادي والبطالة وانتشار الفقر، بما قد يؤدي بها إلى فوضى وصراعات سياسية تمهد الأرض لتوغل النفوذ السوفياتي، فيما يتجاوز حدود الستار الحديدي الذي أشار إليه ونستون تشرشل، الزعيم البريطاني، في محاضرة شهيرة له في عام 1946.
كان مارشال رئيساً للأركان في عهد الرئيس فرانكلين روزفلت، ثم الرئيس هاري ترومان خلال الحرب العالمية الثانية، وقد صار معلوماً أن مجموعة عمل كانت تخطط وتدرس في أثناء اندلاع هذه الحرب واشتعال معاركها ضد النازيين ودول المحور، الترتيبات التي ينبغي اتّباعها بعد الحرب لإقرار السلام بعد النصر.
وتتبدى ملاحظات على مشروع مارشال، من حيث الإعداد والتنفيذ والآثار توجزها ست نقاط بمنظور الحاضر واستشرافاً للمستقبل:
أولاً – أن كسب السلام لا يقل أهمية عن الانتصار في الحرب.
وهذا من دروس الحرب العالمية الأولى التي بلورها الاقتصادي الإنجليزي جون ماينارد كينز في كتابه «النتائج الاقتصادية للسلام» الذي حذر فيه من أن العقوبات والتعويضات الضخمة، التي فرضتها «معاهدة فرساي» على ألمانيا، ستؤجج نيران العداوة مرة أخرى بعد تدمير مقوماتها الاقتصادية وزيادة البطالة بين أبنائها واشتعال الأسعار بموجات غلاء، وأن الأحوال الاقتصادية المتردية ستدفع إلى صعود تيارات يمينية متطرفة وصراعات ومواجهة عسكرية حتمية؛ وهو ما حدث.
ثانياً – أن الدول التي تتصدر السباق الاقتصادي عالمياً عليها مسؤولية أكبر تجاه قضايا ما يسمى «الصالح العام» الدولي.
وهذه مسألة فطن إليها الاقتصادي تشارلز كيندلبرغر، أحد مهندسي مشروع مارشال، في تحليله لأزمة الكساد الكبير في فترة الثلاثينات قبل الحرب العالمية الثانية.
فقضايا الصالح العام الدولي، مثل الاستقرار الأمني والمالي والنقدي وأمن حركة التجارة الدولية، هي أمور كان يفترض تاريخياً في كل نظام دولي، قبل الحرب العالمية الثانية، أن تقوم به مجموعة دول تقودها القوى الكبرى. ونعلم أن هذه المهام أُنيطت بمنظمة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية بعد الحرب وفقاً لاتفاقيات ومعاهدات دولية. وقد عجزت بريطانيا عن القيام بهذه المهام، بسبب تأثر اقتصادها بالحرب العالمية الأولى، كما ترددت الولايات المتحدة، التي حلت محلها كصاحبة الاقتصاد الأكبر عالمياً، في القيام بهذا الدور بسبب سياساتها الانعزالية حينها. وأسهم ذلك في حالة الكساد ثم الحرب بعدها، وهو ما أشار إليه مؤخراً جوزيف ناي أستاذ العلوم السياسية بجامعة هارفارد، الذي ارتبط اسمه بمفهوم القوى الناعمة للدول في مد مجال نفوذها وحماية مصالحها.
ثالثاً – أهمية إدراك أبعاد الاقتصاد السياسي وأوضاع التوازن الدولي في تصميم مشروع مارشال.
فلقد كان للمشروع دافع سياسي لم يكن خافياً، خصوصاً مع إرهاصات الحرب الباردة، ألا وهو الإسهام في احتواء وتحجيم المد الشيوعي من خلال إنعاش اقتصادات الدول الحليفة، وزيادة قدراتها التنموية بما يجعلها سنداً لا عبئاً بعضها على بعض.
ولم يكن مشروع مارشال هو المشروع الأول لمساندة التعافي الأوروبي، فقد سبقه مشروع آخر تبناه هنري مورجنثو وزير الخزانة الأميركي، والذي كان يهدف إلى جعل ألمانيا دولة زراعية رعوية لمنعها من بناء قدرات عسكرية، إذا ما انطلقت صناعياً. لكن سرعان ما تبين أن هذا المشروع كارثي، إذ كان من الممكن أن يتسبب بترحيل عشرات الملايين من الألمان خارج بلادهم لظروف بطالة حتمية، وهو ما تفاداه مصممو مشروع مارشال، الذي أصلح البنى الأساسية ومهّد لتقدم اقتصادي شامل.
رابعاً – أن بناء المؤسسات أهم من سخاء المساعدات.
فقد عمد مشروع مارشال إلى بناء الثقة، بدايةً من تدعيم روابط العلاقة الاقتصادية بين مُزارعي الريف ومُصنعي المدن والتجار والبنوك والقائمين على نظم الدفع والتبادل، وذلك بعد زمن من شيوع عدم اليقين وزيادة المخاطر بسبب الحرب.
وفي الوقت ذاته كان هناك إدراك من قبل مصممي مشروع مارشال أن المؤسسات والأوضاع السياسية والاجتماعية ستتطور تدريجياً مع تحسن الاقتصاد ونمو قطاعاته، وأن هناك أهمية لوضع أسس منذ البداية لضمان كفاءة إدارة المساعدات المالية، واستهدافها لقطاعات الإنتاج والخدمات الأساسية. وجدير بالذكر أن مشروع مارشال قد أقام مؤسسات قُطرية وإقليمية وعالمية، ما زال بعضها قائماً حتى اليوم، أو تطور فأصبح على وضعه الحالي مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس، والتي حلت محل منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي.
كما استعان بمؤسسات قائمة كمراكز بحث لتقييم برامجه التفصيلية مثل معهد بروكنغز في واشنطن، أو جهات للمساعدة الإنسانية مثل «كير» التي أُنشئت عام 1945 لتنفيذ بعض مهامه في أوروبا.
خامساً – ضرورة أن يكون برنامج تدفق المساعدات المالية كافياً مستمراً، وليس مجزءاً متقطعاً حتى يؤتي الآثار المرجوة، وتكون معالجته مستهدفة لأسباب العلل الاقتصادية، لا مسكّناً لآلامها.
وفي رصده الموسوعي لمشروع مارشال ذكر المؤرخ الاقتصادي بن ستيل، في كتابه الصادر عنه منذ أسابيع، أن الولايات المتحدة قد قدمت مساعدات تجاوزت 14 مليار دولار لست عشرة دولة أوروبية، على مدار أربع سنوات من عام 1948 حتى عام 1952، وهو ما يعادل حالياً 130 مليار دولار، ولكن كنسبة معادلة من الناتج المحلي يتجاوز هذا المبلغ 800 مليار دولار.
وصاحب هذه المساعدات لمشروع مارشال برامج أخرى لخفض الديون المستحقة على هذه الدول والتنازل عنها، وتفعيل آليات مالية وإدارية لرفع كفاءة المساعدات وحسن استخدامها، بداية من مصادرها مروراً بإدارات الحكومات المركزية، حتى تصل إلى المزارعين والصناع لاستثمارها في الإنتاج ثم تسويتها بمدفوعات مقابل الإنتاج.
سادساً – تفاوتت الدول الأوروبية من حيث استجابتها وتفاعلها مع مشروع مارشال.
فمن حيث وضعها الاقتصادي بعد الحرب شهدت جميعها انخفاضاً في الناتج عما قبلها، تراوح بين نسبة 20% في ألمانيا و46% في فرنسا.
وعانت هذه الدول من مشكلات جسيمة في نقل الغذاء والخامات، لدمار الطرق والموانئ والسكك الحديدية. وتقدّر الدراسات أن مشروع مارشال أضاف إلى هذه الدول ما يقدَّر بنقطتين إلى 7 نقاط مئوية في النمو سنوياً مقارنةً بوضعها من دونه، كما هيأها للولوج في مسار نمو وتقدم مطرد.
واليوم، تظهر تحليلات لتجارب معاصرة للمساعدات في دول أخرى، غير أوروبية، أن نتائجها مخيبة للآمال وضلت فيما سعت إليه، إلا قليلاً، رغم أن قيمها تزيد في أحوال كثيرة على ما أُنفق من خلال مشروع مارشال.
ويعزى هذا إلى أن تلكم الدول، لم تكن على حال أوروبا ذاتها حتى بعد دمار الحرب، فقد كان حظها من التنمية محدوداً، كما افتقدت مؤسسات وطنية ومحلية فاعلة، وغابت عنها سياسات عامة متسقة، يُتابع تنفيذها وما ينفق من خلالها بدقة وحكمة.
كما أن جانباً من هذه المساعدات تلقتها بلدان تعيش في أتون حرب متأججة، أو تعاني من هشاشة تهدد بناء الدولة، وهو ما لا تصلحه المساعدات المالية وحدها، وإن حسنت مقاصدها واتفقت مع أولويات هذه البلدان.
وتعتمد الأهداف الجديدة للتنمية المستدامة، التي وافق عليها قادة الدول في قمة خاصة في عام 2015 بالأمم المتحدة على أجندة لتمويل التنمية، كان أحد محاورها المساعدات الإنمائية الرسمية، التي تقدر حالياً بنحو 145 مليار دولار سنوياً، وفقاً لالتزام دولي لمساندة الاقتصادات الأقل دخلاً. لكن هذه المساعدات، حتى إن زادت قيمتها، كما يرجى مستقبلاً، لن تحقق أهداف التنمية التي تتطلب عشرات أمثال قيمة هذه المساعدات.
فلا غنى للدول التي تنشد التقدم عن تعبئة الموارد المالية المحلية ومشاركة القطاع الخاص في التنمية وفق سياسات منضبطة تقود التنمية في إطار مؤسسي محكم.