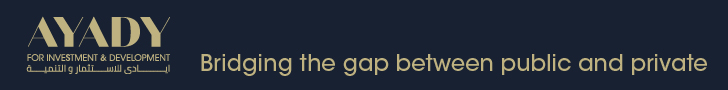بقلم د. محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي
مع كل نهاية لعام وبداية لعام جديد تُراجَع أرقام عن أداء الاقتصاد بين صعود وهبوط وتقدم وتراجع، وتُطرح رؤى وتوقعات مستشرِفة لما ستكون عليه أوضاع الاقتصاد بين متفائل ومتشائم. وتُستحضر أحداث وحوادث من التاريخ لعلها تفيد في استجلاء ما قد يحمله المستقبل.

وفي إصدارها السنوي احتفاءً بالعام الجديد رصدت مجلة «الإيكونوميست» البريطانية، ما يشكّل في اعتقادها أهم المتغيرات الاقتصادية والسياسية، وصدّرت ما رصدته من توقعات خلاصتها أن العالم أصبح أكثر تقلباً من الناحية السياسية وأكثر هشاشة من الناحية الاقتصادية مما كان عليه في عام مضى.

يعلم المحترفون وذوو الخبرة والمهارة من المستثمرين والمنتجين والتجار كيفية التعامل مع مخاطر الاقتصاد والأسواق، فلديهم من الأدوات والوسائل الممكنة للتعامل معها. حتى إذا ارتفعت حدة هذه المخاطر ستجد منهم المستفيد منها بتنوع في النشاط وزيادته في مجال والإحجام عنه في مجال آخر، وإدارة السيولة، وما هو متاح من تسهيلات ائتمانية لاغتنام الفرص والاستحواذ.
أما ما يصيب أهل الاقتصاد بالارتباك والحيرة وتضطرب له أعمالهم، فهو تعرضهم لمناخ يسوده الغموض وعدم اليقين بسبب حالة عدم الثقة التي تنتاب عالمنا المعاصر.
ففي أكثر من محفل عالمي تتردد كلمات تعكس ظاهرة العجز في الثقة، وتجد هذا العجز يمتد بين عموم الناس وحكوماتهم، حتى وإن اختاروها للتوّ بإرادتهم تجدهم وقد انقلبوا عليها مسرعين نادمين على اختيارهم كما رأينا مؤخراً في أوروبا. وترى عجزاً آخر في الثقة بين الحكومات وبعضها البعض حتى وإن ضمّها حلف قديم من الأحلاف التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية.
ومع الاحتفال منذ شهور مضت بالذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، جرت مقارنات بين تطورات بدأت في الظهور مع بدايات القرن الحالي وما جرى في بدايات القرن العشرين.
فبعد التوسع في العولمة ظهر عجز من قِبل المجتمع والسياسة في أوروبا عن ملاحقة واستيعاب تلك التغيرات الاقتصادية المتسارعة والمنتجات الصناعية الجديدة والرغبة العارمة في اقتنائها.
ففي عام 1900 شهدت باريس أكبر معرض للمنتجات الصناعية والاختراعات الحديثة كإنجازات لعصرها، شارك فيه ما يزيد على 75000 عارض، ترددت عليهم أعداد هائلة بلغت 50 مليوناً من الزوار.
ويشير إلى هذا الحدث ذي الدلالة، المؤرخ فيليب بلوم في كتاب عن نشأة نظام عالمي جديد في السنوات السابقة على الحرب العالمية الأولى. ويستعرض ما قدمته السنوات الخمس عشرة السابقة على الحرب العالمية الأولى، والمكاسب والخسائر من الثورة الصناعية والإنتاج الكثيف للسلع والانتقال إلى الحضر، وآثار تغير الأنماط الاجتماعية والثقافية وتبدل توزيع الثروة ومراكز القوى في أوروبا بشكل متسارع مهَّد لأجواء الحرب.
وقد استمرت تداعيات التغيرات الاقتصادية والاجتماعية لما بعد الحرب العالمية الأولى، وترتب على ذلك ظهور التوجهات والممارسات شديدة التطرف سواء المنتمية إلى أقصى اليمين أو إلى أقصى اليسار السياسيَّين. ورغم اختلاف هذه التوجهات فإنها اتفقت على القول بأن العولمة ما هي إلا مؤامرة على الدولة القومية، وفي هذا اختزال كبير لأسباب تقدم الأمم وتراجعها.
إننا بصدد نظام دولي جديد يتشكل مدفوعاً بتغيرات في موازين القوى الاقتصادية العالمية والإقليمية، والتي تسارعت وتيرة تغيرها مع الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في عام 2008 وما سبقها ولحقها من أزمات في أسعار الغذاء والطاقة.
وتعكس النزعات الحمائية والنزاعات التجارية، وتصاعد دور التيارات الشعبوية اليمينية واليسارية في الشارع السياسي جزعاً من تراجع للقوى الاقتصادية الغربية القديمة والجديدة، مفسحةً المجال للبازغين بقوة وثبات من شرق العالم بفضل ارتفاع إنتاجيتهم ونمو اقتصاداتهم وما حققوه من عمل على طريق التنمية الشاملة.
وبين هذا الانحسار النسبي وذلك البزوغ السريع يتشكل نظام دولي جديد تتضح معالمه وطبيعته مع استقبالنا للعقد الثالث من هذا القرن. وبين المنحسرين والبازغين يتلمس العرب مكاناً لهم على أمل أن تكون ترتيبات النظام الدولي الجديد أكثر إنصافاً.
وقد علمنا من قبل أن صاحب الأمل بلا عمل يسانده كالمتعلق بأحبال وهم واهية، وأنه بغير الدأب المتواصل على التطوير والتحديث والارتقاء برأس المال البشري وتطويع تكنولوجيا العصر تخسر الأمم في مضمار التقدم، ولا يبقى لديها من مجد الأقدمين إلا آثار وأطلال تُذكّر بما كانوا عليه.
وفي هذا الإطار من عدم اليقين وحالات الاضطراب والارتباك والحراك السريع الذي يشهده عالم متعدد الأقطاب، وفي إقليم أصابه من الملمات الجيوسياسية ما أصابه، فإن على الاقتصاد العربي بمكوناته وفاعليه التحرك قدماً وبسرعة ليلبي احتياجات عموم الناس وتوقعاتهم.
فالمجتمعات العربية تزداد شبابية في هرمها السكاني مع زيادة توقعات العمر عند الولادة في ذات الوقت، وهي أمور إيجابية إذا أُحسن الاستعداد لها بزيادة الاستثمار، وليس مجرد الإنفاق في التعليم والرعاية الصحية والبنية الأساسية المعينة على الاستفادة من الاقتصاد الرقمي. فضلاً عن الاستثمار في مجالات التوقي من المخاطر البيئية والأوبئة وتغيرات المناخ، والتحسب من احتمالات النزوح البشري، وكثرة اللاجئين والمهاجرين قسراً بسبب الصراعات أو الكوارث الطبيعية سواء في داخل الإقليم العربي أو محيطه.
وإن كانت هذه أولويات المستقبل القريب، فإن التعامل مع التحديات الراهنة يجب ألا يكون بالافتئات على مستلزمات هذا المستقبل. وهذه التحديات الراهنة، وفيها تكمن الفرص أيضاً، يمكن تلخيصها في ثلاث:
أولاً.. أنه رغم الحديث الممتد وبعض الجهود لتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصادات العربية فموازناتها العامة وموازين مدفوعاتها الدولية ما زالت شديدة التأثر بتغيرات وتقلبات أسعار النفط بشكل مباشر وغير مباشر.
وبعدما تجاوز متوسط سعر النفط 100 دولار في الفترة من 2011 إلى 2014 أصبح أقل من 50 دولاراً في الفترة من 2015 إلى 2018، والتوقعات، التي تتم مراجعتها، أن يحوم السعر حول 69 إلى 74 دولاراً في العامين القادمين. وهذا التقلب الشديد في أعوام قليلة لا يعين على ضبط الموازنات ودفع اقتصادات ما زالت شديدة الارتباط بسلعة واحدة ومشتقاتها، في عالم يشهد تغيراً في خريطة تصدير النفط وتخفيض الاعتماد عليه بالتنوع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. وقد وجدنا همة في جهود الإصلاح تشتد مع انخفاض أسعار النفط في الدول المصدرة، ومع ارتفاعه في الدول المستوردة ثم تفتر هذه الهمة مع تغيرات اتجاه الأسعار مما يعسر من شأن الاقتصاد واستقراره ونموه. فالعبرة هنا باستمرار التنويع الكفء والإصلاح الشامل.
ثانياً.. هناك ضرورة للتصدي العاجل لخلل الموازنات العامة وما يترتب عليه من تراكم المديونية المحلية والدولية، وارتفاع معدلات التضخم والغلاء ارتباطاً بالاقتراض من البنوك المركزية وتأثيره على الإصدار النقدي.
فرغم تحسن طفيف طرأ على إجمالي موازنات الاقتصادات العربية بانخفاض العجز فيها من 6% إلى 4.5%، فإن مدى تعرضها لصدمات اقتصادية ما زال كبيراً، مع اتجاهات ارتفاع تكلفة الاقتراض لتمويل العجز وانخفاض الإيرادات السيادية، وبخاصة الضريبية، لسوء منظومة إدارة الإيرادات العامة، وتركُّز النفقات العامة في بنود خدمة الديون والأجور والمرتبات، وعدم تناسب كفاءة النفقات العامة مع أولويات التنمية المستدامة وأهدافها الطموحة إلا قليلاً.
حسناً فعل بعض الدول العربية باتخاذ إصلاحات في المالية العامة وبإنشاء صناديق سيادية تديرها مؤسسات محترفة لزيادة العوائد على الاستثمار وتنويع مصادر الدخل وحماية حقوق الأجيال القادمة، لكن مع ارتفاع الديون في كثير من الدول العربية وانخفاض الادخار في أغلبها أصبح لزاماً عليها أن تحدد إطار تمويل التنمية بشكل متكامل، وكيفية التنسيق بين مصادر التمويل العامة والخاصة والمحلية والأجنبية وتفعيل نظم المشاركة بما يدفع بالنمو قدماً ويقلل أعباء الديون.
ثالثاً.. تشير توقعات النمو الاقتصادي، في ظل الأوضاع العالمية والإقليمية المشهودة، إلى تحسن طفيف في نمو الاقتصادات العربية بمقدار 0.3% مقارنةً بالعام الماضي الذي استقر معدل نمو الاقتصاد فيه عند 2% فقط، وهو رقم شديد الانخفاض لا يلبي احتياجات التنمية وزيادات السكان وتوقعاتهم، ويجعل المديونيات العامة المحلية والخارجية في نطاق حرج، ويقترب من الخطر في بعض البلدان العربية.
وتستوجب التغيرات العالمية والمربكات الكبرى المصاحبة لتغيرات التكنولوجيا أن تشرع الاقتصادات العربية في تبنّي نهج جديد شامل نحو اقتصاد حديث يعتمد على مستحدثات الثورة الصناعية والاستثمار في التعليم والتدريب المتقدم يستفيد من التحول الرقمي في جميع قطاعات الإنتاج.
ويستند هذا النهج إلى تمكين الشباب والمرأة من خلال إتاحة فرص العمل والاستثمار وريادة الأعمال من خلال مؤسسات متخصصة وتمويل داعم. ويعتمد هذا النهج على محلية التنمية في منافسة بين المدن والمحافظات في جذب الاستثمارات، وتوطين الصناعات والخدمات الأساسية والمتطورة، ورفع كفاءة الأصول المنتجة من خلال إجراءات المالية العامة ودفع التنافسية.
ولا يغني ذلك عن منع نزيف خسائر الكيانات الاقتصادية، وضرورة استخدام الأصول المعطَّلة في زيادة الموارد وتحويلها إلى أصول منتجة أو أرصدة تموِّل التنمية لا أن تُترك بلا نفع فيها كأعجاز نخلٍ خاوية.
وإذ نرجو أن يكون العام الجديد عام خير، فمع بدايته وفي شهره الأول ستُعقد في بيروت قمة اقتصادية بحضور قادة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية. لعل هذه الأولويات، وما يحيط بالتعامل معها من مستجدات عالمية وإقليمية، تكون محلاً لتعاون عربي مشترك لما فيه نفع الشعوب العربية وتحقيق طموحات شبابها بخاصة.