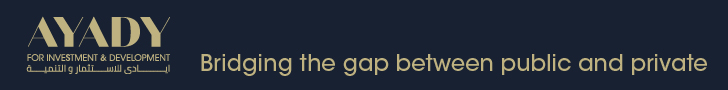د. محمود محيي الدين يكتب: نهج جديد للاستثمار لعلاج معضلة النمو
د. محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي
أجمعت التقارير الصادرة حديثاً عن المؤسسات الدولية، على تخفيض توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي، بعدما تراجعت أرقام النمو الفعلية للعام الماضي، فصلاً بعد فصل، ليصل لنحو 2.7 في المائة في آخر العام، بعدما بلغ 3.3 في المائة في أوله.

وقد دفع هذا مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، إلى أن تصف الاقتصاد العالمي بأنه «يشهد مرحلة دقيقة»، وإلى أن يذكر ديفيد مالباس، الرئيس الجديد لمجموعة البنك الدولي، في أول تصريح له للإعلام، أن النمو الاقتصادي العالمي «فقد قوة دفعه» خلال العام المنصرم.
وقد تزامن هذا التراجع في نمو الاقتصاد العالمي مع انحسار أثر حزم التحفيز التي تبنتها الاقتصادات المتقدمة، بعد الأزمة المالية التي اندلعت في عام 2008، والضغوط المالية التي تعاني منها بعض الاقتصادات ذات الأسواق الناشئة، وزيادة حالة عدم اليقين بسبب ما يكتنف توجهات السياسات النقدية وأسعار الفائدة من غموض، والقيود المتزايدة التي تعترض حركة التجارة الدولية، ومخاطر زيادة الديون الخارجية.
أما معدلات النمو في الاقتصاد العربي فهي ما زالت تحوم حول متوسط 2 في المائة سنوياً، وتشير التوقعات إلى زيادتها بنحو ثلاثة أرباع النقطة المئوية فقط، حتى عام 2021.
هذه الأرقام المتواضعة لا تكفي لتوليد كافة فرص العمل المطلوبة عربياً، والتي قدرت بعشرة ملايين فرصة سنوياً، في بلدان تشهد معدلات بطالة مرتفعة، ولا تلبي متطلبات تحسن متوسطات الدخول، بعدما شهدته من تراجع في عدد من البلدان العربية، وعدم عدالة في توزيعها في أكثرها.
كما أن انخفاض معدلات النمو يعرض الدول عالية المديونية لمخاطر جمة، خصوصاً مع استمرار ارتفاع عجز الموازنات العامة.
لا توجد معضلة اقتصادية دون حل، ولكن لكل حل تكلفة تزداد بالإبطاء في اتخاذ القرار بشأنه. ويتطلب علاج تراجع النمو بداية، إدراك أن النمو الاقتصادي وحده لا يكفي لتحقيق التنمية، ولكن من دونه يتعذر القضاء على تحديات الفقر والبطالة، ومن دونه أيضاً يستحيل التقدم في سباق الأمم أو حتى الصمود فيه.
هكذا أنبأنا التاريخ الاقتصادي لأوروبا الغربية والولايات المتحدة واليابان، منذ الثورة الصناعية الأولى وحتى الحرب العالمية الثانية. وبهذا يخبرنا حاضر نهضة الصين ودول جنوب شرقي آسيا والهند، واقتصادات أخرى انتهجت سبيل النمو لتحقيق أهداف التنمية، ومن أهمها النجاح المطرد في القضاء على الفقر المُدقع.
مَن ينشد حلولاً ناجعة لمعضلات النمو الاقتصادي وتراجعه، لعله يستأنس بخبرات عملية ناجحة لخصها تقرير عن النمو والتنمية، قاد فريق عمله – الذي كنت أحد أعضائه – البروفسور مايك سبنس، الحائز جائزة «نوبل» في الاقتصاد.
وقد اشتركت الدول الأعلى نمواً في سمات خمس تمثلت في: تحقيق استقرار اقتصادي، والانفتاح على العالم تصديراً وجذباً للاستثمارات وجلباً للمعارف؛ والتوجه للمستقبل بمدخرات ومعدلات استثمار مرتفعة، خصوصاً في التعليم والرعاية الصحية، وكفاءة تخصيص الموارد من خلال آليات السوق وحسن الرقابة عليها، والاحتكام لقواعد القانون وأسس الحوكمة والإدارة المتميزة للشأن العام، من خلال سياسات فاعلة ومؤسسات كفؤة.
إذا كانت هذه سمات وخصائص مشتركة جمعت دولاً عالية النمو شاملة التنمية وسريعة التقدم، على النحو الذي شهدته الفترة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى الأزمة المالية الأخيرة، فإن عناصر جديدة لعلاج معضلات النمو في الاقتصادات العربية تستوجب أولوية الإدراج من ذوي الاعتبار مع المستجدات المعاصرة.
تتجلى الأهمية مع تطورات شهدها العقد الحالي، وتحديات النمو الجديدة المشار إليها، ومخاطر وفرص الثورة الصناعية الجديدة، وما أطلق عليه «عصر المربكات الكبرى»، التي ارتبطت بثورة تكنولوجيا المعلومات، وتطور قواعد البيانات الكبرى، التي يطلق عليها «النفط الجديد»، وكذلك الطفرات التطبيقية للذكاء الاصطناعي، فضلاً عما يواجه انسياب حركة التجارة والاستثمار من تحديات ومعوقات تقليدية وأخرى مستجدة.
يمكن حصر هذه العناصر الجديدة في ثلاثة يجمعها نشاط الاستثمار: استثمار في رأس المال البشري، واستثمار في البنية الأساسية المتقدمة اللازمة للثورة الصناعية الجديدة، والاستثمار الثالث في جهود توطين التنمية.
أولاً، الاستثمار في رأس المال البشري، وهو يتطلب مشاركة ضخمة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، في استهداف تحقيق التعلم مدى الحياة، واكتساب المهارات المطلوبة للعمل مرتفع الإنتاجية، وليس مجرد الحصول على شهادات باجتياز مراحل للتعليم، يتواكب معها رقي في نوعية الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل للكافة، ونظم الضمان الاجتماعي.
وبالمراجعة المقارنة لأداء البلدان العربية مع سائر بلدان العالم، وفقاً للأرقام القياسية المعنية برأس المال البشري، تجدها في مراكز متراجعة إلا قليلاً. وفي تقديرات حديثة لاحتياجات الصحة والتعليم من زيادة في الإنفاق يتضح احتياجهما لما يقترب من 7 في المائة من الدخل المحلى سنوياً في الدول النامية. وحتى يتحقق العائد الاقتصادي المطلوب يتطلب الأمر نقلة نوعية في سوق العمل وآليات التعاقد، في عصر جديد لتكنولوجيا الإنتاج.
ثانياً، الاستثمار في متطلبات الثورة الصناعية الجديدة، وتشمل تطوير البنية الأساسية المتقدمة، وسبل التعامل مع قواعد البيانات الكبرى، وحماية البيانات وأسس الرقابة على الخصوصية، ودعم الابتكار المعرفي.
وتشير تقارير متخصصة عن مدى الاستعداد للتحول الرقمي عالمياً، إلى فجوات في البنية الأساسية تتطلب استثمارات ضخمة في شبكات الإنترنت فائق السرعة، وقدرات المنصات المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات، وحفظ واسترجاع وتأمين البيانات والتعامل معها.
كما تحتاج الدول العربية أيضاً إلى إيجاد نسق متكامل للذكاء الاصطناعي، وتطبيقاته في الإنتاج ومجالات الحياة المختلفة.
ثالثاً، الاستثمار في توطين التنمية، بمعنى أن تتوطد علاقة أنشطة الاقتصاد مع المجتمعات وأولوياتها، وأن يتشارك أبناء المجتمع المحلي في صياغة السياسات المؤثرة في حياتهم، بما في ذلك نوعية المجال الاقتصادي ومشروعاته الإنتاجية، وآثارها على البيئة والخدمات والتنمية الاجتماعية، وخضوعها لقواعد الشفافية والحوكمة، سواء استقرت هذه المشروعات في قرى الريف أو أحياء الحضر.
وهذا أمر يتجاوز الحديث المكرر في أدبيات التنمية المحلية العربية بشأن المركزية واللامركزية؛ فريق ينحاز للأولى وفريق يتحيز للثانية.
إن تقدم وسائل تنفيذ ومتابعة سياسات وبرامج ومشروعات التنمية مع تطور التكنولوجيا، بما يمكن من وضع معايير وقواعد للتطبيق، مع الأخذ في عين الاعتبار الموقع الجغرافي للمنافسة والإشراف والرقابة، بما يحقق نفع عموم الناس، لا يفرق بين سُكنى العواصم أو الأقاليم النائية.
فقد يسرت تكنولوجيا المعلومات والتنقل سبل التواصل والمنافسة والنفاذ للأسواق والخدمات لمن أراد. وبدعم التآلف بين الاستثمار ومشروعاته الخاصة والعامة، وأولويات المجتمع المحلي وتطلعاته، يتيسر تحقيق أهداف التنمية، ويزداد الإدراك العام لأهمية الاستثمار في تنويع مصادر النمو وأثره.
نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط