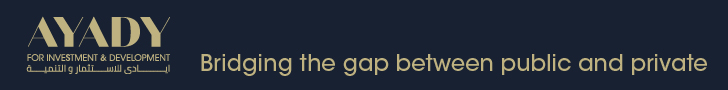بقلم د. محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي نقلا عن الشرق الأوسط
تشترك التقارير الصادرة مؤخراً عن أوضاع الاقتصاد العالمية في أمرين: الأول تخفيض توقعات مؤشرات النمو والتنمية. والثاني غلبة تكرار كلمات «الشك» و«عدم اليقين» في وصف توجهات السياسات الاقتصادية، خصوصاً فيما يتعلق بأسعار الفائدة والتدابير التجارية.

ففي المراجعة نصف السنوية لآفاق الاقتصاد العالمي، خفض البنك الدولي معدل النمو الاقتصادي لعام 2019 بمقدار 0.3 في المائة ليصبح 2.6 في المائة، مرجعاً هذا التخفيض إلى توتر العلاقات التجارية الدولية، والضغوط التي تشهدها الأسواق المالية، وانخفاض النشاط الاقتصادي في الدول المتقدمة عما هو متوقع، والتأثيرات السلبية لتغيرات المناخ، وغموض توجهات السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى… فضلاً عن ازدياد المخاطر الجيوسياسية.
وانعكست هذه العوامل بدرجات متفاوتة على الاقتصادات العربية، فأضافت ضغوطاً إلى ما يعتريها من تحديات داخلية وشدة تأثرها بتقلبات أسعار النفط وما يكتنف كثيراً من دولها من نزاعات وصراعات، بما خفض من معدلات النمو الاقتصادي فيها بمقدار 0.6 في المائة لتصل إلى 1.3 في المائة، وهو أقل معدل نمو لأي إقليم اقتصادي حول العالم لهذا العام.
وكأنما تبارت المنظمات والمؤسسات الدولية في تفسير مسارات النمو المنخفض وما يترتب عليه. فيظهر «تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» أو ما يعرف بالـ«أنكتاد» أن الاستثمار الأجنبي قد واصل انخفاضه للعام الثالث على التوالي وبمقدار 13 في المائة، ليصل إلى 1300 مليار دولار في العام الماضي، وهو أقل مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية، ويظهر مدى انخفاض نمو الاستثمارات المباشرة الدولية على مدار هذا العقد. وإذا لم تتحسن أوضاع التجارة الدولية واستمرت نزاعاتها فلا يُتوقع تعافٍ ملموس في الاستثمارات، بما يؤثر سلباً على توقعات النمو والتشغيل في المستقبل.
ورغم الأجواء الاحتفالية التي صاحبت الذكرى المئوية لتأسيس «منظمة العمل الدولية»، وما نص عليه الإعلان الصادر بمناسبتها من التأكيد على تجديد العقد الاجتماعي بين الحكومات واتحادات العمال والمشغلين، وعلى إرساء ضمانات في ظل بزوغ أنماط جديدة للعمل مع التحول للاقتصاد الرقمي، فإن هذا كله لم يوارِ المخاوف أثناء المناقشات التي شهدتها المنظمة العتيدة منذ أسابيع، من زيادة مؤشرات عدم العدالة في الدخول، والتباين في الأجور، ومدى العدالة في إتاحة الفرص، فضلاً عن شيوع الأنشطة غير الرسمية.
كما تكررت الإشارات إلى ضعف الارتباط المتعارف عليه بين معدلات النمو وتخفيض معدلات البطالة؛ فهناك دول تشهد نمواً بلا تشغيل، وأخرى تشهد تشغيلاً بلا نمو اقتصادي يُذكر لانخفاض الإنتاجية.
وقد أصدرت مؤسسة «كي بي إم جي» رقمها القياسي الجديد لعام 2019 عن الاستعداد للتغيير، الذي يصنف 140 دولة وفقاً لـ150 مؤشراً تقيس قدرات الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في كل دولة على قيادة عملية التغيير المطلوبة، سواء لمواجهة مستجدات في الأجل القصير، أو تحولات في الأجلين المتوسط والطويل، فضلاً عن المربكات التي قد تسببها مستحدثات الثورة الصناعية الجديدة وتغيرات المناخ، أو مدى القدرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وباستثناءات معدودة؛ فإن أغلب الدول العربية لا تحتل مكاناً مطمئناً أو لائقاً في هذا التصنيف. فإذا ما أخذنا في الاعتبار المخاطر الإقليمية المجتمعة، فإن الدولة التي قد تتمتع بتصنيف أفضل من المتوسط ليست بمنأى عن تداعيات تراجع جاراتها في هذا التصنيف من خلال محاور الارتباط المتبادل، بما يؤكد أهمية أن تكتسب التنمية وسياسات التغيير المساندة لها بعداً إقليمياً حتى يتسنى إدراك المصالح الوطنية.
ويوضح «بنك التسويات الدولية»، المعروف بـ«بنك البنوك المركزية»، أهمية تفعيل كل القوى المحركة للاقتصاد للتعامل مع مؤشرات تراجع النمو المتمثلة في انخفاض معدلات الطلب على الاستهلاك والاستثمار، والتوترات التي تسود مضمار التجارة الدولية، متزامناً ذلك كله مع تراكم متسارع في المديونية الدولية؛ سواء الديون السيادية من قبل الحكومات، أو القروض التجارية من قبل الشركات، فضلاً عن تراكم قروض القطاع العائلي محلياً بسبب تيسير الاقتراض الاستهلاكي في اقتصادات مختلفة انتفاعاً بانخفاض شروط ومعايير الاقتراض.
هذه التطورات تملي اعتبارات جديدة لعمل البنوك المركزية وكفاءة إدارتها السياسة النقدية لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي من ناحية؛ وإدراك ما تتطلبه مقتضيات نمو النشاط الاقتصادي من ناحية أخرى. هذه الاعتبارات المستجدة في ظل أجواء عالمية وإقليمية مضطربة ومتقلبة تستدعي حكمة في تحقيق التوازنات المطلوبة وانضباطاً وحرفية وحسن توقيت في اتخاذ إجراءات السياسة النقدية بالتنسيق مع السياسات المالية العامة، والتواصل مع المعنيين بشأن تفاصيلها وتوضيح توجهاتها لعموم الناس.
وقد شبه الاقتصادي المخضرم أجوستين كارستنس، مدير «بنك التسويات الدولية»، اقتصاد الدولة بطائرة ضخمة ذات 4 محركات؛ من دون عملها معاً فلن تحلق الطائرة كما ينبغي لها إذا ما اعتمدت على محرك واحد، خصوصاً مع شدة تلبد السماء بالغيوم. فإذا كان البنك المركزي هو المحرك الأول الذي أُفرط في الاعتماد عليه بكثرة منذ الأزمة المالية العالمية، خصوصاً في الدول المتقدمة.
وقد آن الأوان لمزيد من تفعيل السياسات المالية العامة، خصوصاً إذا ما أتيح لها حيز حركة في زيادة الطلب المحلي من أجل النمو واتباع أولويات منضبطة في الإنفاق العام وتحقق زيادة في الإيرادات السيادية من خلال اتباع نظم الإصلاح الضريبي جنباً إلى جنب حسن إدارة الدين العام. أما المحرك الثالث؛ فهو قواعد الرقابة المالية الحصيفة، وبها يتحقق الاستقرار من خلال إدارة المخاطر النظامية التي قد يتعرض لها القطاع المالي بشكل كليّ، ومنع نمو الفقاعات المالية أو حدوث فجوات تهدد استقرار الأسواق.
أما المحرك الرابع؛ فهو الإصلاح الهيكلي الذي يتطلب إرادة سياسية عالية للتعامل بفاعلية وحكمة مع تراكمات ومصالح متعارضة، خصوصاً إذا ما كانت هناك مظاهر لضحالة في أسواق المال، ولممارسات احتكارية في أسواق التجارة، ولخلل في أسواق العمل، ولرخاوة في قواعد الرقابة الفعالة على هذه الأسواق جميعاً. ولضمان فاعلية واستمرار هذه السياسات في تحقيق أهدافها، يتطلب الأمر أن تُصاغ وتنفذ في إطار رؤية متكاملة لتوطين التنمية لتشمل الكافة؛ فشأن التقدم ليس موضوع سجال محصور بين الحكومات والأسواق فيُهمش فيه دور المجتمع وعموم الناس.