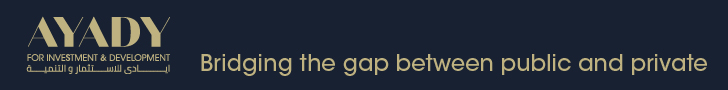بقلم د. محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي نقلا عن الشرق الأوسط
يمر الاقتصاد العالمي بفترة تعج بالتوقعات السلبية عن مسارات نموه وتزايد احتمالات الركود في دول متقدمة، وارتفاع المديونيات، وخلل موازين التجارة، وتراجع الاستثمارات والتشغيل في الدول النامية.

فالعالم منذ الأزمة المالية العالمية، التي وقعت منذ أكثر من عشر سنوات، يعيش بين تبعاتها ومعالجة آثارها ومحاولة الانفلات من أزمات أخرى لن تقل وطأة عنها، إذا حدثت، وبخاصة مع اتساع هوة الثقة بين الدول، وإن انتمت تقليدياً إلى معسكر واحد، فضلاً عن تدني ثقة عموم الناس بمؤسسات الحكم في بلدان متقدمة عدة، على النحو الذي عبّرت عنه نتائج انتخابات عامة مؤخراً.
وكلما لاحت آمال في انفراجة ما مع كل اقتراب من اجتماع لقادة الدول في إطار مجموعة العشرين أو مجموعة السبع أو تجمع دولي لمسؤولي الاقتصاد والبنوك المركزية، تبددت تلك الآمال لعدم خروج هذه الاجتماعات بما يعجّل برأب صدع النظام الاقتصادي الدولي. وتعيش الأسواق المالية والتجارية وكأنها تنسج بنشاط أبعاد نبوءات ذاتية التحقق عن أزمات ركود بما لها من عواقب وتبعات.
مرت عقود لم تمارس فيها الحكومات إجراءات تصنف بأنها من أدوات الحروب التجارية التي تنص عليها مراجع الاقتصاد العتيقة، وهي حالة تحاول فيها الدول تدمير التجارة المتداولة بينها باستخدام التعريفة الجمركية، أو قيود الحصص الكمية، أو منع صريح لواردات معينة من دولة بعينها، أو تستخدم أنواعاً من الدعم أو التمويل الائتماني المدعوم لصادراتها أو التلاعب في قيم عملاتها بقصد إلحاق الضرر بصادرات خصومها التجاريين إليها.
ومع اشتعال حروب التجارة، فإن هذه الأدوات تستخدم بكثافة في سلسلة من الإجراءات الثأرية المتبادلة. وفي عالمنا المعاصر التي تتشابك فيه العلاقات الاقتصادية تمتد هذه الإجراءات وآثارها إلى ما يتجاوز قطاعات التجارة.
فمنذ أربعين سنة مضت كانت التجارة تشكل 90 في المائة من التدفقات العابرة للحدود، أما اليوم فهي تقل عن 10 في المائة فقط، مفسحة المجال للتدفقات المالية والاستثمارية المختلفة على النحو الذي وصفه بإسهاب كتاب «الحرب بوسائل أخرى» الذي ألفه الدبلوماسي الأمريكي روبرت بلاكويل مع جنيفر هاريس الباحثة في السياسة الخارجية.
وفي كتابهما، الذي حظي بإشادة وزير الخارجية الأميركية الأسبق هنري كيسنجر، يستعرضان سبل التعامل مع الجغرافيا – الاقتصادية الجديدة وما تتطلبه إدارة الدولة من إلمام بأدوات لا تقتصر فقط على التجارة، لكنها تشمل سياسات الاستثمار الخارجي، والقيود والعقوبات الاقتصادية، وأمن شبكات المعلومات والمساعدات الاقتصادية، والسياسات المالية والنقدية، وإدارة الاحتياطي، والسياسات الحاكمة للطاقة، والسلع الرئيسية.
وفي هذا العالم المتشابك، الذي تتكون فيه السلع الداخلة في التجارة من مكونات تسهم فيها الدول المستوردة لها إنتاجاً واستثماراً ونقلاً وابتكاراً وتسويقاً، من الصعب الحسم بمن سيتحمل الخسائر النهائية من نزاعات ومعارك حروب التجارة، وبخاصة إذا ما امتدت آجالها. فزيادة التعريفة الجمركية من شأنها زيادة الأسعار على المستهلكين، وبخاصة إذا كانت سلعاً ضرورية، فالمصدّر لهذه السلع لن يخفض بالضرورة من أسعاره لتستوعب ما زاد من تعريفة جمركية.
كما أنه إذا تحولت التجارة إلى مصدر آخر سيبيعها بالسعر الأعلى بعد التعريفة الجمركية الجديدة، وبزيادة أكبر في الربح على حساب المستهلك إلا إذا فُرضت عليه هو الآخر تعريفة جمركية مماثلة.
بطبيعة الحال، مع ما يصاحب الفورات الشعبوية، وما يصيب بعض الناس فيها من اضطراب في الإدراك السوي لحقيقة الهزيمة أو معنى النصر، قد تتشابه عليهم الأمور حتى تذهب السكرة، وقد لا تأتي الفكرة إلا بعد حين.
في هذه الأجواء التي يسودها الشك وعدم اليقين وتبني الإجراءات المتحفزة لإلحاق الضرر بشريك اقتصادي أمسى خصماً، تتزايد احتمالات الوقوع في أزمات كما تصعب إدارتها إذا وقعت وتضعف قدرات التخفيف من آثارها لتدني الثقة بين أطراف العلاقات الاقتصادية.
وقياساً على إدارة الأزمة المالية الأخيرة؛ فإن الرغبة الصادقة في التعاون الدولي للخروج من الأزمة، وتكثيف الجهود المشتركة بين الحكومات والبنوك المركزية وسلطات الرقابة المالية منع من استمرار الأزمة لفترة أطول ومنع تحولها من أزمة مالية لكساد كبير. لكن هذا زمن مختلف.
طوَّر إيان بريمر، الباحث المتخصص في المخاطر السياسية العالمية، مفهوماً أطلق عليه تحدي مجموعة الصفر، وهي حالة تعجز فيها القوى التقليدية والقوى الصاعدة عن إيجاد مساحة مشتركة لإيجاد حل للقضايا المطروحة، فتفشل في التوصل إلى اتفاق توافقي بينها، كما يعجز في الوقت ذاته أي طرف من فرض تصوره على الآخرين؛ لأنه لا يملك الآليات والإمكانات اللازمة لفرضه جبراً. في مثل هذه الحالات لا تسفر اجتماعات المجموعات الدولية التي اتخذت أرقاماً مختلفة مثل 7 و8 و20، وغيرها عن إجراءات حاسمة لحل القضايا العالقة أو توجهات واضحة تهدئ من روع الأسواق وتستعيد الثقة بآليات عمل الاقتصادي الدولي، وتدعم دور المؤسسات الرسمية متعددة الأطراف.
أستدعي في هذا الصدد ما استمعت إليه من كلمات للاقتصادي والمفكر المرموق الدكتور إسماعيل صبري عبد الله، متحدثاً، منذ أكثر من عشرين عاماً مضت، عن العلاقات الثلاث التي ربطت بين الشرق والغرب، وبالأحرى بين الشمال والجنوب وبين الأطراف الأقوى والأضعف خلال القرن الماضي.
بدأت بعلاقة مستعمِر بمستعمَر في فترة من القرن، ثم علاقة متبوع بتابع في فترة لاحقة على ذلك، ثم انتهينا إلى علاقة أخرى جديدة. في العلاقة الأولى كانت هناك حقوق ما لأهل المستعمرات، الذين استذلوا واستضعفوا ببشاعة، على من استعمرهم، كالالتزام بحد أدنى من المسؤولية بتوفير بعض الأمن والاستقرار وحد أدنى للعيش يقترب من الكفاف؛ حتى لا تضطرب الأمور. كما كانت في علاقة التبعية، مع كل ما تضمنته من انتقاص للسيادة والاستقلال.
كانت هناك ثمة التزامات على دول المركز لدول الهامش التي تدور في أفلاكها كتوفير حماية دولية ومساعدات اقتصادية ومعونات غذائية. لكن العلاقة الثالثة الجديدة فتتمثل في التهميش، بمعنى أن تكون الدولة المعنية داخل البرواز أو إطار الصورة إذا توفرت لها الإمكانية، أو خارجه إذا عجزت عن ذلك. وفي ظل هذه الترتيبات فلا حقوق مكتسبة من علاقة، وإن كانت غير متكافئة أصلاً، ولا التزامات هناك إلا في إطار من الصفقات.
إن تحقيق الفاعلية المطلوبة للسياسات العامة في الدول العربية، لتحقيق النمو الشامل للكافة والتنمية المستدامة ودفع التقدم في سباق الأمم، يتطلب إدراكاً شاملاً لمستجدات الواقع الدولي وعدم الخلط بين التمنيات وأحلام اليقظة وما تفرضه التغيرات المتلاحقة من ترتيبات جديدة.
يتطلب الوضع الدولي نهجاً جديداً يستنفر الإمكانات المحلية من خلال سياسات توطين التنمية، ودفع الطلب المحلي والاستثمار في البنية الأساسية بدأ من القرى والمدن الصغيرة، وتفعيل آليات مشاركة المجتمعات المحلية في الإنتاج والتنافسية، وتقديم الخدمات الأساسية بكفاءة خاصة التعليم والرعاية الصحية والنقل.
ويتطلب ذلك تنسيقاً لسياسات اقتصادية واجتماعية متكاملة تنفذها مؤسسات ذات كفاءة للتعامل مع مستجدات الثورة الصناعية الرابعة واغتنام فرص يتيحها التحول الرقمي. وفي هذا لا تجدي أساليب الصوامع المغلقة أو الجزر المنعزلة، أو تبني أشباه الحلول التي لا تؤدي إلا إلى أشباه النتائج في أفضل الأحوال.