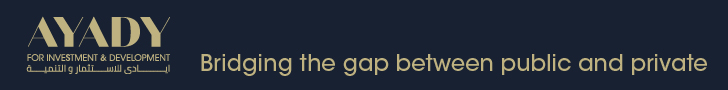بقلم محمود محيي الدين الخبير الاقتصادي المصري نقلا عن الشرق الأوسط _ من أكثر الموضوعات عرضة للجدل الحاد، في خضم تبعات أزمة كورونا الاقتصادية الراهنة ومحاولات احتوائها، هي احتمالات عودة التضخم للارتفاع بعد سنوات من انخفاضه.
فمع انكماش الاقتصاد العالمي وركوده عند معدل سلبي للنمو مقداره 3.5 في المائة وتراجع معدلات التضخم في بلدان العالم أجمع إلا قليلاً وانخفاض أسعار الفائدة بالتبعية، شجع هذا الحكومات خاصةً في الدول المتقدمة على زيادة الإنفاق العام. وكان آخر هذه الزيادات الضخمة ما كان من موافقة الكونجرس الأمريكي على حزمة بمقدار 1.9 تريليون دولار إضافية تضخ في اقتصاده المنكوب بفعل الجائحة.

وقد جاءت هذه الحزمة بعد عام شهدت فيه الموازنة الفيدرالية عجزاً بمقدار 3.1 تريليون دولار تسبب فيه الإنفاق لمواجهة الجائحة.
وقد اتفق اقتصاديون من وزن بول كروجمان الحائز جائزة نوبل و«لاري سمرز» وزير الخزانة الأمريكية الأسبق على ضرورة هذا الإنفاق، وإن وصفه كروجمان بالإنقاذي وصنفه سمرز كتحفيزي.
والفرق بين الأمرين كبير فإذا كان الإنفاق للإنقاذ والإغاثة فلا ينبغي النظر إليه بالاعتبارات الاقتصادية المنصبة على فجوة الناتج والمطلوب تجسيرها، وهذا رأي كروجمان الذي يقلل من احتمالات الآثار التضخمية للإنفاق رغم زيادة حجمه.
أما سمرز فيرى أن الحزمة الضخمة التي قدمتها إدارة الرئيس جو بايدن أكبر من المطلوب لسد فجوة الطلب، وأن من شأنها زيادة ضغوط التضخم ورفع توقعاته بما قد يدفع البنك الفيدرالي الأمريكي إلى زيادة أسعار الفائدة في وقت مبكر بما يدفع الاقتصاد إلى الركود وهو عكس الغرض من السياسة برمتها.
وهناك بنود من الإنفاق لا خلاف عليها بين الفريقين كالعون في إتاحة اللقاح للكافة وتأمين عودة المدارس للعمل، وكذلك مساعدة المتعطلين والإدارات الحكومية على مستوى الولايات والسلطات المحلية. ولكن وجه الخلاف هو تلك الشيكات المدفوعة لملايين بلا مقابل من عمل أو تعويض لضرر.
وفي تقدير سمرز أن هناك ما يقترب من نصف مبلغ الحزمة الأخيرة، حوالي تريليون دولار، من الإنفاق العام غير المبرر الذي سيذهب سدى أو في عمليات للمقامرة على فقاعات الأسهم مثلما حدث في مغامرات أسهم شركة «جيم ستوب» المفلسة.
وفي تقديرات لنماذج اقتصادية، كتلك التي تستند إليها «جيتا جوبيناث» رئيس قسم البحوث بصندوق النقد الدولي، في مقال نشر مؤخراً، بأن الاقتصاد الأميركي شهد تأرجحاً لمعدلات البطالة بين 10 في المائة في عام 2009 بعد الأزمة المالية العالمية و3.5 في المائة في 2019 قبل أزمة كورونا، من دون أن يتأثر التضخم الذي ظل مستقراً عند معدلات منخفضة لم تضطر البنك الفيدرالي لرفع فائدته.
ووفقاً لهذه النماذج فلا خوف من التضخم خاصةً إذا ما ساندتها عوامل هيكلية وسلاسل الإمداد بسلع رخيصة عبر العولمة. فمع استمرار انخفاض متوسطات الدخول في 150 دولة في هذا العام لأقل مما كانت عليه في عام 2019، فإن هذا سيؤكد استمرار انخفاض التضخم مدفوعاً بحركة التجارة الدولية.
يدعم من هذا التوجه المقلل من شأن احتمالات زيادة التضخم، ما هو مشاهد من ارتفاع إسهام المكون التكنولوجي في الإنتاج بما يمنع تحول ارتفاع الأجور لزيادة في أسعار السلع النهائية.
ولكن الأمر في مسألة التضخم لا تحكمه فقط عوامل تكلفة المعروض وطلب المستهلكين، فالتوقعات أيضاً لها أثر حيوي خاصةً في ظروف ارتفاع المخاطر وقلة الثقة وحالات اللايقين في ظل أزمة غير مسبوقة.
فيدفع «أكسل فيبر» الرئيس السابق للبنك الفيدرالي الألماني بأن التوقعات السلبية حيال التضخم وتأثيرها على احتمال رفع أسعار الفوائد لديون الأجل القصير لا تأتي من فراغ. إذ تغذيها زيادة عجز الحكومات المركزية لما يتجاوز 11 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي وهو ما يتجاوز ثلاثة أمثال متوسطات العجز في العشر سنوات الماضية، وقد مول هذا العجز ارتفاع في موازنات البنوك المركزية وقوائمها المالية بمقدار 13 في المائة خلال العام الماضي.
وما حفظ الاستقرار هو قبول جموع المدخرين والمستثمرين في الأوراق المالية الحكومية بعائد سلبي أو يقترب من الصفر، فإذا ما راجع هؤلاء المدخرون والمستثمرون قراراتهم فسيضعف هذا من قيمة العملات بما يرفع معدلات التضخم.
كما أن هناك عاملين آخرين يضيفهما «فيبر»، الأول أنه في حالة تخفيف قيود السفر والانتقال سترتفع أسعار الخدمات بسبب ضعف المعروض من إمكانيات خدمية في المطاعم والخطوط الجوية والفنادق التي قد لا تصل لطاقاتها التشغيلية الملائمة بالسرعة المتوقعة، في أوروبا على سبيل المثال. والعامل الثاني، وهو أكثر انتشاراً في الدول النامية، ينعكس في عدم قياس التضخم بدقة لأن سلة السلع والخدمات المستخدمة في القياس لا تمثل واقع أسعار السلع الأكثر ارتفاعاً وحساسية للتغيرات المتوالية في الطلب وعناصر التكلفة.
ما سقته من آراء متقابلة وحجج متباينة لفرق من الاقتصاديين المختلفين حول احتمالات عودة التضخم عالمياً، تغذيه في النهاية التوقعات التي تحرك التدفقات المالية داخل حدود البلاد وخارجها.
أما عن فخ الوسط فأقصد به الدول متوسطة الدخل التي تشكل ثلث اقتصاد العالم وتضم 75 في المائة من سكانه ويعيش فيها 62 في المائة من فقراء العالم.
وهذه الدول لا تتمتع بمزايا الدول المتقدمة في الاقتراض الرخيص بالعملات المحلية بلا مخاطر في سعر صرف العملات الدولية المقترض بها. كما أن دول فخ الوسط لا تستفيد من مزايا الاقتراض الرخيص الميسر من المؤسسات التنموية الدولية، كذلك الذي تستفيد منه الدول الأفقر والأقل دخلاً، بافتراض فضفاض بأن لديها قدرات لتدبير احتياجاتها التمويلية من خلال استثمارات القطاع الخاص المحلي والأسواق المالية الدولية.
فعلى الدول الواقعة في فخ الوسط التحوط المبكر من أثر تغيرات مباغتة في أسعار الفائدة العالمية تستهدف الأوراق المالية قصيرة الأجل لاحتواء توقعات التضخم وما قد يصحب ذلك من تغيرات في أسعار الصرف وارتفاعات في التكلفة الفعلية للقروض الدولية، خاصةً إذا ما تغيرت تصنيفاتها الائتمانية.
ومن الملاحظ أن هناك توجهاً في مجموعة الدول السبع وكذلك مجموعة العشرين بأن أوجه التيسير والعون الدولي في مواجهة جائحة كورونا لا تلتفت إلى الدول متوسطة الدخل بحال. فمبادرة مجموعة العشرين لتجميد مدفوعات خدمة الديون في إطار العون المؤقت لمواجهة كورونا، والتي ستنتهي في شهر يونيو القادم، وكذلك مبادرة النهج المشترك للتعامل مع مشكلات الديون كلها مبادرات موجهة للدول الفقيرة لا تستفيد منها الدول متوسطة الدخل على الإطلاق.
وهذا وإن زادت أعداد البشر الذين يعانون من الفقر في هذه البلدان الواقعة في فخ الوسط عن كل فقراء الدول الأقل دخلاً. فسبل التيسير لحياة الفقراء مطلوبة بما يتجاوز اعتبارات التصنيف العقيمة للدول وفقاً لشرائح دخول تختزل واقع التنمية ومدى استقرار المجتمعات واقتصاداتها في متوسطات مضللة.