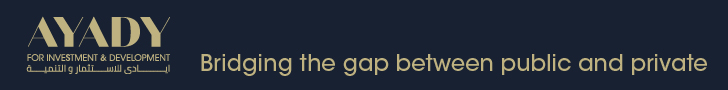د. محمود محيي الدين يكتب.. عن صراعات المناخ وحروب التجارة ومستقبل لم يعد كما كان
بقلم محمود محيي الدين الخبير الاقتصادي المصري نقلا عن الشرق الأوسط – في أثناء مشاركتي بإحدى حفلات الخريجين في الجامعات البريطانية لهذا العام، استمعت لمتحدثة باسم الخريجين وهي تكرر في كلمتها مقولة «إن المستقبل لم يعد كما كان»، مشيرة إلى أنه رغم سعادتها وأقرانها بإنجازهم الدراسي وحصولهم على مؤهلات أكاديمية من جامعة مرموقة، فإنهم يستشعرون قلقاً أكبر لما ينتظرهم في اقتصادات عانت من تقلبات حادة بسبب الجائحة وما سبقها من سنوات شهدت أزمات مالية وحروباً تجارية تراها تعود بقوة، ويتزامن مع ذلك كله إجراءات للتصدي لتغير المناخ لن تكون كلها بالضرورة حانية على سوق العمل.
وكلمات الخريجة النابهة ذات الأصول الأفريقية محقة في تخوفاتها، ويشاركها فيها أقران لها في بلداننا، ولن يهدئ من هذه التخوفات تعاطف مستحق أو إبداء تفهم لأسبابها. فالمطلوب حقاً هو نهج جديد للاستثمار والنمو المقترن بتوليد فرص للعمل اللائق.

ويردد مسؤولو الدول المتقدمة مقولة «إعادة البناء بشكل أفضل»، قاصدين بها السعي لنمو ذكي أخضر يعتمد على التحول الرقمي ومراعاة الاشتراطات البيئية. وقد رصدوا لذلك موازنات ضخمة ممولة بتكاليف منخفضة بسبب تدني أسعار الفائدة المصاحبة بإجراءات غير مسبوقة من البنوك المركزية، حتى تجاوز الإنفاق العام للتصدي للجائحة والتعافي الاقتصادي 10 في المائة في كثير من البلدان الغنية، وما زالت مستمرة في إنفاقها حتى الاطمئنان على التعافي.
أما في بلداننا النامية فلا يهدد فرص التعافي الاقتصادي فيها تحورات في فيروس كورونا ونقص اللقاحات وقلة الموارد المتاحة للإنفاق العام فحسب، بل ما يتجدد من صراع دولي حول أولويات التصدي لتغيرات المناخ، وشحذ استعدادات ترسانة الحمائية في سبيل حركة التجارة الدولية.
ومع قدوم أجيال جديدة بأعداد غفيرة إلى سوق العمل في بلداننا يثور تساؤل مشروع، مماثل لما طرحته الخريجة البريطانية ذات الأصول الأفريقية، حول فرص التحاقهم بعمل لائق، وإن كانت التحديات أمامهم أكبر. وهذا يؤكد مرة أخرى ضرورة تبني سياسات دافعة للاستثمار والتشغيل والنمو مع التصدي لعقبات التمويل، ولكن كيف سيكون ذلك في ظل صراعات المناخ وحروب التجارة؟
– خطورة تبني سياسات للتصدي لتغيرات المناخ بمعزل عن إطار التنمية المستدامة: يجد المتابع للجدل الدائر حول تغير المناخ تسييساً مفرطاً في أولوياته، واستقطاباً حاداً حول برامجه، وتغلبت فيه الآيديولوجيا فأزاحت أهل العلم عن الصدارة، وصار إطار الحديث عن تغيرات المناخ والمشاعر المشحونة يذكرك بالصراعات الدينية في القرون الوسطى. فكأنك بين أشياع مبشرين وجموع من المشككين وآخرين متهمين بالهرطقة. وفي عصر يتباهى بتطورات العلم كان من المفترض أن تكون الأدلة المثبتة هي السند الأساسي للحوار حول تغيرات المناخ.
وقد أكد أهل الاختصاص ما يحيق بعالمنا من مخاطر وجودية بسبب الانبعاثات الضارة بالمناخ وبما يهدد الحياة. ثم تأتي بعد هذا منطقياً الإجراءات التي ينبغي اتخاذها للتعامل مع هذه المخاطر، وقد استقر الأمر باتفاق دولي ملزم تم إبرامه في باريس في عام 2015.
ثم يأتي بعد ذلك التنفيذ المحكم لما تم الاتفاق عليه، بما في ذلك وفاء الدول الغنية بتعهداتها السابقة بتوفير 100 مليار دولار سنوياً للدول النامية لتعينها في تمويل استثمارات التوافق مع متطلبات حماية المناخ. وهو رقم زهيد لم يتم الوفاء به، رغم الاحتياجات المكلفة، خاصة أن الدول النامية مطالبة للإسهام في إصلاح ما أفسدته الانبعاثات الضارة المتولدة من الدول المتقدمة.
فوفقاً لمعهد الموارد العالمية هناك مصادر كبرى أكثر ضرراً بالمناخ والبيئة ومنها المصادر التسع التالية: 1) إنتاج الكهرباء والتدفئة بنسبة إسهام تقدر بنحو 33 في المائة. 2) النقل والمواصلات بنسبة 15 في المائة. 3) التصنيع والتشييد بنسبة 13 في المائة. 4) الزراعة والإنتاج الحيواني بنسبة 11 في المائة. 5) حرق أنواع مختلفة من الوقود بما في ذلك الأخشاب بنسبة 8 في المائة. 6) منتجات صناعية كثيفة الاستخدام للطاقة مثل الألمونيوم والإسمنت وغيرها بنسبة 6 في المائة. 7) إزالة الغابات الشجرية الاستوائية بنسبة 6 في المائة. 8) انبعاثات مرتبطة بإنتاج الطاقة بنسبة 5 في المائة. 9) دفن النفايات والمخلفات الصلبة 3 في المائة.
هذه المصادر ترتبط بها حياة البشر والإنتاج، ولكنها تتركز في دول بعينها أكثر استهلاكاً ودخلاً، وعليها أن تتحمل أعباءها ولا تحيلها إلى غيرها. كما أن القطاعات الحيوية المذكورة يمكن تسييرها وإدارتها بطرق أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وأفضل فاعلية في توافقها مع الاعتبارات البيئية.
وهنا تأتي الحلول الاقتصادية بما ينفع الناس؛ وأولها الاستثمار في التكنولوجيا والبحوث والتطوير، فبفضلها أصبحت الطاقة البديلة أكثر كفاءة وأقل تكلفة. فقد أوضح تقرير أخير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أن تكلفة الطاقة الشمسية قد انخفضت بمقدار 16 في المائة في العام الماضي وحده، بينما انخفضت تكلفة الطاقة المولدة من الرياح بنسب تتراوح بين 9 في المائة و13 في المائة، بما جعل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أقل مما كانتا عليه سعراً منذ عشر أعوام بنحو 85 في المائة و52 في المائة على الترتيب.
الأمر إذن يتعلق بإدارة التحول بعناية حتى لا تأتي الهرولة والتعجل غير المنضبط بدعوى حماية المناخ بنتائج عكسية تضر بالنمو وفرص العمل بما يعوق في نهاية الأمر سياسات حماية المناخ نفسها. وعلينا أن نتذكر أن هدف حماية المناخ هو الهدف رقم 13 من 17 هدفاً عاماً من أهداف التنمية المستدامة لا يقل أي منها عنه أهمية بحال؛ فمنها القضاء على الفقر المدقع والجوع، والارتقاء بالتعليم والصحة، وزيادة النمو والتشغيل، وتوفير الطاقة والمياه، وغيرها من أولويات لا تستقر حياة المجتمعات ولا تطور الاقتصادات من دونها.
– أضرار العودة للسياسات الحمائية: يبدو أن دولاً متقدمة قد استمرأت التبني لإجراءات تدعو لها مبشرة طالما استفادت منها، ثم تحيد عنها بعدما تصل بها إلى مبتغاها. وقد كان هذا الشأن مع تحرير التجارة وإزالة معوقاتها كالتعريفة الجمركية والحصص.
وقد لامت دول متقدمة التجارة الدولية على تعثر مشروعات وخسارتها على أرضها، في حين أن الأوْلى باللوم هو تراجع الإنتاجية والكفاءة وانخفاض مهارة العمل وارتفاع تكلفته.
وقد لجأت أحزاب وحركات شعبوية لتأجيج مشاعر الغضب وتوجيه الاتهام لوارداتها من دول أكثر كفاءة وأفضل نوعية وأقل تكلفة. وحركت بعض الدول الغنية الحنين إلى ماضيها الصناعي برفع التعريفة الجمركية وزيادة قيود التجارة وتحجيم المنافسة وزيادة الدعم الموجه لصناعات فقدت مزاياها النسبية.
ولم تحقق أكثر هذه الإجراءات إلا زيادة في أعباء الإنفاق العام والدعم. وفي مقال للاقتصادي الأميركي أدم بوزن في مجلة «الشؤون الدولية» عن ثمن الحنين إلى الماضي، ومقال آخر للاقتصادية الأمريكية آن كروجر عن السياسة الصناعية الأميركية المضطربة، تحذير واضح عن التوغل المكلف في سياسات مدفوعة بمقاصد جيدة للتشغيل وحماية الصناعات وزيادة الإنفاق العام المرتبطة بها، ولكنها ستنتهي إلى ما انتهت إليه إجراءات سابقة عجزت عن انتقاء مشروعات مرشحة للنجاح، فقد كانت فعلياً أقرب للفشل والخسارة، وهو ما كان.
لا مراء أن للدولة واستثماراتها دوراً في علاج قصور السوق وعجز إمكانات المشروعات الخاصة المحلية والأجنبية وحدها عن الوفاء بمتطلبات التنمية. وهذه الاستثمارات العامة أولى بها أن توجه إلى البنية الأساسية والتكنولوجية ومساندة البحث والتطوير وتجويد التعليم والرعاية الصحية والإسهام في زيادة مهارات وقدرات رأس المال البشري وتأهيله للمنافسة الدولية في عالم سريع التغير.
وإذا كان على الدولة أن تقدم دعماً، كما هو متوقع منها وفقاً لوظائفها، فيجب أن يكون موجهاً لمستحق من خلال نظم الضمان الاجتماعي الشامل. أما تبني الإجراءات الشعبوية كتقييد حركة التجارة والمنافسة فهي قصيرة الأمد عالية التكلفة، وإنْ صاحبها تشجيع المتهافتين في بدايتها فسيتبرأون منها بعدما تلحقه من دمار وإضاعة لفرص عمل حقيقية كتلك التي يمكن أن تلتحق بها هذه الخريجة الجامعية وأقرانها، إذا وفقت السياسات في تحديد أولوياتها صياغة وتنفيذاً.