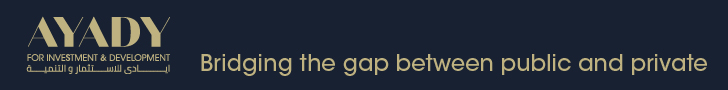د. محمود محيي الدين يكتب.. من الدراما الآسيوية إلى الدراما العالمية
بقلم د. محمود محيي الدين الخبير الاقتصادي المصري نقلا عن الشرق الأوسط – منذ أكثر من نصف قرن نشر الاقتصادي السويدي، الحائز جائزة نوبل جونار ميردال كتابه الشهير، الدراما الآسيوية واصفاً فيه أحوال فقر الدول النامية في جنوب آسيا. فبعد رصده لأحوال النمو والتنمية لعشرة أعوام قبل صدور كتابه في عام 1968 مقارناً الدول المتقدمة صناعياً بالدول النامية الآسيوية، انتهى إلى أن التفاوت الشاسع بين الدخول وزيادة الهوة اتساعاً سيمنع الدول الأسيوية من التخلص من آفات الكساد والفقر.
لم يسنح الزمن لميردال أن يشهد البزوغ الآسيوي الكبير في الربع الأخير من القرن العشرين، وما كان من تقارب مضطرد بين الشرق والغرب بوثبات في النمو والتنمية فيما أُطلق عليه بعد ذلك المعجزة الآسيوية.

هذا التحول من حالة الدراما التعيسة في التنمية إلى ما وصف بالمعجزة لم يأت صدفة أو بهبات ومنح تتدفق من الغرب إلى الشرق، ولكنه نتاج استثمارات ضخمة في رأس المال البشري وفي البنية الأساسية وتراكم ومنجزات لم تهدرها تغيرات في الحكم بين نظم بائدة وأخرى مبيدة.
وقد أعلى ميردال من أهمية القيم وتحيزاتها في صياغة السياسات العامة بما في ذلك السياسات الاقتصادية، وهو ما لم تتجاهله القيادات الآسيوية التي انتشلت بلدانها من براثن ثالوث الفقر والجهل والمرض وما يصاحبه حتماً من اضطراب وفوضى وهشاشة في المجتمع وتدهور مستمر في الأداء الاقتصادي.
كما يتضح في التجربة الآسيوية قوة الدولة ومرونة سياساتها وبرغماتيتها، وهي أيضاً من علامات القوة في عالم سريع التغير لا يلتفت إلى الحائرين في متاهات الجمود، والتشبث بآيدلوجيات نافقة.
ويكفي الاطلاع على كتاب د. سويي كنغ جوه، وهو أحد الآباء المؤسسين لسنغافورة مع زعيمها التاريخي لي كوان يو، عن ممارسة النمو الاقتصادي للتعرف على جهود التمرد على آفات الدولة الرخوة التي حذر منها ميردال بإدراك متميز لاعتبارات الاقتصاد السياسي وثقافة المجتمع وقيمه عند صياغة السياسات العامة وبناء مؤسسات تتوافق مع طبيعة البلاد وأولوياتها مع الإلمام الكامل لمستجدات العصر ونظمه المتطورة.
وهذه الاعتبارات تحديداً هي التي تميز التفوق الآسيوي المعاصر، بعد عهود من المعاناة، عن هذه الإخفاقات الكبرى التي شهدت تجارب متهافتة فيما سمي «بناء الدولة». فكان الفشل كما رأينا مؤخراً في أفغانستان، ومغامرات مدمرة لمشاريع فاشلة مثل الشرق الأوسط الكبير، حاولت فرض نموذج بعينه لإدارة المجتمع والاقتصاد بنظام سياسي منقول من بيئة شديدة الاختلاف في قيمها وتطورها باعتباره النظام الأمثل واجب الاتباع، فكان ما كان من فوضى لم تخلق إلا دماراً.
أسوق ما تقدم استرشاداً لأسس مواجهة ما يمكن تسميته الدراما العالمية. فبعد عقود من التقارب بين الدول النامية والمتقدمة، بفضل زيادة معدلات النمو المطرد، يهددنا عالم ما بعد الجائحة بتباعد كبير بتداعيات جيوسياسية وتوتر وصراعات ينبغي التعامل معها مبكراً والتوقي منها.
حقاً خرجت كثير من الدول النامية من أسر التخلف بفضل سياسات وطنية متكاملة ومؤسسات فعالة تقوم على تنفيذها، ولكن ما حقق تقاربها مع الدول المتقدمة هي قنوات منفتحة أمام تدفق حركة التجارة الدولية والاستثمارات الخارجية واكتساب المعارف من خلال بعثات تعليمية وانتقال العمالة ومشروعات مشتركة. ولكننا نرى اليوم مؤشرات في غاية الخطورة عن تفاوت معدلات النمو والتباين في الدخول.
ففي حين يبلغ متوسط النمو الاقتصادي العالمي المتوقع حوالي 6% يقل هذا المؤشر إلى النصف في العديد من البلدان النامية بما لا يتجاوز 3% هذه السنة بما لا يعوض ركود العام الماضي. وفي الوقت الذي تستحوذ فيه الدول المتقدمة وعالية الدخل على أكثر من 80% من عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا، لا تتجاوز النسبة 2% في إفريقيا.
وتمتعت الدول المتقدمة بسخاء مالي ونقدي في مواجهة تداعيات الجائحة تجاوز 27% من ناتجها المحلي الإجمالي، نجد أن هذه النسبة تقل عن 7% في الدول متوسطة الدخل وتصل إلى 1.8% في الدول الأقل دخلاً. وفي هذه الأثناء تتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول النامية، كما أن نسبة التجارة إلى نواتجها المحلية لم تتغير بالكاد منذ الأزمة المالية العالمية.
كما يهدد كثير منها شبح أزمات متفرقة للمديونية الدولية للعجز عن الوفاء بخدمة الديون، خاصة إذا ما ارتفعت أسعار الفائدة العالمية مع بدايات لتخارج البنوك المركزية في الدول المتقدمة من إجراءات التيسير النقدي ولمواجهة احتمالات زيادة معدلات التضخم بسبب عدم توافق نمو العرض بسبب عراقيل سلاسل الإمداد وعدم وفرة مدخلات الإنتاج مع زيادة في الطلب في الدول المتقدمة.
هذه ملامح دراما عالمية تتجاوز الدراما الآسيوية انتشاراً في ربوع الأرض تعكس تفاوتا بين الدول وداخلها، عكستها مؤشرات حديثة استعرضتها تقارير دولية عن التنمية المستدامة تزامن صدورها مع انعقاد الدورة السادسة والسبعين للجمعية الأمم المتحدة هذا الشهر.
هذه المؤشرات تُجمع بجلاء مزعج أن العالم ليس على طريق تحقيق أهداف الاستدامة، ولا يمكن لوم الجائحة وحدها على هذا التقاعس، فالمشكلة سابقة على انتشارها وإن توحشت بعدها.
لقد حذر أنتونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من أن أرقام متابعة اتفاقية باريس لتغيرات المناخ تشير إلى أن المسار الحالي سيؤدي إلى زيادة الانبعاثات الضارة بالمناخ بحوالي 16% بحلول عام 2030 بدلاً من تخفيضها بمقدار 45%. كما أوضح أن عدم الوفاء بالتعهدات المالية لمساندة جهود الدول النامية يهدد اجتماع جلاسجو القادم بالفشل.
لعل المجتمعين في إطار الجمعية العامة بين مشارك بالحضور الشخصي أو عن بعد عبر الشاشات أن اجتماعهم على هذا النحو في حد ذاته يؤكد أن العالم ما زال في معترك التعامل مع الجائحة؛ وأن من يتجاهلها لا تعامله بالمثل، فتداعياتها الصحية والاقتصادية له بالمرصاد.
وهناك أولويات سبع للتصدي لأوجاع الدراما العالمية المصاحبة للتفاوت الدولي وهذا التباعد غير المسبوق بعد عقود من التقارب. هذه الأولويات تتوفر لها الحلول العملية لكنها تفتقد العزم على تنفيذ إجراءات تحقيقها:
أولاً: توفير اللقاح للدول النامية لتصل لنسبة 40% من المطعمين قبل نهاية هذا العام، من خلال زيادة الإنتاج والتصدير والسماح بالتصنيع بالدول النامية التي تتوفر لها القدرة من خلال الإعفاء المؤقت من قيود حماية الملكية الفكرية في إطار منظمة التجارة العالمية.
ثانياً: وضع نهج متكامل للاستدامة يشمل برامج تحقيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة التي تم إقرارها بالأمم المتحدة في عام 2015، بما في ذلك ما تتضمنه اتفاقية باريس باعتبارها الهدف الثالث عشر من هذه الأهداف. فتبني مسار منفصل لتغيرات المناخ يهدد بتكريس حالة الجزر المنعزلة ويشتت جهود التنمية وإهدار الموارد.
ثالثاً: الوفاء بالتعهدات الدولية بشأن تمويل الاستدامة، ويكفي ما أشار إليه تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن فجوة بما لا يقل عن 20% من التعهدات السنوية المحددة بمقدار من 100 مليار دولار منذ مؤتمر كوبنهاغن في عام 2009. ورغم تواضع هذا الرقم مقارنة بالاحتياجات الفعلية وغموض طرق حسابه منذ إقراره إلا أنه لا يتم الوفاء ولا تتوازن أوجه إنفاقه في مجالات مواجهة تغيرات المناخ. هذا فضلاً عما تواجهه المساعدات الإنمائية الدولية من ثبات عند أرقام لم تراوحها تقل عن نصف الالتزامات المعلنة.
رابعاً: ضرورة قيام الدول على المستوى الوطني بإعداد موازناتها العامة وتطوير قواعد الرقابة المصرفية والمالية والسياسات النقدية لتتوافق مع أولويات الاستدامة وتحقيق الأهداف المعلنة للتنمية بحلول عام 2030. فلا مجال لتشجيع منضبط للقطاع الخاص أو تلق تمويل ناجع للتنمية بقروض ميسرة، أو بالاستثمار من باب أولى، دون أن ترسم الموازنة العامة والسياسات المالية والنقدية والرقابية معالم الطريق وأسس المشاركة.
خامساً: لقد أضير سوق العمل ونظم الضمان الاجتماعي أيما ضرر من جراء الجائحة وتراجع النمو وتفاوت الدخول قبلها وأثناءها وبعدها، بما يحتم مراجعة نماذج النمو لتكون أكثر شمولاً بتوليدها لفرص العمل اللائق مع مساندة نظم الضمان الاجتماعي للتوقي ضد المخاطر المتزايدة.
سادساً: توطين التنمية المستدامة من خلال الدفع باستثمار ضخمة للارتقاء برأس المالي البشري تعليمياً وصحياً، وتطوير البنية الأساسية بما في ذلك المكون التكنولوجي ومتطلبات التحول الرقمي. مع التوسع الزراعي وزيادة فرص تكوين قيمة مضافة من خلال التصنيع والابتكار، بدلاً من تصدير السلع الأولية لمن يزيدها قيمة ثم يتم استيرادها منه. فكثير من ممارسات التجارة الدولية يذكرك بالبيت الشعري القديم«كالعير في البيداء يقتلها الظمأ،والماء فوق ظهورها محمول».
سابعاً: سيتعذر تحقيق أي مما سبق إذا ما لم تتخذ الإجراءات المانعة من تحول الضغوط المالية المصاحبة للزيادة الراهنة في المديونية العالمية، فيما يعرف بالموجة الرابعة للديون. ونتذكر أن الموجات الثلاث السابقة التي حدثت خلال الأربعين سنة الماضية قد انتهت كل واحدة منها بأزمة عاتية تحمل بتبعاتها البريء قبل المذنب. فالأزمات المالية عندما تشتعل تربك الأولويات وتستأثر بالموارد الحيوية للتعامل معها، وهو ما يجب التعامل معه بحسن إدارة الدين العام محلياً وتفعيل كافة أطر التعاون الدولي، التي يعاني بعضها من قصور باكتفائها بتقديم الحد الأدنى لما هو ضروري وإن كان ليس كافياً بحال.