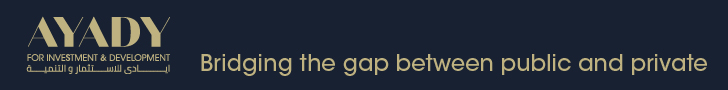بقلم د. محمود محيي الدين الخبير الاقتصادي المصري نقلا عن الشرق الأوسط – عاد التضخم ليصبح ظاهرة عالمية بعد فترة غياب لم يفتقده فيها أحد. فبعد جدل على مدار العام الماضي حول ما إذا كانت ارتفاعات الأسعار الحادة خلال العام الماضي مؤقتة أم مستمرة، عارضة أم متواصلة، عادت آليات مكافحة التضخم إلى قمة أولويات السياسات الاقتصادية مع اختلاف في كيفية التعامل معه.
فمعدلات التضخم الراهنة لم تشهدها الاقتصادات الكبرى منذ سنوات بعيدة، فهي الأعلى في الولايات المتحدة منذ أربعين عاماً؛ إذ بلغت 7 في المائة في شهر ديسمبر الماضي، كما لم يشهدها الاتحاد الأوروبي منذ إصدار العملة الموحدة – اليورو – منذ عشرين عاماً.

وقد ظلت إجراءات مكافحة التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار وحماية الفقراء ومنخفضي الدخل من آثاره من أولويات سياسات الدول النامية،
ولكنها تواجه اليوم تأثيرات أكثر حدة من المعتاد تأثراً بالتضخم العالمي من طريقين: أولهما التضخم المستورد الذي تحمله إليها وارداتها من السلع القادمة من أسواق اشتعلت أسعارها، والأخرى، وهي الأكبر خطراً في تقديري ما تسببه إجراءات التعامل مع التضخم في الدول المتقدمة من تأثيرات سلبية على التدفقات المالية الموجهة للدول النامية،
وتكلفة التمويل بزيادة أسعار الفائدة على القروض، والضغوط على أسعار الصرف، وزيادة مخاطر التعثر في سداد الديون التي تراكمت بشدة قبل وبعد جائحة فيما يعرف بالموجة الرابعة للديون الخارجية.
سؤال الملكة يتكرر مرة أخرى: تستعيد مشكلة التأخر في التنبؤ بالتضخم إلى الذاكرة ذاك السؤال الشهير للملكة إليزابيث الثانية عندما زارت مدرسة لندن للاقتصاد العريقة في شهر نوفمبر من عام 2008 بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية، حيث سألت مدير البحوث الاقتصادي لويس جاريكانو إذا كانت المشكلات بهذا الحجم كيف لم يرها أحد؟ ثم علقت قائلة، إنه أمر فظيع! وتوالت الإجابات قصيرة ومطولة على سؤال الملكة، مفسرة التقصير في إجراءات السياسات الاقتصادية، ومبررة القصور في القدرة على التنبؤ الاقتصادي بظروف ارتفاع حالة اللايقين وعدم التنسيق الكافي بين دوائر اتخاذ القرار الاقتصادي.
وها نحن في حالة مماثلة بعد سنوات من سؤال الملكة في مجال آخر ستكون له تداعياته السلبية على المجتمعات والاقتصادات والأسواق فيما يتعلق بالتضخم.
ورغم أن التنبؤ بمسارات التضخم أكثر يسراً من توقع الأزمات المالية، فإن الإخفاق تكرر مرة أخرى. فبسؤال 36 خبيراً من المتخصصين في التنبؤ الاقتصادي عن توقعهم لمعدلات التضخم في الولايات المتحدة في شهر مايو الماضي، ذكروا أن احتمالات تجاوز التضخم معدل 4 في المائة لا تزيد على 0.5 في المائة.
كما يذكر الاقتصادي جاسون فورمان، الأستاذ بجامعة هارفارد، أن أعضاء اللجنة الفيدرالية لعمليات السوق المفتوحة، وهي المعنية بتحديد أسعار البنك الفيدرالي الأمريكي، لم يتوقع أي منهم أن يزيد معدل التضخم على 2.5 في المائة في عام 2021، وهو ما ثبت خطأه ببون شاسع. كما أن المتعاملين في أسواق السندات لم يكونوا أفضل من الجهات الرسمية في التوقع؛ فأسعار سندات الخزانة الأميركية المتداولة لم تعكس أيضاً توقعات استثنائية لتضخم أكثر ارتفاعاً.
وكالعادة عند وقوع خطأ يكثر اللوم وتشيع الاتهامات. فهذا ينتقد نماذج التنبؤ وعدم قدرتها على استيعاب التغيرات الحادة في الاقتصاد أو اختلاف سلوك المستثمرين والمنتجين والمستهلكين وردود أفعالهم. وذاك يلوم الإدارة الاقتصادية في تباطؤها في اتخاذ القرار حيال التضخم.
وفي رأيي، أن خطأ البنوك المركزية الكبرى يرجع إلى مزيج من العوامل: منها ما يتعلق بعجز نماذج التنبؤ القياسية عن استيعاب المستجدات المتوقعة كافة وغير المتوقعة، خاصة في ظل ظروف اللايقين.
ويبدو أن اضطراب سلاسل الإمداد وتأثير تحورات الفيروس على أسواق السلع والخدمات والعمل لم يتم إدراك أثرها بالكامل في جانب العرض، مع اشتعال جانب الطلب بعودة أسرع من المتوقع محمّلة بقوة شرائية مؤجلة منذ بدايات الجائحة، ومشبعة بتمويل سخي من حزم التيسير النقدي.
كما أن هناك صعوبة في اتخاذ إجراءات حادة تضر بالنمو وتزيد من البطالة وتعطل جهود التعافي من آثار الجائحة أثناء محاولة مكافحة التضخم، في ظل ضغوط سياسية تقيد حركة اتخاذ القرار. ولا يبدو أن متخذ القرار كان يملك وجود أدلة قوية تبرر إجراءات استباقية، فضلاً عن ذلك فكثير من الإدارات الاقتصادية في مجموعة الدول السبع الكبرى لا تملك قدرة عالية على الإقناع كما تفتقد ملكات استثنائية لازمة للقيادة في أجواء أزمة مركبة. في ظل هذه الأجواء… ما العمل إذن حيال التضخم؟
للانتفاع بما حدث؛ ترشدنا أصول البراغماتية المبدئية أن نجعل أهداف تحقيق التقدم والتنمية دائماً نصب الأعين، ولن تتحقق هذه الأهداف أبداً دون معدلات عالية للنمو الاقتصادي الشامل للكافة مع الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.
ولا يجب أن تحيد الإدارة الاقتصادية عن هذه الأهداف مهما كانت المعوقات والمربكات، وإذا حدث خطأ فعليها أن تعترف به دون مكابرة أو تضليل وتسعى لتصحيحه دون إبطاء.
وبناءً عليه، هناك إجراءات عاجلة لا تحتمل ممارسات «فن عمل لا شيء» التي استهلكتها إدارات اقتصادية بتكاليف باهظة يتحملها عموم الناس.
أولاً، اتباع نهج عملي في تطوير نماذج التنبؤ الاقتصادية يستوعب المتغيرات المستجدة غير المسبوقة والتمرد في الظروف الاستثنائية على النماذج النمطية ذات الافتراضات الساذجة عن المستقبل باعتباره مجرد امتداد خطي للماضي.
ثانياً، الإفصاح عن نتائج هذه النماذج من قبل البنوك المركزية والإدارات الاقتصادية، مع أهمية تحديد ضوابط الاسترشاد بها في اتخاذ القرار.
ثالثاً، التحلي بالتواضع وتشجيع مشاركة المتخصصين ببدائل عملية للسياسات المقترحة، بدلاً من هذه الثقة المتغطرسة التي دأب مسؤولون على استخدامها، خاصة عندما يتحدثون عن المستقبل كأنما كُشف لهم عن الغيب ورفعت عنهم الحجب.
رابعاً، إذا كان الجانب الأكبر من العبء في التصدي للتضخم يقع على عاتق البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة التي تتوفر فيها كفاءة أعلى لآليات تأثير السياسة النقدية؛ فكل المجتمع لديه حسابات مصرفية ومندمج في الاقتصاد الرسمي، وله ارتباطات في شكل أصول والتزامات مستمرة مع القطاع المالي، مثل امتلاك أسهم وسندات وقروض مرهونة بعقارات وقروض شخصية وبطاقات ائتمان إلى غير ذلك، فإن وسائل التأثير المماثلة أقل في البلدان النامية.
كما أن التضخم في هذه البلدان لا يمكن اعتباره ظاهرة نقدية فحسب، فهناك اعتبارات هيكلية وتشوه في الأسواق وقواعد عملها.
كل ذلك يستوجب تنسيقاً أعلى بين السياسات النقدية والسياسات المالية العامة بشقيها المتعلقين بالضرائب والإنفاق العام، جنباً إلى جنب مع الإجراءات الاقتصادية الأخرى لحماية الأسواق والمستهلكين من غلواء التضخم.
خامساً، هناك ضرورة عاجلة لتدعيم نظم الضمان الاجتماعي وشبكات المساندة للأفقر والأقل دخلاً في المجتمع توقياً من تداعيات التضخم.
سادساً، الاستمرار في تخفيض وإعادة هيكلة الدين العام بالاعتماد على مصادر محلية ومد آجال الاستحقاق.
سابعاً، الاعتماد بشكل رئيسي على الاستثمار بديلاً عن الاقتراض كنهج لتمويل التنمية المستدامة ومشروعاتها ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والمستحقة للأولوية.
ثامناً، مراجعة كفاءة الإنفاق العام خاصة في مشروعات البنية؛ فقد أوضحت دراسات عن حوكمة وكفاءة الإنفاق للاستثمارات في هذه المشروعات لوصول الفاقد فيها لنحو 20 في المائة من التكلفة الكلية في الدول المتقدمة وما يتجاوز 50 في المائة في الدول النامية.
تاسعاً، حسن إدارة سياسات التعامل مع تغيرات المناخ حتى لا تتسبب، كما حدث خلال الأشهر الماضية، في ارتفاعات حادة غير مسبوقة في أسعار الطاقة التقليدية للتعجل من الانسحاب من الاستثمارات الحرجة في مصادرها، والهرولة في المضاربة على أسعار مكونات وخامات الطاقة المتجددة فأضرت هذه السياسات المرتجلة التي اتبعتها دول متقدمة خاصة في أوروبا بكافة أسعار مصادر الطاقة، سواء تقليدية أو جديدة، ورفعت معدلات التضخم دون أن تحقق هدفاً كبيراً يذكر في مضمار تغيرات المناخ، بل أضافت لظاهرة غلاء الأسعار سبباً جديداً هو «التضخم الأخضر»!
عاشراً، تكثيف التوعية بمستجدات الأسواق المالية وما تشهده من تغيرات، وأثرها على استثمارات ومدخرات عموم الناس. فمع التضخم تنفجر فقاعات مالية كثيرة، كما تكثر التلاعبات والترويج لخرافات الربح السريع والنصب باسم توظيف الأموال المعروفة في الأسواق المالية بأساليب بونزي للتغرير براغبي الربح السريع.
وقد شهدنا على مدار الأيام الماضية تقلباً وانخفاضات حادة في أسواق الأسهم والسندات، وكان الأكثر خسارة المشفرات كالبيتكوين وغيرها.
وأشير في هذا الصدد للقواعد الرقابية الجيدة التي أصدرتها السلطة النقدية لسنغافورة المعروفة باتباعها معايير حصيفة للإشراف المالي، حيث منعت الدعاية ونشر الإعلانات العامة لهذه الأصول عالية المخاطرة حماية لغير المتخصصين.
فهناك حملة دعائية جارية تزداد سخونة مع التخوف من تراجع أسعار الأصول المالية المشفرة لجذب مزيد من المضاربين، أو الضحايا؛ لدفع زيادة الطلب عليها. وقد استوجب هذا تدابير رقابية جديدة كتلك التي اتخذتها سنغافورة وإجراءات بالحظر على بعض الشركات، كما حدث في لندن، لانتهاك قواعد الإعلان الآمن للمشفرات عالية المخاطرة.