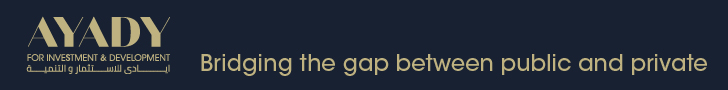د. محمود محيي الدين يكتب.. عن المناخ وثالوث أزمات الركود والغلاء والديون
بقلم د. محمود محيي الدين الخبير الاقتصادي المصري نقلا عن الشرق الأوسط.. يشهد العالم منذ أكثر من سنتين أحداثاً لم يشهدها مجتمعة منذ وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها. فقد سببت أزمة «كورونا» أكبر حالة لركود اقتصادي منذ عام 1945، وتبعتها موجة تضخم حادة لا يوجد ما يضاهيها ارتفاعاً إلا ما شهدته الاقتصادات الأمريكية والأوروبية في سبعينات القرن الماضي.
وقبل نشوب أزمتي الركود والتضخم تواترت تحذيرات للدول النامية من أنها تواجه ارتفاعاً في المديونية الخارجية لمستويات حرجة تجعلها أكثر عرضة لتقلبات أسعار الفائدة والصرف الأجنبي وصدمات الارتفاع المفاجئ في تكاليف الاقتراض، وزيادة احتمالات التعثر في السداد.

ويشكل تراجع تقديرات النمو الاقتصادي العالمي في هذا العام والعام المقبل أيضاً إلى حدود تتراوح بين 2.5 في المائة و3 في المائة انخفاضاً حاداً عما كان عليه معدل النمو في عام 2021، ويتزامن ذلك مع ارتفاع في معدلات التضخم عن متوسطاتها العالمية لتبلغ 7.8 في المائة في أبريل الماضي، وفقاً لتقرير البنك الدولي عن آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في الشهر الماضي، الذي يرصد أيضاً ارتفاع معدلات التضخم في الدول النامية والأسواق الناشئة لتتجاوز 9.4 في المائة لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
وهذا التزامن بين انخفاض متوالٍ في معدلات النمو وزيادات في معدلات التضخم أعلى من متوسطاتها المستهدفة بما سبب حالة من الركود التضخمي، وأدى إلى انخفاض في متوسطات الدخول الحقيقية عن مستوياتها قبل أزمة «كورونا» في حوالي نصف عدد البلدان النامية؛ فاقتصاداتها مضارة مرتين؛ مرة بانحسار فرص النمو وزيادة البطالة التي تقلل من فرص التفاوض على أجر أعلى، كما أنها تتضرر من عدم زيادة أجور العاملين بمعدلات تفوق زيادة التضخم.
وقد بات لزاماً على صانعي السياسة الاقتصادية في الدول المتقدمة العودة إلى سجلات عقود مضت للتعرف على ما كان من أوجه التعامل مع ارتفاعات التضخم المتتالية في السبعينات، وما كان مجدياً منها وغير مجدٍ. وفي أحاديث مع مشاركين في مؤتمر دافوس الذي عُقد في شهر مايو الماضي تبين أن التضخم الحاد يمثل تحدياً عمرياً للمديرين التنفيذيين للشركات ومؤسسات الإنتاج في البلدان المتقدمة، فمن يشغلون هذه المناصب تتراوح أعمارهم بين العقدين الرابع أو الخامس من العمر، أي أنهم كانوا في مراحل التعليم قبل الجامعي عندما كان التضخم ظاهرة تشغل بال الأسواق، وعليهم أن يتمرسوا التعامل مع هذه المتغيرات وثقافتها.
هذا طبعاً على عكس الحال في الدول النامية التي لم تنقطع عن أكثرها تحديات ارتفاع الأسعار تزيد بها معدلات التضخم السنوية أو تحلق ارتفاعاً مسببة لموجات غلاء شديدة لا تطيقها دخول عموم الناس. ولكن مما لا شك فيه أن مجرد اجترار الذكريات عن التضخم وكيفية التعامل معه لن يجدي شيئاً مع تعقد الأزمات الاقتصادية وتشابكها.
مع شدة الأزمات المحتدمة تشابكاً من غلاء وركود وديون، تلوح فرص ترتبط بالعمل المناخي في التصدي الناجع لهذا الثالوث، إذا ما أحسن إدراج جهود التصدي لأزمات المناخ في السياسات العامة. ويأتي هذا باتباع نهج شامل للتصدي لتغيرات أولى من الاختزال المخل الذي جعل العمل المناخي يجتزئ إجراءات بعينها انحرافاً عن حسن إدارة العملية الانتقالية نحو الحياد الكربوني وفق اتفاق باريس وتعهداته الملزمة.
أولاً، أن سياسات إدارة الطلب بزيادة أسعار الفائدة لن تخفض التضخم بمفردها في البلدان المتقدمة اقتصادياً، وضررها بالغ على البلدان النامية، كما أوضح جوزيف ستيجليتز الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد، في مقال مشترك مع الاقتصادي دين بيكر، أن مصدر ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة يرجع إلى صدمات في جانب العرض مثل الارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة والغذاء والخامات التي انخفض عرضها بفعل «كورونا» وارتباك سلاسل الإمداد وتداعيات حرب أوكرانيا، فزيادات أسعار الفائدة لن تزيد المعروض من المنتجات، بل على العكس ستجعل تكلفة الاستثمار أكثر ارتفاعاً وتعوق جهود تنشيط جانب العرض.
وفي مقال لاقتصادي مرموق حائز أيضاً جائزة نوبل في الاقتصاد، وهو مايكل سبنس، يحذر من مغبة الرفع المتزايد لأسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الرئيسية بدفعها للاقتصاد العالمي تجاه ركود أعمق. وفيما يتجاوز الأثر السلبي للأزمة الأوكرانية، يوضح سبنس أن هناك معوقات في جانب العرض وإنتاجية العمل والأجور النسبية تحتاج لعلاجات لن يجدي رفع أسعار الفائدة معها نفعاً.
كما أن هناك تحديات جيوسياسية ورغبات في إعادة تشكيل سلاسل الإمداد بدوافع تحقيق أمن الحصول على منتجات أساسية بتوطين عمليات الإنتاج أو من خلال التعاقدات مع مصادر أكثر تنوعاً للطاقة وأقل تركزاً من حيث المخاطر، ومرة أخرى لن تحقق ارتفاعات أسعار الفائدة أي تحسن في وفرة المعروض من المنتجات التي ارتفعت أسعارها، بل ستعيد تسعير الأصول المالية والعقارية والعملات. أما عن آثارها على البلدان النامية فستزيد من اضطرابات أسواق النقد الأجنبي والتدفقات المالية مع مزيد من التعثر في سداد الديون الخارجية.
ثانياً، دفع جانب العرض بزيادة الإنتاج والإنتاجية في قطاعات الطاقة والغذاء وإدارة المياه من خلال الاستثمار. جانب كبير من التضخم يرجع لزيادة أسعار الطاقة والمواد الغذائية التي زادتها سوءاً الحرب الأوكرانية.
في الأجل القصير تأتي إجراءات انفعالية كرد فعل كاستخدام مولدات الكهرباء المستخدمة للفحم في أوروبا، ولجوء أكثر من 30 دولة لإجراءات حمائية ومانعة لتصدير منتجاتها الزراعية. ولكن في الوقت ذاته تتولد دوافع للاستثمار في الطاقة المتجددة وتطوير القطاع الزراعي ومنظومة الإنتاج الغذائي وكفاءة استخدام المياه بالتوافق مع إجراءات التخفيف والتكيف المناخي مع التوسع في استخدام مستحدثات التحول الرقمي والذكاء الصناعي، وما يتطلبه ذلك كله من استثمارات جديدة.
ولعل أهم ما أسفرت عنه اجتماعات مجموعة السبع هو تعهدها في البيان الصادر عنها الشهر الماضي باستثمار 600 مليار دولار في مشروعات في البلدان النامية خلال السنوات الخمس المقبلة في مجالات العمل المناخي والصحة العامة والبنية الرقمية والمعلوماتية والعدالة بين الجنسين.
وهذه المجالات تأتي في إطار اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر؛ وهي تتطلب تعاوناً فنياً وتكنولوجياً مع الدول النامية لا يقل أهمية عن التمويلات الموعودة، الذي أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها ليست منحاً أو معونات، لكنها استثمارات. بافتراض تدفق هذا التمويل فإن الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ستظل في حاجة إلى المزيد لتجسيرها، إذ تصل تقديراتها إلى 4.2 تريليون دولار سنوياً، وفقاً لتقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ومن خلال الاستثمارات الموجهة للدول النامية ذات النفع المتبادل، يمكن التعامل مع تحديات الركود بدفع نمو قطاعات الإنتاج وتيسير الحصول على طاقة نظيفة والتعامل مع أزمة الغذاء وأسعاره التي استعرت، خصوصاً بعد الأزمة الأوكرانية.
ثالثاً، تخفيض الديون من خلال مبادلتها بالاستثمار في العمل المناخي، باعتبار أن درء مفسدة الديون المتفاقمة يقدم على جلب المنح والهبات، فهناك ضرورة تحتم إعادة النظر في المديونية الدولية، وأوجه الخلل فيها، ومنع انتشار أزمات التعثر في السداد والإعسار، وما يرتبط بها من مشكلات ويترتب عليها من تداعيات واختلالات اقتصادية في البلدان النامية، ولنا في الموجات الثلاث للديون، التي انتهت كل واحدة منها بأزمة كبرى، عظات.
وباعتبار أننا لا نشهد تدفقاً مالياً يذكر للعمل المناخي رغم التعهدات، فمن مجالات العمل الممكن للتعاون الدولي تطوير وسائل جديدة من مبادلة الديون ويكون بمقتضاها استفادة الدولة المدينة بتخفيض ديونها الخارجية المستحقة، سواء كانت لمدينين رسميين أو تجاريين، من خلال تنفيذ مشروعات، كما فعلت دولتا بليز وسيشيلز، وإن كان من الأفضل أن يكون ذلك مقابل إجراءات تنفذها الدولة المعنية بالتوافق مع تعهداتها وفق اتفاق باريس، سواء في مجالات التخفيف أو التكيف بمنظومة محددة فنياً وزمنياً؛ وهو ما سأقوم بتوضيحه بتفصيل وأمثلة في مقال مقبل.
ولحسن التعامل مع الأزمات الراهنة يظهر بجلاء أن الاكتفاء بافتراضات سخية عن تماثل الأزمات الراهنة، أو تشابهها، مع أزمات سابقة لن يضعها على مسار حل سحري.
كما أن لوم مصدر الأزمة بكونه من مسببات خارجية أو من مخلفات عهود بائدة، لن يفيد إلا لوقت وجيز يتلقى خلاله مدير الأزمة كلمات للتضامن أو التشجيع لا ينبغي أن تشغله عن مهمته الأساسية في التصدي للأزمة، فشأنه بعدها لن يكون مثلما كان قبلها بحال.
وأفضل ما ينفع مما سبق من دروس الأزمات الفائتة أنها جميعاً إلى انقضاء، وهو ما قد يطمئن، ولكنها لا تنتهي تلقائياً ولكن بما يبذل في مواجهتها من جهد منظم بفريق محترف يقود مؤسسات ذات كفاءة بسياسات واضحة الرؤية.
ومن دروس التعامل مع الأزمات أن لها تكلفة تزيد بإهمال التصدي الفوري لها، وأنها ليست عادلة في توزيع أعبائها، وهو ما ينبغي إدراجه في تصميم برامج التصدي لها، فكثير من أنواع الدواء الموصوف قد يكون أشد من الأزمة شراً. وسيتبين بعد نهاية الأزمة أنها، ككثير من سابقاتها، كان من الممكن التوقي من شرورها أو على الأقل من أغلبها. وهذا هو الدرس الأكبر من دروس تاريخ الأزمات بلا منازع، إذ أننا لا نتعلم منه شيئاً، بما يجعل الأزمات تتكرر بملل مزعج في كثير من مسبباتها.