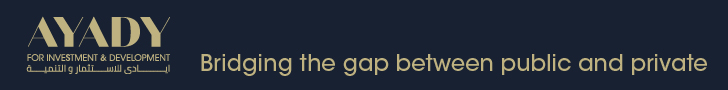د. محمود محيي الدين يكتب.. لن ينصلح شأن المناخ إلا بالقضاء على الفقر
بقلم د. محمود محيي الدين الخبير الاقتصادي المصري نقلا عن الشرق الأوسط.. منذ عام 2015 وتزامناً مع إعلان الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة، وأولها وأهمها القضاء على الفقر المدقع، استخدم البنك الدولي رقماً يعادل 1.90 دولار لليوم الواحد للفرد لتحديد خط الفقر المدقع عالمياً.
ومع تغيرات الأسعار العالمية تم تعديل هذا الرقم هذا العام ليصبح 2.15 دولار، بمعنى أن أي إنسان يعيش بأقل من هذا القدر سيُعدّ ممن يعانون رسمياً من الفقر المدقع بالمعيار العالمي.

وبالإضافة إلى خط الفقر المدقع، يستخدم البنك الدولي كمؤسسة دولية معتمدة في تحديد منهجية قياس الفقر مؤشرين آخرين للعون في تحديد مستوى الفقر عامة في البلدان النامية، وقد تم تعديل المؤشرين أيضاً ليعكسا تغيرات الأسعار فارتفع رقم خط الفقر للدول متوسطة الدخل بشريحتيها الدنيا والعليا من 3.20 دولار و5.50 دولار إلى 3.65 و6.85 دولار على الترتيب.
ومن الضروري التأكيد أن هذه التغيرات تعكس فقط تغيرات الأسعار للحصول على ذات المكون الحقيقي الذي يستخدمه الفرد من السلع والخدمات، وأن لكل دولة خطاً للفقر العام وخطاً للفقر المدقع ينبغي تحديثه ليعكس تغيرات الأسعار للتعرف على الأولى في المجتمع بالرعاية من خلال السياسات العامة.
وأنه بالإضافة إلى أرقام خطوط الفقر على أساس الدخل والاستهلاك، فهناك أهمية لاستكمالها بمؤشر لقياس الفقر المجتمعي الذي يدرج تطور تعريف الفقر ومحدداته مع تطور دخل الدولة وزيادة ثرائها، فضلاً عن مؤشر الفقر متعدد الأبعاد الذي يقيس أوجه الفقر والحرمان فيما يتجاوز العناصر النقدية للفقر.
ووفقاً لمؤشر الفقر المدقع المعدل، فإن عدد من يقع تحت هذا الخط قد بلغ 700 مليون إنسان في عام 2017، وفي دراسة لمؤسسة «أوكسفام» المعنية بشؤون الفقر، فقد ارتفع هذا الرقم في الربع الأول من هذا العام إلى 860 مليوناً، ويعكس هذا الرقم ارتفاع أعداد البشر الذين يعانون من الجوع إلى 827 مليوناً في هذا العام، وهذه الأرقام لا تعكس أثر ارتفاعات أسعار الغذاء والطاقة بعد اندلاع الحرب الأوكرانية التي يرجح أن تضيف 65 مليون إنسان إلى أعداد من يعانون الفقر المدقع.
هذا هو الوضع الحالي للهدف الأول لأهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر المدقع الذي كان يرجى في عام 2015 عند الإعلان عنه في قمة خاصة في الأمم المتحدة الوصول إليه مع حلول عام 2030، والعالم اليوم في وضع أسوأ عليه مما كان عليه الحال منذ 7 سنوات.
ومرة أخرى لن يكفي لوم مشاجب الأزمات والصدمات الخارجية لتعلق عليها خيبة السياسات العامة وضعف مؤسسات العمل التنموي وإهدار الموارد مع تشتتها.
فالعالم لم يكن على مسار تحقيق أهداف التنمية وفقاً لتقارير التنمية المستدامة عن عام 2019، قبل تفشي جائحة كورونا في عام 2020. ولم يحسن العمل الدولي في التصدي للجائحة بشكل متوازن سواء بمعيار توفير اللقاحات أو إتاحة المساندة المالية للبلدان النامية التي ستدفع غالياً ثمن السخاء في ضخ السيولة في البلدان المتقدمة ثم تكاليف سحبها بإلغاء برامج التيسير النقدي ورفع أسعار الفائدة ومن ثم تكاليف الاقتراض.
ثم أتت الحرب الأوكرانية بتداعياتها فزادت حدة أزمات قائمة وكشفت عن عورات في الأداء الاقتصادي لم يعد من الممكن سترها بأوراق البنكنوت من الإصدار النقدي، أو بخصف الأموال المقترضة قصيرة الأجل على أجساد اقتصادات منهكة.
إن الوضع الاقتصادي العالمي الراهن الذي يعاني من تراجع معدلات النمو وتهديدات الركود التضخمي وأزمات في قطاعات حيوية مثل الغذاء والطاقة وارتفاع مخاطر وتكاليف الديون الدولية لا يستقيم معه الاستمراء في اتباع نهج مختزل في سياسات الاستدامة لتعني فقط بجانب من جوانب من جوانب العمل المناخي، وهو تخفيض الكربون رغم أهميته الكبيرة.
فبقيادة العمل المناخي من مجموعة دول بعينها قطعت أشواطاً في التقدم والنمو ورفع مستويات معيشة أبنائها تعليماً ورعاية صحية ومساندة بخدمات عامة وانخفضت فيها معدلات الفقر واختفت فيها حالات الفقر المدقع أو كادت، تفرغت للنصح وإملاء الشروط نحو الاستدامة بما يوافق أوضاعها ويتعارض في الوقت ذاته مع تحديات وأولويات البلدان النامية.
فنحّت أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر جانباً باستثناء الهدف الثالث عشر المعني بالعمل المناخي. وليتها تناولت هذا الهدف على استقامته وشموله فركزت فقط علة تخفيض الانبعاثات الضارة بالمناخ – التي لا خلاف علمياً وبديهياً على أهميتها – ولكنها أهملت عمداً أو سهواً ضرورة توفير البديل للبلدان النامية الأقل إسهاماً في الانبعاثات الضارة بالمناخ من مصادر الطاقة المتجددة والجديدة من الشمس والرياح والهيدروجين الأخضر وما يحتاج إليه ذلك من استثمارات وتقنية متقدمة.
كما أن هذه البلدان التي كادت أن تنفرد بصياغة أولويات العمل المناخي غضت الطرف عما سببته من أذى متراكم باستخدامها لتكنولوجيا ملوثة للبيئة ومهددة للمناخ وسلامة الأرض منذ الثورة الصناعية الأولى، فتجدها لا تعر الاهتمام المستحق في مساندة ملف التكيف مع آثار ارتفاع سخونة درجة حرارة الأرض وما سببته الانبعاثات الضارة بالمناطق الساحلية وطبيعتها وبنيتها الأساسية وتكبدته قطاعات الزراعة والغذاء والمياه من تكاليف لحمايتها.
ولا تلتفت كثيراً اللهم إلا بوعود وتعهدات لا تنجز للجزر الصغيرة المهددة وجودياً وما تتطلبه من موارد لحماية مقوماتها تنوء بها موازناتها العامة المتواضعة التي لو أنفقت مواردها بالكامل لما أوفت ببعض المطلوب من نفقات للعمل المناخي. وإذا استجابت البلدان النامية للنصح بمزيد من الاستدانة المكلفة من الأسواق الدولية للإنفاق على العمل المناخي فهي بذلك تستجيب لما يقوض قواعدها المالية ويحملها وأجيالها القادمة بما لا تحتمل وبما لا ينبغي إثقال كواهلها بها أصلاً.
ثم أن البلدان المتقدمة إذا ذكرت بتعهداتها التي ألزمت بها نفسها ومنها المائة مليار دولار الشهيرة التي أعلن عنها في قمة كوبنهاجن في عام 2009 كحد أدنى سنوي تمنحه للبلدان النامية تجد الرد متهافتاً عن أسباب عدم الوفاء بها.
ففي أفضل التقديرات هو ما أعلن عنه قبل قمة جلاسجو من أن الرقم قد اقترب من 79 في المائة من المبالغ المطلوبة في العام الماضي وهو ما تختلف مع طرق تقديره مؤسسة «أوكسفام» التي ترى أن ما تم الوفاء به لا يتجاوز 20 في المائة وأنه أكثر انحيازاً للإنفاق على مجالات تخفيف الانبعاثات الضارة وأن جهود التكيف لا تحظى بالاهتمام المطلوب.
كما تشير التقارير منها الصادر عن مؤسسة «أو دي أي» إلى أن 7 دول متقدمة فقط من إجمالي 23 هي التي أوفت بتعهداتها وهي السويد، وفرنسا، والنرويج، واليابان، وهولندا، والدنمارك وألمانيا، وأن الأربع الأولى منها فقط قد أعلنت التزاماتها حتى عام 2025.
هذا علماً بأن رقم المائة مليار دولار لا يمثل أكثر من 5 في المائة من إجمالي الإنفاق المطلوب للعمل المناخي في البلدان النامية.
هناك ضرورة لإعادة إدراج العمل المناخي في إطار أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها عالمياً. ويحتاج العالم إلى إنهاء نهج الجزر المنعزلة في التعاون الدولي الذي أضر بالتنمية المستدامة وأوضاع الفقر ولم يصلح من شأن العمل المناخي.
واتباع نهج متكامل للتمويل بكل مصادره سيذكرنا بأن كل دولار ينفق على التكيف مع آثار تغير المناخ يولد ما بين دولارين إلى عشر دولارات من المنافع الاقتصادية على النحو الذي يشير إليه تقرير حديث مشترك لمعهد «جرانثام» للبحوث. فللمناخ تأثيرات شديدة الإضرار بمستويات الفقر بتداعيات تدهوره على قطاعات الزراعة وأعمال الفلاحة والغذاء وقلة المياه والصحة ونزوح البشر اضطرارياً.
وفي المقابل، فالاستثمار في التنمية في مجالات تطوير رأس المال البشري تعليماً ورعاية صحية وفي البنية الأساسية والتكنولوجيا والتحول الرقمي وفي مجالات الاستدامة بتمتين المجتمع والاقتصاد والبيئة لها آثار متبادلة إيجابية تعضد بعضها.
ويعزز هذا التوجه التوطين العملي للتنمية المستدامة لتشمل عموم الناس أينما كان سكناهم ومجالات تدبير معايشهم بداية، وليس انتهاء بالاستثمار في تنمية القرى والمناطق الأكثر فقراً.
فكما أن السماء لا تسقط ذهباً ولا فضة فإن النمو ليس له ثمار تتساقط عفواً على الأكثر فقراً. فليس هناك بديل للنمو الشامل للكافة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما فيها هدفا القضاء على الفقر المدقع وحماية المناخ معاً.