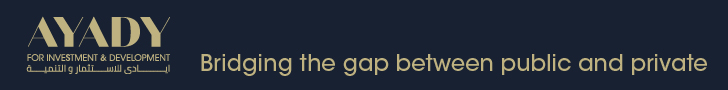د. محمود محيي الدين يكتب.. عن ملف «الخسائر والأضرار» وما لحق بباكستان
بقلم د. محمود محيي الدين الخبير الاقتصادي المصري نقلا عن الشرق الأوسط.. في عام شهد صنوفاً من المعاناة بين جفاف وفيضانات وحرائق سببها تدهور المناخ، كانت باكستان من أكثر الدول التي تعرضت لمحن كبرى، بفيضانات تسببت في فقدان أرواح ما يزيد على 1480 إنساناً منذ شهر يونيو حتى الآن، وتدمير 1.7 مليون مسكن، وشردت وهجرت 33 مليون إنسان، وألحقت أضراراً بالغة بالبنية الأساسية والإنتاجية للبلاد، وعرَّضتها لأزمات غذائية وصحية غير مسبوقة.
لا يمكن لوم الطبيعة وحدها بأن ما حدث من نوازلها، فلا يمكن تبرئة البشر من إحداث هذه الكارثة بالإضرار للمناخ بمختلف الانبعاثات المؤذية له، وزيادة سخونة الأرض، وعدم الالتزام بتعهدات التخفيف من الضرر، وكأن ما حدث من تراكمات منذ الثورة الصناعية الأولى لا يكفي.

ثم إذا دُعيت الدول المتقدمة لتقديم العون تعهدت ثم نكص أكثرها عن العهد، واكتفوا بإلقاء محاضرات ومواعظ بكلمات رنانة، عن أهمية الحفاظ على الأرض التي باتت تئن من ويلات ما فعلوا من ضرر، وتنذر بمزيد من الأزمات، كرد فعل على الاستمرار في الإساءة للمناخ والطبيعة والبيئة معاً.
ويعد موضوع الخسائر والأضرار الذي تعانيه باكستان، ومعها عديد من البلدان النامية، من أكثر الأمور الخلافية في العمل المناخي، ويقصد به الآثار المدمرة التي لحقت بالبيئة والطبيعة والعمران وحياة عموم الناس، جراء التدهور في المناخ. وهو يختلف جذرياً عن ملف التكيف مع آثار المناخ، في كونه يتجاوز قدرات المجتمعات المضارة على التعامل معها، إما لعدم توفر القدرة المالية والمادية، وإما لاستحالة تعايش البشر معها.
ولما كانت الخسائر والأضرار تصيب المجتمعات الأفقر والأضعف أكثر من غيرها، فالتعامل معها يعتبر من أهم موضوعات العدالة المناخية. وعلى الرغم من أن هذا الملف مطروح منذ بدء مسارات التفاوض في العمل المناخي منذ بداية التسعينات من القرن الماضي، بمطالبات موجهة إلى الدول المتقدمة لتقديم الدعم المالي والعون الفني في إطار تعويضات مستحقة للضرر الواقع بالبلدان النامية، جراء ممارسات ارتكبتها الدول الصناعية بأساليب إنتاج واستهلاك أنهكت البيئة وانتهكت قواعد سلامة المناخ، فإن هذه المطالب قوبلت إما بالرفض وإما بالتجاهل.
ومن أمثلة الخسائر والأضرار المقصودة في العمل المناخي: ما تسببه حوادث الطقس شديدة التغير عن مؤشراتها المعتادة، وكثرة تواتر التعرض للأعاصير والزوابع وحالات الجفاف وموجات الحر القائظ، وارتفاع مستوى البحر مهدداً اليابسة، والتصحر وتدهور خصوبة الأرض، وزيادة ملوحة البحار والمحيطات.
وفي كثير من الحالات تتعرض الموارد الطبيعية لتدمير مستمر يحيل الأراضي المأهولة والقابلة للزراعة، إلى مناطق خربة يستحيل العيش فيها. ويترتب على هذا كله خسائر في الأرواح وأسباب المعيشة تدفع إلى موجات من نزوح البشر والهجرة الاضطرارية الجماعية.
وفي حين تقل احتمالات التعرض للخسائر والأضرار الناجمة من المناخ مع التوسع في إجراءات التخفيف من الانبعاثات الضارة بالمناخ، وكذلك من الآثار الإيجابية للتكيف مع الآثار الضارة لتدهور المناخ، فإن موضوع الخسائر والأضرار كما تسفر عنه نوازله يتجاوز في طبيعته واحتياجاته ما قد تسفر عنه جهود التخفيف والتكيف التي تعاني ذاتها تراجعاً حيناً وتباطؤاً أحياناً، على الرغم من كثرة التعهدات.
كما توضح الدراسات العلمية أنه حتى بافتراض تحسن في العمل المناخي، بما يمنع زيادة درجة حرارة الأرض عن 1.5 درجة عن متوسطاتها إبان الثورة الصناعية الأولى، فإن الدمار الذي لحق ببعض الموارد الطبيعية لن تعالجه جهود التخفيف أو التكيف، ومثال لذلك: الشعب المرجانية التي سيختفي أكثر من 70 في المائة منها في المناطق الاستوائية، بما يلحق الأذى بالتنوع الطبيعي ومصادر الغذاء السمكي التي تتعايش في هذه الشعب، ومن ثم الإضرار بمصادر معيشة سكان المناطق الساحلية.
وقد قدم تحالف الجزر الصغيرة مقترحاً في عام 1991، لتكوين تدابير تأمينية للتعامل مع تهديدات ارتفاع مستوى البحر، وقوبل المقترح بالرفض. ثم ظهر ملف الخسائر والأضرار لأول مرة كمقترح في عام 2007، واستغرق الأمر سبع سنوات حتى تم الاتفاق على «آلية وارسو» لدراسة الموضوع المتعلق بالخسائر والأضرار، ولكنها لا تقدم أي تمويل من أي نوع للمضارين.
وفي اتفاق باريس لعام 2015، نجح المتفاوضون في تضمين المادة الثامنة في الاتفاقية عن الخسائر والأضرار، ولكنها لم تأتِ بتمويل ملزم للتعامل معها، وأصرت الدول المتقدمة على إضافة نص يفيد بأن ورود هذه المادة في الاتفاقية لا يعني اعترافاً بمسؤولية، ولا يترتب عليه تعويض.
وبفضل مطالبات للدول النامية المضارة أكثر إلحاحاً ومشفوعة بالدلائل، ظهرت بوادر في قمة جلاسكو في نوفمبر 2021 للمناخ، لاستعداد ما لتمويل ملف الخسائر والأضرار، ثم ظهرت إشارات باستعداد للمساندة في اجتماعات لاحقة في هذا العام استعداداً لقمة شرم الشيخ، وذلك من عدة دول متقدمة مثل كندا والدنمارك وألمانيا ونيوزيلندا، فضلاً على اسكوتلندا ومقاطعة ولونيا البلجيكية.
ولكن يظل الأمر معلقاً دونما تمويل ملزم أو كافٍ في مسار للنقاش لم يسفر بعد عن أي تطور في التمويل المقترح لشبكة سانتياغو للخسائر والأضرار، باستثناء بعض التبرعات المتواضعة.
وعودة إلى حالة باكستان البائسة التي ما زال ثلث أرضها غارقاً تحت الماء، فتقدير الخسائر العاجلة التي لحقت بها يقدر بثلاثين مليار دولار، يعتبر الاقتصادي الأميركي المعروف جيفري ساكس أن نصفها على الأقل يرجع لتغيرات المناخ العالمية، والنصف الآخر يمكن عزوه إلى التغيرات السنوية في الطقس وممارسات استخدام الأراضي محلياً.
وحتى كتابة هذه السطور، فإن التبرعات والإعانات الدولية لم تتجاوز 1 في المائة من نصف الخسائر. فقد تبرعت الولايات المتحدة بخمسين مليون دولار، وكندا بخمسة ملايين، وقد تصل تبرعات أخرى، ولكنها ستظل ضئيلة للغاية مقارنة بالاحتياجات، ولا تتناسب بحال مع ما ألحقته الدول المتقدمة الصناعية من ضرر بالمناخ.
فهذه الدول مسؤولة تراكمياً عما يقترب من 60 في المائة من الانبعاثات الضارة المحسوبة للفترة من 1850 حتى 2020، في حين لا يتعدون 15 في المائة من سكان العالم.
ووفقاً لجيفري ساكس، فإن باكستان لا تتعدى انبعاثاتها الضارة 0.3 في المائة للفترة ذاتها، وسكانها يشكلون 3 في المائة من سكان العالم. وهذه الأرقام تبرهن على ما وصل إليه العالم من تفاوت وعدم عدالة وتملص من المسؤولية، وتعنت في استمرار أوضاع بات خرابها مشهوداً يعانيه الفقراء والمستضعفون.
وتتعلق الآمال بقمة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، وقد أخذت على عاتقها الدفع بتنفيذ التعهدات في مجالات التخفيف والتكيف والتمويل، وأن تستحث المفاوضين على أن يحددوا قواعد للعمل المناخي الملزم بتحقيق دفعة في ملف الخسائر والأضرار، وأن يتفقوا على تمويل محدد المصادر والوجهات، استجابة للخطورة الملحة لهذا الملف وأعبائه المتراكمة.
هذا علماً بأن 134 دولة نامية تقدمت في قمة المناخ السابقة بغلاسكو بطلب تمويل آلية التعامل مع الخسائر والأضرار، والتي تقدر تكلفتها بحوالي 300 مليار دولار حتى عام 2030، كحد أدنى لا يتضمن بطبيعة الحال تعويض ما لا يعوض من خسائر في أرواح البشر.
إذا تحققت انفراجة في هذا الملف المهم من ملفات العمل المناخي، فستكون مكسباً كبيراً لمصداقية التعاون الدولي، في عالم بات يعاني عجزاً في الثقة وفائضاً في الأزمات.