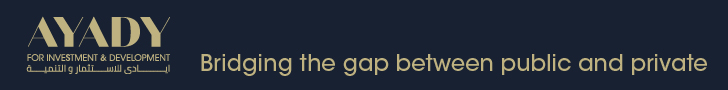بقلم د. محمود محيي الدين الخبير الاقتصادي المصري نقلا عن الشرق الأوسط _ اقتربت السنة من نهايتها إيذاناً ببدء الموسم المعتاد لتداول توقعات عن العام القادم لا تتحقق، ولنشر تنبؤات لا تصادف واقعاً، وإن اعتمد أصحابها على نماذج رياضية معقدة أو ادعوا ذلك. فظروف اللايقين التي يعيشها العالم تجعل احتمال حدوث التوقعات المعلنة من أنواع التخرص، وإن صدقت بعض هذه التوقعات فهي من المصادفات غير المحسوبة.
ولمن لديه شك، فليراجع توقعات المؤسسات الدولية على مدار السنوات الثلاث الماضية منذ اندلاع جائحة «كورونا» عن نمو الاقتصاد العالمي، ومعدلات التضخم، وأسعار السلع الرئيسية كالنفط ومواد الطعام والمعادن النفيسة، وأسعار صرف العملات الرئيسية، وليحدد مدى اقترابها من الواقع المعيش.

فظروف اللايقين الراهنة أشد بأساً في التعامل معها من أحوال المخاطرة المحدودة أو العالية التي يمكن فيها التعرف على نسب احتمال وقوع الحدث بقدر عالٍ من الدقة. فالتوقعات الجديدة في هذا العالم شديد التغير، الذي يعاني من أزمة في الثقة وفوائض في الأزمات، ليست كسابقتها من توقعات تصيب وتخطئ وتكتنفها تعقيدات شتى، التي عبّر عنها نيلز بوهلر، عالم الفيزياء الدنماركي الحائز «جائزة نوبل»، بأن «التوقع أمر في غاية الصعوبة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمستقبل». وبالتالي، يجب التعامل مع التوقعات المتواترة بدرجة أكبر من الحذر وعدم الإسراف في الاحتفاء بها إن جاءت متفائلة، وألا تصيب مستقبليها بالإحباط إن جاءت متشائمة.
وفي ظل هذه الظروف المعقدة حريّ بمؤسسات صنع القرار القيام بأمرين متلازمين: الأول يكون بالاسترشاد ببيانات فعلية ومعلومات تفصيلية محدّثة باستمرار، والثاني هو تتبع الظواهر الاقتصادية والسياسية الكبرى وتوجهاتها العامة ومدى تأثيرها على الأمور الجارية، والتحسب لها بسيناريوهات بديلة بقدر عالٍ من المرونة للتغيرات المفاجئة. فالدولة القوية يستلزمها سياسات مرنة تدعم متانتها في التصدي للصدمات المتوقعة وغير المتوقعة، وهو ما سأوضحه هنا باختصار:
فعند كتابة هذه السطور هناك مؤشرات على أن التضخم العالمي ينحسر وفقاً لأسعار البيع بالجملة، كما انخفض سعر النفط على مدار شهر بنحو 19.5 في المائة ليقترب من 72 دولاراً للبرميل رغم تخفيض إنتاجه. كذلك انخفضت تكلفة نقل السلع؛ إذ تراجعت تكلفة نقل الحاويات من الصين إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وفقاً لموقع «سي إن بي سي» بنحو 90 في المائة منذ العام الماضي، بعدما شهدت ارتفاعاً غير مسبوق بسبب خلل سلاسل الإمداد.
واستمر انخفاض معدل تسارع الأسعار في الولايات المتحدة منذ شهر يونيو الماضي، كما انخفض معدل التضخم الشهري في منطقة اليورو لأول مرة منذ 17 شهراً، وفقاً لصحيفة «الفاينانشال تايمز» اللندنية.
وستطرح هذه التغيرات التساؤل مجدداً عن توجّه أسعار الفائدة في البنوك المركزية المصدرة للعملات الرئيسية، وتوقيت تحولها إلى خفض أسعار الفائدة ومراجعة معايير توجهاتها، إذا فعلت ذلك وفقاً لسرعة التغيير المطلوب ومداه الزمني وقيمته.
ولن تخفض البنوك المركزية استجابة لدعاوى، أكثرها مقنع، بأن رفع أسعار الفائدة قد سبب ضرراً أكبر من نفع، ولكن عندما يتبيَّن لها أنه بعد كل ما تكبده الاقتصاد من تكلفة الرفع، أن معدل التضخم الرئيسي – الذي لا يتضمن أسعار الوقود والطعام – بدأ فعلاً في الانخفاض باطراد، وأن توقعات التضخم أصبحت أقل تشاؤماً.
وسيعزز قرار تخفيض سعر الفائدة مؤشرات سوق العمل من أرقام البطالة والأجور، فيلزم إجراء هذا التخفيض تفادياً لمزيد من تداعيات الركود. ومما يعقد من عملية اتخاذ القرار في الفترة الراهنة هو وقوع البنوك المركزية الرئيسية في خطأ فادح بتأخرها في رفع أسعار الفائدة، وهي لا تريد أن تلام مرة أخرى بأنها أخطأت ثانية بالهرولة بالتخارج من إجراءات تقييد السياسة النقدية قبل الأوان المحدد لها. وبالتالي، فالأرجح أن تبدأ البنوك المركزية الرئيسية في تخفيض حدة رفع أسعار الفائدة قبل أن تتحول إلى تخفيضها بعد فترة من تثبيتها.
وسيكون من المهم العمل على استعادة الثقة بين السلطات النقدية والمستثمرين والأسواق المالية، بأن تأتي القرارات متوافقة مع توجهات السوق وما تستشرفه من تغيرات، مع إتاحة معلومات أكثر دقة وتحديثاً. كما تستلزم هذه الفترات الدقيقة تدعيم التنسيق بين السياسات المالية العامة والسياسة النقدية، مع إدراك تام بأن التواصل الفعال مع الرأي العام وإشراك الأطراف المعنية كافة في مراحل اتخاذ إجراءاتها من فرائض السياسات الاقتصادية المعاصرة لا من نوافلها. فآثار السياسة الاقتصادية تعني عموم الناس، وليس نخبهم فحسب، وعليهم التحوط ضد التغيرات المتوالية في الاقتصاد، فضلاً على الاستعداد لمربكاته الصغرى والكبرى التي تشكل سبل التعامل معها مستقبل الاقتصاد في الأجل المنظور، خاصة فيما يتعلق بالديون والركود التضخمي.
وهذا ينقلنا إلى الأمر الثاني المتعلق بتتبع توجهات الظواهر الاقتصادية والسياسية الكبرى وآثارها، لمحاولة الاستفادة منها أو التوقي من مخاطرها. وهنا أشير إلى ما تكرر في عدد من الدراسات المستفيضة المهمة عما سيشكل هذا القرن الحادي والعشرين.
ففي كتابه عن قوة الأزمات، أشار المحلل السياسي الأميركي المرموق إيان بريمر، إلى ثلاث أزمات وقدرات التعامل معها ستغير موازين القوى في هذا العالم، وهي: سياسات الجوائح، والمربكات التكنولوجية، وطوارئ المناخ.
أما الدراسة الشاملة التي أشرف عليها الاقتصادي الحائز «جائزة نوبل» في الاقتصاد جون تيرول، ومعه أوليفييه بلانشار، عن مسارات الاقتصاد الفرنسي، فجاءت التحديات الكبرى في هذا الاقتصاد الغربي المتقدم ملخصة في ثلاثة موضوعات، هي: شيخوخة التركيبة السكانية، وعدم العدالة في توزيع الدخل والثروة، وتغيرات المناخ. وفي كتابه الحديث تحت عنوان «التهديدات العظمى»، أورد الاقتصادي المعروف نوريل روبيني عشرة اتجاهات عامة وظواهر خطيرة، أورد منها في أولها – وهو ما سمَّاه أمَّ الأزمات – الديون الدولية، كما تضمنت القائمة التحديات المرتبطة بالتركيبة السكانية، والركود التضخمي، وفشل القطاعين الحكومي والخاص، وانهيار العملات والاضطرابات المالية، ونهاية العولمة، والذكاء الصناعي، والحرب الباردة الجديدة، ولم تخلُ القائمة من أزمة المناخ التي عبّر عنها الكاتب بـ«أرض غير صالحة للعيش فيها».
وإذا أردت أن تكتفي بقائمة من تحدٍّ واحد يشكل هذا العالم، فيمكنك الاطلاع على كتاب الكاتبة البريطانية المتخصصة في قضايا البيئة، جايا فينس، تحت عنوان: «عصر الرحل: كيف ستشكل الهجرة المناخية عالمنا؟»، التي تحذر فيه الكاتبة من أن تدهور المناخ سيدفع بزيادة حالات الهجرة واللجوء المناخي من المناطق التي تتزايد حرارتها في الجنوب في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، إلى دول الشمال التي عليها أن تستعد لتدفقات بشرية غير مسبوقة من لاجئي المناخ، ما دامت استمرت الانبعاثات الضارة بالمناخ بأنماطها الراهنة من دون تخفيض جذري.
لا ينقص هذا العالم مجتمعاً ما يحتاجه من موارد مالية وحلول علمية وتكنولوجية للتعامل مع التحديات السابقة، سواء كانت من مربكات الأجل القصير أو مهددات الأجل الطويل، ولكن ما ينقصه حقاً هو الإرادة السياسية التي تستطيع توجيه هذه الموارد والحلول في المناطق شديدة الاحتياج إليها.
في مقال سابق عن الاقتصاد السياسي لمشروع مارشال الذي أعاد بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، ذكرت أن توجّه التعاون الدولي كان مدفوعاً بحكمة أن كسب السلام أهم من الانتصار في الحرب، وقد اندثرت هذه الحكمة مع زوال أصحابها، وأصبحت دوافع التعاون الدولي مغلوبة على أمرها، مكتفية ببواعث الخوف والشعور الضعيف بالذنب.
فالخوف هو ما قد يبرر تحركاً في بعض الأروقة لزيادة المساعدات المالية للبلدان النامية لتخفيض احتمالات الهجرة بسبب الفقر أو الاضطرابات السياسية والاقتصادية، أو الأزمات الاجتماعية والمناخية. والشعور الضعيف بالذنب هو ما قد يفسر استمرار مساعدات مالية إلى دول أفقرتها سياسات النهب في عهود الاستعمار الاستيطاني، ثم استنزاف مواردها بعدها بممارسات مستغلة، ليس أقلها سوءاً الاستمرار في تدفق الأموال غير الشرعية من دول الجنوب، وغبن شروط التبادل التجاري، والملكية الفكرية، وتباين معايير التمويل الدولي وحوكمته، وافتقاده لأسس العدل والكفاءة في إتاحة التمويل المطلوب للتنمية المستدامة، وتغيرات المناخ. وهذا يستدعي لمصلحة الدول كافة إصلاحاً هيكلياً للبناء المالي والاقتصادي العالمي، لا ذراً للرماد في العيون، أو تعهدات قلما صادفت طريقاً لتنفيذها.