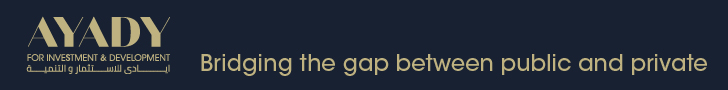د. محمود محيي الدين يكتب.. عن سياسة لا تسمى… وعالم شديد التغير
بقلم د. محمود محيي الدين الخبير الاقتصادي المصري نقلا عن الشرق الأوسط .. شرعت الولايات المتحدة ودول أوروبية وبلدان متقدمة أخرى في اتباع سياسة اقتصادية جديدة تلاحقت خطوات تطبيقها مهرولة في أعقاب أزمات متعددة متلاحقة، وستكون لها تداعيات مهمة على اقتصادات بلداننا النامية واستثماراتها وتجارتها ودور الدولة فيها.
وقبل تحميل الأزمات المترتبة على جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا بما لا تحتمل، أشير إلى أن الإجراءات المشكّلة لهذه السياسة الجديدة قد رصدتها تقارير دولية ودراسات، منها بحث في «عودة السياسة التي لن تسمى: مبادئ السياسة الصناعية» أعدّه خبراء من صندوق النقد الدولي في عام 2019، مسترشدين بنجاحات التجربة الآسيوية التي ساندت المنتجين المحليين في الصناعات المتقدمة، وتوجهها التصديري، ودفع المنافسة مع تفعيل قواعد المحاسبة بالإثابة والجزاء.

وفي عام 2020 عُقد مؤتمر لخبراء في الاقتصاد حول احتمالات عودة السياسة الصناعية بشكل جديد بما يشمل، ولا يقتصر على، تحقيق قفزات نوعية في الصناعات التحويلية التكنولوجية المتقدمة؛ وهو ما لخصت نتائجه الاقتصادية ماريانا مازوكاتو في كتاب عنونته «عودة السياسة الصناعية ودور الحكومة في تحقيق ازدهار مشترك».
وتشمل السياسة الصناعية الجديدة ما يصفه الاقتصادي روتشير أجراوال بـ«جهود الدولة لتشكيل الاقتصاد باستهداف أنشطة اقتصادية وصناعات ومشروعات محددة من خلال حزمة متنوعة كالدعم والحوافز الضريبية وتطوير البنية الأساسية وقواعد رقابية حامية ومساندة البحث والتطوير».
وعلى مدار الأعوام الثلاثة الماضية تبارى النقاش بين رفض قاطع للسياسات الصناعية كفكرة سيئة أهدرت موارد الاقتصاد في السابق في مشروعات حبذتها بيروقراطية الدولة بخسائر فادحة للقطاع العام وزيادة الديون وتراجع التنافسية والاستثمار والتصدير وتفشي البطالة المقنعة، إلى نهج جديد يعتمد على مفهوم المشاركة بين الاستثمارات العامة والخاصة، وتحديد «مهام طموحة» على غرار ما قام به الرئيس الأمرdكي السابق جون كينيدي منذ أكثر من 60 عاماً.
وقد عرضت هذا النهج خلال كلمتي في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عُقدت في بيروت في عام 2019، موضحاً أن «العالم يشهد تغيرات في موازين القوى الاقتصادية العالمية والإقليمية، تستوجب الاستفادة من منهج عملي واقعي لتحقيق التقدم.
وبمناسبة الاحتفاء بهبوط أول إنسان على سطح القمر لنا فيما فعله الرئيس كينيدي، مع وكالة الفضاء الأمرdكية مثلاً. فقد أُسست هذه الوكالة، المشهورة بـ(ناسا)، في عام 1958 لتحقيق أهداف متعددة كغزو الفضاء وتطوير التكنولوجيا في مجال عملها، إلى غير ذلك، وحُشد للوكالة من الموارد ما حُشد، وجُمع لها من العلماء ما جُمع. لكن كينيدي أنقذها من مصير بيروقراطي محتوم بأن جعل لها هدفاً محدداً، ومن دونه لظلت هائمة تطلع إلى المجهول من دون هدى أو دليل». فما فعله كينيدي هو تحديد الهدف بوصول أول إنسان إلى سطح القمر والعودة به سالماً إلى الأرض.
وبهذا حوّل غموض تعدد الأغراض، هدفاً طموحاً، محدد الزمن، سهل التخيل، يمكن الحكم عليه بالنجاح والفشل. وقد تحقق هذا الهدف فعلاً في عام 1969 بالخطوة الأولى التي خطاها رائد الفضاء نيل أرمسترونغ، وكان ذلك الإنجاز الهائل نتيجة لتوجه نطلق عليه اليوم «رمية نحو القمر».
وحالياً تجد دعماً في الولايات المتحدة على سبيل في مجال أشباه الموصلات بعد اعتماد صناعتها على استيراد 90 في المائة من احتياجاتها منها من تايوان، فوجّهت لها دعماً يبلغ 39 مليار دولار من جملة دعم مالي وفّره قانون أقرّه الكونغرس الأمريكي بتحفيز مالي بمقدار 280 مليار دولار لهذه الصناعات ومثيلاتها التي تعتمد على البحث والتطوير ومشاركة الاستثمارات الخاصة والتي ستكون محظورة عليها المشاركة في تطوير هذه الصناعات في الصين لمدة 10 سنوات.
كما يوفّر قانون آخر ذو توجه داخلي وحمائي، والمسمى قانون تخفيض التضخم، 370 مليار دولار معونات للاستثمارات في الطاقة النظيفة. وقد حاولت ما استطاعت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، في زيارتها الأخيرة للصين تخفيف أثر مثل هذه السياسات على العلاقة بين البلدين بأنه سيتم تحديد نطاق القطاعات ذات الطبيعة الخاصة للأمن القومي لأضيق الحدود.
وفي الاتحاد الأوروبي تشهد بين أعضائه تعالياً للنداءات لمواجهة السياسة الصناعية الأميركية بحماية تنافسية الأنشطة الاقتصادية الأوروبية، فيُخصص لها من صندوق التعافي من الجائحة 160 مليار يورو لمشروعات الابتكارات والتحول الرقمي وصناعة البطاريات وأنشطة العمل المناخي. وعبر المحيط الهادي ستجد 57 شركة متميزة في اليابان تحظى بدعم 500 مليار دولار من الحكومة لحثهم على الاستثمار المحلي وتخفيف الاعتماد على الصين.
على بلداننا النامية أن تدرك عاجلاً خصائص هذا الواقع الجديد وألا تضيع الزمن النفيس في التحسر على تبدل توجهات وتغير الأساليب الاقتصادية؛ فليست هذه المرة الأولى في العصر الحديث التي يشهد فيها العالم تحولاً بندولياً في إدارة الاقتصاد من النقيض إلى النقيض! ولخّص المؤرخ الاقتصادي ماكس هارتويل حركة بندولية للتيارات السائدة في حكم الاقتصاد بين القرن الثامن عشر والقرن العشرين، تراوحت بين تدخل سافر للدولة بسيطرة أفكار مدرسة الميركانتيليين أو التجاريين حتى ثبتت عدم كفاءتها؛ أعقبها تبنٍ لحرية التجارة والاقتصاد فحسنت الكفاءة ولكنها أضرت بالعدالة.
كما شهدت العقود التالية للحرب العالمية الثانية تبدلاً بين تدخل الدولة والاعتماد على السوق في تخصيص الموارد؛ فكلما ظهر فشل في أحدهما كان اللجوء للبديل. وما تغير اليوم هو سرعة انتقال هذا البندول بين مزيج منهما.
هناك اعتبار آخر أوضحتُه في دراسة مشتركة اعتمدت على مسح تطبيقي، وهو تراجع أهمية المذاهب الاقتصادية كالرأسمالية والاشتراكية، وما بينهما من مدارس اقتصادية، في تشكيل أولويات السياسات العامة وطرق تحقيقها. فنحن عالم يطبّق براغماتية القط الأسود والقط الأبيض؛ وفقاً لمقولة الزعيم الصيني دينغ جياو بينغ بأنه لا يهم لون القط ما دام يُصيد الفئران.