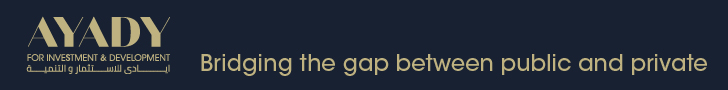د. محمود محيي الدين يكتب.. توطين التنمية في عالم شديد التغير (3)
بقلم د. محمود محيي الدين الخبير الاقتصادي المصري نقلا عن الشرق الأوسط .. مع تصاعد النزاعات والتوتر بين القوى الاقتصادية التقليدية والقوى الصاعدة برز تعبير عالم الجنوب، أو بلدان الجنوب، مستبدلاً ما جرى تسميته العالم الثالث ليعبّر عن أوضاع البلدان النامية متوسطة ومنخفضة الدخل ومدى تأثرها بالتغيرات العالمية وما تتعرض له من صدمات ومربكات. واستخدام تعبير عالم الجنوب يدمج الأبعاد الجيوسياسية مع الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية لتمييزها عن البلدان مرتفعة الدخل ذات الاقتصادات المتقدمة في الشمال.
ومن دول الشمال ما تتمتع بمنافع السبق في الثورة الصناعية، كما استفادت من الحالة المستمرة للتبادل اللامتكافئ في التجارة الدولية بينها وبين البلدان الأقل دخلاً وأجوراً؛ ومن البلدان المتقدمة ما أضاف إلى ثرواتها ما استغله من ثروات الجنوب بأساليب النهب الاستعماري، ومنهم من أضاف لنفسه مزيداً من امتيازات المنتصرين بعد الحرب العالمية الثانية.

فالمنتصر لا يكتفي بغنائم الحرب المادية، وفي لعبة الأمم، حرباً وسلماً، فإن كتابة التاريخ ليست مجرد تدوين المنتصر أحداث الماضي، ولكن الأهم هو رسم قواعد اللعبة في المستقبل لضمان استمرار التمتع بمكاسب النصر.
وتبشر التطورات في عالم الجنوب بتمردها على ركود الأحوال في العهد البائد لمفهوم العالم الثالث. وقد باد هذا المفهوم وتبعاته لارتباطه بالعالم الثاني الذي زال مع سقوط حائط برلين في عام 1989 وتحرُّر دول ما وراء الستار الحديدي، مما كبح اقتصاداتها وقمع حرياتها لعقود.
كما أن ما يمكن وصفه بالعالم الأول، والمقصود به البلدان الرأسمالية، قد تعرض لزلزال الأزمة المالية العالمية في عام 2008 الذي كان مدمراً لقواعده وليس فقط لبعض أعمدته.
فالآثار السياسية المحلية والدولية على البلدان الرأسمالية أكثر خطراً وأطول مدى من التداعيات الاقتصادية. يعبّر عن ذلك المشهد المستمر لتصاعد تيارات اليمين المتطرف وموجات عنصرية، واختيارات عجيبة لقيادات سياسية لسدة الحكم بانتخابات عبَّرت نتائجها عن استقطاب سياسي حاد واضطرابات اجتماعية وتفاوت اقتصادي.
كما أدركت البلدان المتقدمة أن الميزان النسبي للقوة الاقتصادية بدأ يميل تجاه دول الشرق الصاعدة حيث الصين والهند وبلدان الآسيان، حيث يجتمع الزخم البشري المتدفق مع حيوية الاستثمار في التعلم والمعرفة والابتكار، وزيادة الإنتاجية ومن ثمَّ نمو النواتج المحلية والدخول مع بروز طبقة وسطى شديدة الطموح والعنفوان.
فرغم الصدمات والمربكات، وثمة هفوات في التعامل معها، إلا أن هناك صعوداً مطرداً لبلدان من عالم الجنوب التي تضم مع اقتصادات الشرق الصاعدة دولاً من أمريكا اللاتينية مع تجارب عازمة على التقدم في الشرق الأوسط وأفريقيا. ومع هذه التطورات المتسارعة ما كان من اقتصادات متقدمة إلا أن نفضت التراب عن أدلة العمل بالأساليب الحمائية العتيقة ومنها ما بطل العمل به منذ أزمنة غابرة.
وقد جرى حوار شديد الأهمية حول مجموعة الإجراءات الأخيرة المتخَذة في واشنطن للسياسة الصناعية الجديدة وتداعياتها على السياسة الخارجية والعلاقات الاقتصادية الدولية. كان الحوار الذي استضافه معهد «بيترسون للاقتصاد الدولي»، بين رجل الدولة روبرت زوليك الذي عمل ممثلاً تجارياً ونائباً لوزير الخارجية الأميركية، والاقتصادي الشهير لاري سمرز، وزير الخزانة الأمريكية الأسبق؛ واللافت هو اتفاق قيادتين مختلفتي الانتماء الحزبي والخلفية التحليلية لكل منهما على تداعيات سياسات الدعم الضخم والقيود التجارية، وهل ستفيد حقاً في نهاية الأمر قطاعات الاقتصاد وسوق العمل وعموم المستهلكين.
وقد ضرب المتحاوران مثلاً بالتأثير السلبي لبعض هذه الإجراءات على صناعة السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة بزيادة التعريفة الجمركية الحمائية في عهد ترامب، الذي ردت عليه الصين بزيادة مماثلة كان من نتائجها أن انتقلت «تسلا»، عملاق صناعة السيارات الكهربائية، للاستثمار في الصين وإقامة نسق صناعي متقدم لها هناك، بما جعل الصين أكثر تقدماً وإنتاجاً وتصديراً للسيارات الكهربائية.
وبدلاً من أن تخفض إدارة بايدن معوقات التعريفة الجمركية الضارة أبقتها وتبنّت سياسات «اشترِ الأمريكي الصنع»، وزادت من الدعم بما هدد بالمعاملة بالمثل الشركاء التجاريين في أوروبا، وبدلاً من مراجعة هذه الإجراءات فضّلت الولايات المتحدة أن تقوم باستثناء السيارات الأوروبية في حالة طرحها في السوق بنظام التأجير التمويلي.
فزادت السيارات أوروبية الصنع في السوق الأمريكية التي كان من الأفضل لمستهلكيها ومنتجيها ألا تتعرض لهذا المزيج من الحمائية والدعم ثم الاستثناءات وفقاً للمتحاوريْن، خصوصاً إذا وُضع في الاعتبار الأثر على الموازنة العامة وزيادة الديون والتضخم والضرائب المستقبلية.
ومن شأن هذه الإجراءات، أن تُضعف أيضاً تأثير الولايات المتحدة على الساحة العالمية في إطار مفاوضات التجارة الدولية مستقبلاً بما في ذلك من تأثير سلبي على مصالح الولايات المتحدة التي يخشى عليها المتحاوران.
ومتابع مثل هذا الحوار ومحلل السياسات يجد أننا بصدد مجموعة من الإجراءات التجريبية تنزع إلى الحمائية ذات توجه داخلي تعوق حركة التجارة وتدفع بتمويلات ضخمة مدعومة لقطاعات مختارة فيما يمكن تعريفه بـ«توافق واشنطن الجديد» في مقابل التوافق القديم الذي كان يَعتمد، بقدر من التبسيط، على تحرير الاقتصاد والتجارة وتخفيف القيود الذي لم يكن أيضاً خالياً من المثالب سواء باعتبارات الاقتصاد السياسي لفرضها وكذلك عند التطبيق.
من شأن هذه الإجراءات التي أتى بعضها مرتجلاً ومنفعلاً وتجريبياً، وإن تحججت بالتصدي لتغيرات المناخ ودفع التحول الأخضر، وتذرعت بحماية المصالح الاقتصادية العامة ومساندة فئات المجتمع الأفقر والطبقة الوسطى… أن تحمّل الاقتصاد والأجيال المتعاقبة تكاليف باهظة للدعم والديون والتضخم. ومن شأنها أيضاً أن تعامَل بإجراءات مماثلة من الشركاء (الأصدقاء) التجاريين، وهو ما حدث بالفعل، ويهدد بمزيد من التوتر مع الصين وزيادة الارتباك في سلاسل الإمداد. ولهذا كله تأثير على اقتصادات بلدان الجنوب وعُبّر عنه في صياغة أولوياتها وسياساتها وتمويلها في خضمّ موجات دافقة من الدعم والضرائب والرسوم الحمائية، وهو ما سيتناوله مقال قادم.