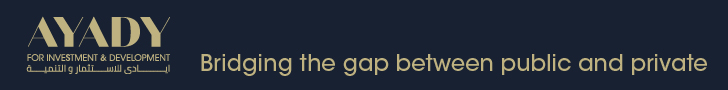د. محمود محيي الدين يكتب.. الحروب والديون والعملة «الصعبة»
بقلم د. محمود محيي الدين الخبير الاقتصادي المصري نقلا عن الشرق الأوسط .. يشهد العالم حروباً وصراعات مسلحة لم يشهدها منذ وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها.
ومن أشد الحروب بشاعة وإيلاماً ما يتعرض فيها المدنيون والأبرياء المسالمون من فقدان للأرواح، وإصابات جسيمة، وإهلاك للممتلكات، وفقدان لأسباب الحياة والمعيشة على مشهد ومسمع من العالم أجمع؛ كالمأساة التي تعيشها غزة على مدار الساعة رغم ما صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمناشدات الملحة بإيقاف القصف المروع وآلة الحرب ولو لهدنة إنسانية.

ومن ناحية أخرى، فإن الحروب والصراعات وإن جاءت في دائرة جغرافية محددة كما يحدث في أوكرانيا وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة لكن تداعياتها الاقتصادية والسياسية الإقليمية والعالمية ظاهرة للعيان مع مخاطر متنامية لتوسع دائرة الحرب؛ ومع توالي الصراعات الجيوسياسية وتدهور الثقة بالنظام الدولي هناك نذر بصراعات مسلحة أكثر انتشاراً وحروب أكثر دماراً مع زيادة حدة الاستقطاب الدولي.
وفي إشارة للاستقرار النسبي على الصعيد العالمي في أثناء الحرب الباردة بين المعسكر الشرقي بزعامة الاتحاد السوفياتي والمعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة، يرى المؤرخ هارولد جيمس الأستاذ بجامعة برينستون الأميركية أن وراء ذلك عاملين، الأول التوازن النووي ضمن الردع المتبادل بين القوتين العظميين في وقتها ببديل وحيد هو الدمار الشامل للطرفين في حالة الحرب.
والثاني هو هيمنة الدولار بوصفه عملة صعبة والذي عدّ سلاحاً نووياً مالياً تجري عليه ذات القاعدة بألا يجري تسليحه وألا يُستخدم إلا دعامة للاستقرار النقدي والمالي، بما عدّ وقتئذ أن تسليح الدولار إيذان بدمار نظامه شأنه في هذا شأن الأسلحة النووية التي رُوج لها أن كل قوتها في قدرتها فقط على الردع؛ وأن نهايتها، بل نهاية ممتلكيها، في حال استخدامها.
هذا مما كان من مسلّمات عهد الحرب الباردة البائد، أما العهد العالمي الحالي، الذي شهد انفراداً لفترة لقطب واحد، بعد سقوط حائط برلين وانهيار الاتحاد السوفياتي بلا حرب إلا ما كان من حرب باردة، ثم تعدداً للأقطاب بعد تصاعد لقوى جديدة مدفوعة بأوزانها الاقتصادية.
ولا يبدو أن للعهد الحالي مسلّمات تذكر، فظروف اللايقين وغياب القيادة وعجز الثقة وفائض الأزمات تطغى عليه. فها هي الأسلحة النووية يُلوح باستخدامها مراراً بعد بداية الحرب الأوكرانية؛ أما الدولار فقد جرى تسليحه بمنع روسيا من استخدامه في المعاملات الدولية بعد هذه الحرب، وكانت قد منعت من استخدام نظام «السويفت» للتحويلات البنكية من قبل، بعد إلحاقها لجزر القرم في عام 2014.
ولكي تكتسب العملة صفتها بوصفها عملة صعبة أو عملة احتياطية في النظام النقدي الدولي، فعليها أولاً ألا تكون عملة سهلة محلياً، بمعنى أن يرضى بها عموم الناس في القيام بوظائفها الثلاث المتعارف عليها بوصفها وحدة للحساب في المعاملات؛ ووسيلة مقبولة لدفع المستحقات ومخزناً للقيمة؛ أما إذا صارت العملة المصدرة سهلة بانهيار مستمر لقيمتها بسبب التضخم والتوسع في المعروض منها لسداد الديون، فسينصرف الناس عنها بإحلالهم نقوداً أخرى محلها، أو باللجوء لوسائل التوقي من التضخم كالذهب.
وإذا ما استقرت العملة محلياً وتوسع اقتصادها إنتاجاً واستثماراً وتصديراً للخارج فسيقبل الناس عليها من خارج حدود الدولة لتقوم بذات الوظائف الثلاث عبر الحدود لتصبح بذلك عملة دولية في تسوية المعاملات.
وإذا ما تطور شأن العملة الدولية فتمتعت باستقرار اقتصادي وسياسي وقوة للقانون تساندها في بلادها المصدرة صارت عملة احتياطية، فتستثمر البنوك المركزية والمؤسسات في الأدوات المالية المقومة بها كأذون وسندات الخزانة استفادة من سيولتها العالية، وحماية حقوق حامليها عبر الوقت.
وللدول المصدرة للعملة الصعبة امتيازات كبرى منها ما يبلغ حد الامتياز السخي الفياض على اقتصادها: بأن تقترض دولياً بعملتها المحلية ثم تكلف عملياً كل حامل للدولار حول العالم بالمساهمة في تكاليف سداد ديونها برفعها معدل التضخم الذي ينتقص من قيمة العملة.
تماماً كحال الدولار الأميركي الذي ورث عرش الجنيه الإسترليني رسمياً في عام 1956 بعد حرب السويس، المشهورة بالعدوان الثلاثي على مصر؛ إذ ظهر جلياً بعد هذه الحرب أن الغلبة في المعسكر الغربي للولايات المتحدة التي أملت شروط وقف القتال تاركة بريطانيا تدرس تداعيات ما بات يعرف بعدها «بلحظة السويس»، وهي اللحظة التي يدرك فيها الطرف الأضعف حقيقة ما صار إليه من ضعف شهد به القاصي والداني، إلا أنه استمر في إنكاره لما كان عليه في عهد سابق من مجد، وظن أن ما يعتريه من ضعف مؤقت وأنه سيستعيد المجد التليد ولكن هيهات.
فقد كان الإسترليني عملة صعبة مسيطرة بارتياح على الاقتصاد العالمي حتى الحرب العالمية الأولى التي كبّدت بريطانيا خسائر اقتصادية ومالية رغم انتصارها السياسي والعسكري؛ فباعت أصولاً واستدانت بما يتجاوز 130 في المائة من ناتجها المحلي لتمويل المجهود الحربي بما يقدره الاقتصادي الأمريكي باري أيكنغرين بستة أمثال مستوى ديونها قبل الحرب.
ورغم ظهور الدولار منافساً محتملاً للإسترليني في العشرينات فإن الحكومة البريطانية اتخذت إجراءات للسيطرة على التضخم وضغط الإنفاق بما جعل الإسترليني يصمد في المنافسة الدولية؛ وهو ما كان هدفاً جيوسياسياً من مكونات الاحتفاظ بالقوة الشاملة لمركز الإمبراطورية التي شرعت الشمس في الأفول عنها بعدما كانت لا تغرب عنها أبداً.
ثم جاءت الحرب العالمية الثانية فخرجت بريطانيا منها منتصرة عسكرياً وسياسياً مرة أخرى، ولكن بديون خارجية أكبر ومع ازدياد التزاماتها محلياً اضطُرت لتخفيض قيمة عملتها بعد الحرب. وشهد الإسترليني تراجعاً عن الاحتفاظ به من قبل البنوك المركزية، وانخفض الطلب عليه، ثم جاءت لحظة السويس الحاسمة التي امتنع فيها الرئيس الأميركي أيزنهاور عن مساندة بريطانيا وعملتها التي انخفضت بحدة إلا بعد انسحاب قواتها ووقف حرب السويس.
والسؤال الملح: هل سيستمر الدولار في هيمنته في هذا العالم المضطرب الشديد التغير؟ وهذا ما سنتناول إجابته في مقال مقبل.