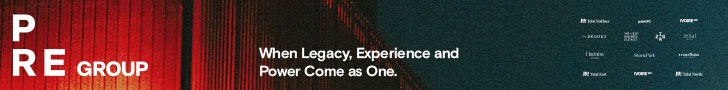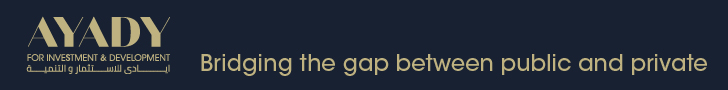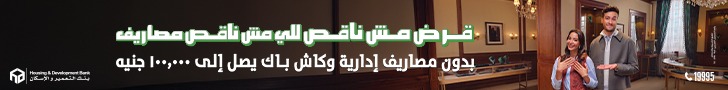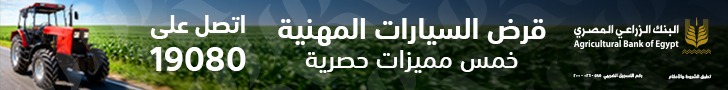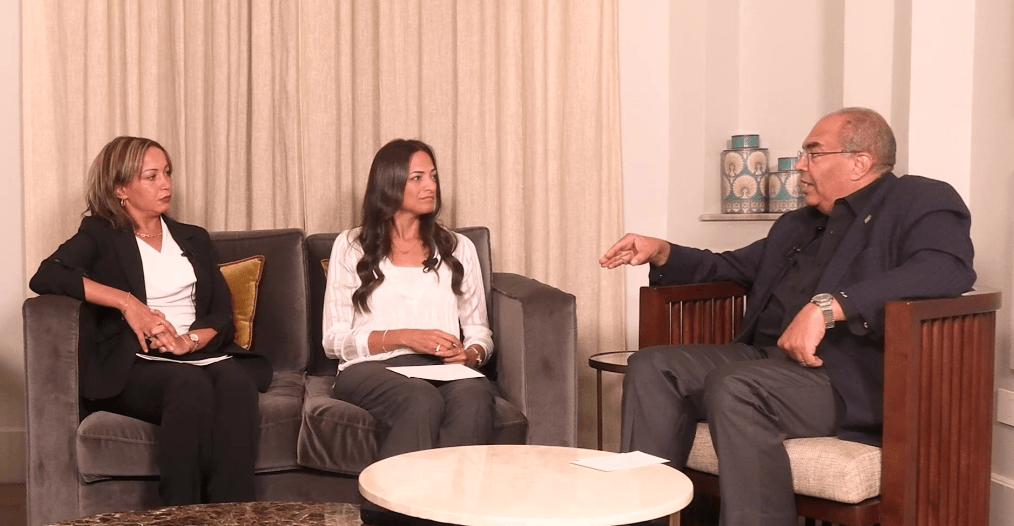في اللقاء 29 من صالون حابي.. حوار غير تقليدي مع الدكتور محمود محيي الدين
متفائل بدرجة (10 من 10) تجاه مستقبل الاقتصاد المصري
في واحد من أهم لقاءاته.. استضاف صالون جريدة حابي، الخبرة الاقتصادية المصرية والدولية الكبيرة، الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، المدير التنفيذي السابق بصندوق النقد الدولي، ووزير الاستثمار المصري الأسبق، في حوار موسع، ألقى الضوء على حال الاقتصاد المصري، ونقاطه المضيئة، وتحدياته أيضًا.

تضمن اللقاء عددًا واسعًا من المحاور، من بينها، تقييم نتائج برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، والإصلاحات الهيكلية، ودور الدولة في الاقتصاد، وبرنامج الطروحات، وتنافسية مناخ الأعمال في مصر قياسًا بالدول المحيطة، وغيرها من المحاول الأكثر تفصيلًا.
أدار اللقاء: أحمد رضوان الرئيس التنفيذي ورئيس تحرير جريدة حابي، وياسمين منير مدير التحرير والشريك المؤسس لجريدة حابي، ورضوى إبراهيم مدير التحرير والشريك المؤسس لجريدة حابي، وإلى تفاصيل اللقاء.
أحمد رضوان: أهلًا وسهلًا بحضراتكم في لقاء جديد من صالون حابي، اليوم معنا خبرة نفتخر بها، وأقول ذلك بوضوح، هو الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي ووزير الاستثمار الأسبق.
أهلًا وسهلاً بحضرتك.
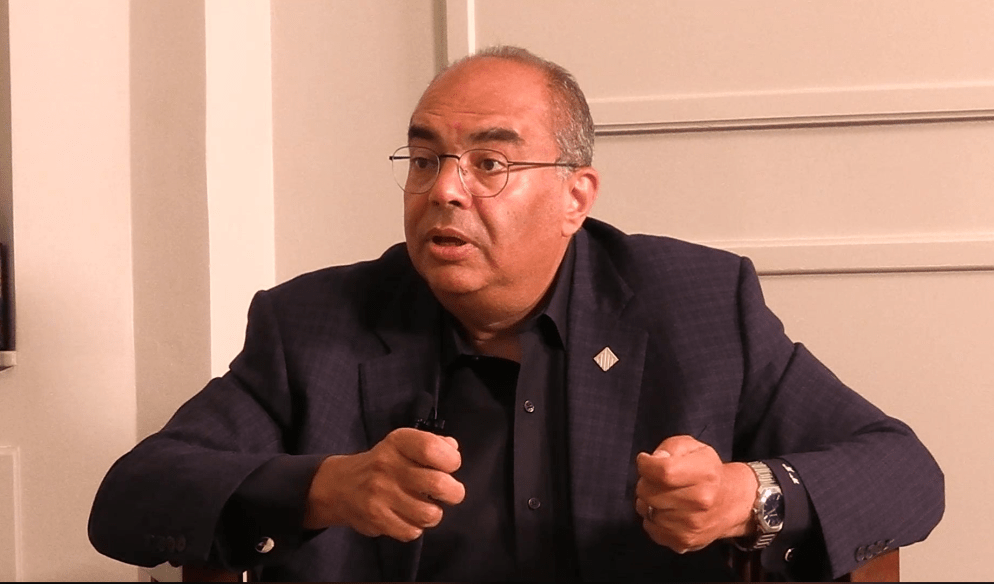
د. محمود محيي الدين: أهلًا وسهلًا أتشرف بكم.
أحمد رضوان: نعرف أن جدول أعمالك مزدحم ولذلك سندخل في الموضوع مباشرةً، سنبدأ بالاقتصاد المصري بعد تنفيذ الكثير من برامج الإصلاح خلال السنوات الأخيرة، من وجهة نظرك ما هي النقاط المضيئة ونقاط الضعف في الاقتصاد خلال وقتنا الحالي؟
أتمنى انتهاء البرنامج مع صندوق النقد بنجاح كبير في نوفمبر 2026
د. محمود محيي الدين: في الحقيقة أتحدث عن برامج الإصلاح باعتبارها شاملة لكل الأبعاد والقطاعات والموضوعات الاقتصادية، أما البرامج الأخيرة التي تمت في مصر اعتبارًا من 2016، حيث هيمنت عليها العلاقة مع صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2016، ومن المفترض وأتمنى وأرجو وأدعو أن ينتهي البرنامج بنجاح كبير في نوفمبر 2026.
أحمد رضوان: هل ما تتمناه يتوافق مع توقعاتك؟
د. محمود محيي الدين: وفقًا للمؤشرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي وفي إطار المراجعات الأربعة التي تمت، مصر التزمت ببعض الشروط الموضوعة وبالتالي هذه المؤشرات تشير إلى إمكانية استكمال البرنامج.
دمج مراجعتين يتطلب ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ الإجراءات المطلوبة
وأوضح هنا أنه عندما يكون هناك دمج لمراجعتين، فهذا معناه أنه لم يتم استقدام مراجعة، بل أُرجئت واحدة مما يعني أن هناك بعض الإجراءات التي تحتاج إلى تنفيذها.
في حين أن التقرير الصادر عن الصندوق يقول إن مصر أنجزت ما هو مطلوب في إطار الاعتبار النقدي والسياسات النقدية وسعر الصرف، كما أنجزت المتطلبات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والمؤشرات المرتبطة بها.
ولكن هناك مشكلة في الإصلاحات الهيكيلة محل تركيز الصندوق، والذي يلخصها في مدى إمكانياتك لتعبئة موارد من الخارج ربطًا بتخارج الدولة من الأصول المملوكة لها عبر برنامج الطروحات.
ومن الواضح أن ملف التخارج لم يتم إنجازه بالشكل المرجو، وبالتالي تم الإرجاء بالدمج حتى يتم التعامل مع هذا الملف، ثم انصرف النظر إلى التركيز على بقية المتطلبات للمراجعة السادسة.
لو أنجزت مصر هاتين المراجعتين يتبقى أمامها مراجعتان فقط لا غير على مدار العام المقبل.
أحمد رضوان: ما هي نقاط القوة التي تراها؟
تحسّن نسبي في الأداء المالي والنقدي لمصر
د. محمود محيي الدين: تكمن نقاط القوة في أن مصر بدأت برنامجها مع الصندوق بخلل في الأداء المالي والنقدي، إلا أن هذا الوضع تحسّن نسبيًّا.
عموم الناس لا تتعايش مع المؤشرات الاقتصادية الكلية
أتحدث هنا عن المؤشرات الاقتصادية الكلية، فالذي يتابعني من عموم الناس الذين تحدثت عنهم في مقال وتم نشره في موقعكم الإلكتروني، فإن عموم الناس غير معنيين بالمؤشرات الكلية للاقتصاد، بمعنى أنهم عند قراءة مؤشر التضخم لا يشعرون بتشبع أو عند متابعة مؤشر النمو سيشعرون بانتعاشة.
إلا أن عموم الناس يشعرون بهذه الانتعاشة عندما يكون النمو محققًا في قطاعاتهم، ويصل إلى الأماكن التي يعيشون فيها بشكل مباشر في أحوال، وبشكل غير مباشر في أحوال أخرى.
لكن أتحدث هنا عن المعنيين بالمؤشرات الاقتصادية الكلية الذين كانوا منزعجين من قراءاتها، حيث كانت في حالة حرجة سواء في عام 2016 ثم أكثر حرجًا في عام 2022.
وأعتقد أن سنوات 2021 و2022 وبدايات عام 2023 كانت الأسوأ في التاريخ الاقتصادي، حيث عانت المؤشرات الاقتصادية من انفلات في التضخم ومشكلة في عجز الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن التداعيات السلبية للغاية بسبب الإجراءات غير الموفقة لمنع الاستيراد.
عام 2024 شهد انفراجة قوية بعد فترة من التحديات
ثم رأينا انفراجات في عام 2024 تزامنت مع إتمام مبادلات وطروحات بجانب مشاركات مع الاتحاد الأوروبي واستمرار الدعم المقدّم من صندوق النقد الدولي.
فبالمعنى الاقتصادي للمؤشرات الاقتصادية الكلية، فإن الوضع تحسن نسبيًّا ولكن هل هو الأفضل؟ بالطبع لا نظرًا لأن البنك المركزي يستهدف معدل تضخم عند 7% يزيد أو ينقص بنسبة 2%.
النمو الاقتصادي المستدام يتطلب السيطرة على التضخم
سؤال آخر: هل نحن عند الرقم المستهدف للتضخم؟ بالطبع لا ما زلنا بعيدين ولكن في الوقت نفسه معدل التضخم الحالي لم يبلغ 40% على سبيل المثال، فبالتأكيد نحن أكثر قربًا من هدف البنك المركزي الآن مما كنا عليه من عام مضى، وهذا أمر جيد.
الأمر الآخر الأكثر إيجابية، هو اختفاء السوق الموازية للنقد الأجنبي إلا في نطاقات ضيقة مرتبطة بالمعاملات غير المشروعة أو غير ذلك ولكنها محدودة، أما الأساس السائد فهو وجود استقرار في سوق النقد الأجنبي.
وأوضح هنا أنني غير معني بتحركات سعر صرف الدولار، سواء كان بـ 50 جنيهًا أو أصبح 48 جنيهًا أو 52 جنيهًا أو توقعات الأسعار المستقبلية.
وفرة النقد الأجنبي وإتاحة تدبيره.. من أهم النقاط المضيئة
أما المسألة الأكثر أهمية هنا فهي وفرة النقد الأجنبي باستقرار وبإمكانية عالية لكل من المستثمر والمتاجر والمسافر مع تغطية احتياجاتهم المُلحّة من الدولار.
وأشير هنا إلى أننا شهدنا الدولار بأسعار 70 قرشًا، ورأيناه قد هاجم الـ 70 جنيهًا، ولكن العبرة في توفر الدولار في سوق النقد الأجنبي بسعره الرسمي وبالشكل الذي يسمح بتدبيره للمستثمر والمصدر.
مع العلم بأن بعد سنوات ليست بعيدة حديثنا عن النقد الأجنبي ليس بالضرورة أن يكون عن الدولار في ظل ما نراه من ارتباك في الإدارة الأمريكية اقتصاديًّا في هذا الموضوع، ولكن إلى أن تأتي عملة أو عملات أخرى محل نظر واعتبار دعونا نتحدث عن الدولار والعملات الأخرى التي نعرفها ومنها اليورو، وقد نستطيع التحدث عن اليوان الصيني أيضًا في مرحلة أخرى.
المؤشرات الخاصة بالدين العام الخارجي تحسّنت نسبيًّا
رجوعًا إلى الموازنة العامة للدولة، فالمؤشرات الخاصة بالدين العام الخارجي تحسّنت نسبيًّا على غرار معالجة الخلل في الأداء المالي والنقدي إلى حد كبير، ولكن سأطرح سؤالًا: هل الموازنة العامة للدولة في الوضع الأمثل؟ حتمًا لا، ليست في الوضع الأمثل.

واستند في ذلك إلى أنني كمسؤول عملت على مدار الفترة الماضية، خاصةً في إطار طبيعة عملي في تمويل التنمية المستدامة مثلما قدمتني، فضلًا عن أنني معني بملف المديونية الخارجية والأزمات التي تعترض الدول.
ملف خدمة الدين هو موضوع في غاية الأهمية. والنسبة الشهيرة الخاصة بالدين العام وليس الخارجي فقط تكون في حدود الـ 60%، وأؤكد على أن الاتحاد الأوروبي هو الذي وضع هذه النسبة.
تأثير قوي لخدمة الدين على الإنفاق العام وأولوياته
ولكن هناك مؤشرات أكثر أهمية بالنسبة لمصر كدولة نامية، ومنها تأثير خدمة الدين على الإنفاق العام وأولوياته، وأوضح هنا أنه عندما يكون الإنفاق على خدمة الدين أعلى مما يتم إنفاقه على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية، حينها ستطرأ مشكلة، إلا أن حلها يعتمد أولًا على السيطرة على الدين، وثانيًا العمل على تقليل الأسباب المؤدية للاستدانة من خلال التعامل مع المنبع، بمعنى إذا كانت الدولة تقوم بنشاط اقتصادي مباشر فليتفضل القطاع الخاص أو أن يكون بنظام المشاركة، والموضوعات هنا مرتبطة ما بين مؤشرات كلية وكيفية أداء الدولة في مشروعاتها المختلفة المعنية.
مثال توضيحي يبرز الفارق بين المقارنات، وأذكره هنا خاصةً مع وجود مراجعة إيجابية من جانب الدولة في هذا الاتجاه مؤخرًا، ففي حال قررت مصر إقامة مشروع بنية أساسية ضخمة، وليكن مطارًا جديدًا في واحدة من محافظات مصر في كفر الشيخ أو البحيرة على سبيل المثال، ولهم الحق في أن تكون لديهم مثل هذه المطارات، هل ستنفذه الدولة بالاعتماد على الاقتراض من البنك الدولي أو بنك التنمية الإفريقية، أم أنه من المفترض أن يكون بنظام المشاركة؟
الإجابة المثلى على هذا الطرح هي بنظام المشاركة مع القطاع الخاص تجنبًا لعدم تكبيل الدولة بأعباء الإستدانة، فضلًا عن أن الإدارة الأمنية لهذا المرفق ستكون تابعة إلى الدولة، والرقابة ستكون من خلال الحكومة وأجهزتها الأمنية.
أحمد رضوان: دور الدولة في الاقتصاد سيكون محورًا مهمًّا جدًّا، سنتحدث عنه باستفاضة لاحقًا، ولكن أود قبل الانتقال إليه أن نركز حاليًا على ما هي التحديات التي تراها الآن؟ خاصةً أن المؤشرات الكلية للاقتصاد أصبحت «مريحة» إلى حد ما، ويجوز التحرك حولها والعمل على تحسينها، هل ترى أن هناك إصلاحات هيكلية في الاقتصاد لم يتم التعامل معها بالصورة المثلى؟
د. محمود محيي الدين: في الحقيقة القضايا الكلية والهيكلية والمؤسسية والمالية والنقدية جميعها محل الإصلاحات حاليًا، وكل هذه الأمور هي أهداف وسيطة، الهدف الأعلى منها أن تحقق نموًّا اقتصاديًّا مطردًا بجانب زيادة التشغيل، وحتى يكون هناك نمو اقتصادي مستدام يتطلب ذلك السيطرة على التضخم، بجانب الموازنة بين القطاعات المختلفة، مع وجود عدالة في توزيع الدخل والثروة.
مصر يجب أن تتمرد على الحيز الضيق في التعامل مع الصندوق
إلا أن مؤشرات تنمية الاقتصاد المصري مختلفة عن المؤشرات التي تحدثنا عنها، ولذلك عندما تحدثت مؤخرًا عن موضوع العلاقة مع الصندوق، وقلت إن مصر يجب أن تتمرد على الحيز الضيق في التعامل مع صندوق النقد الدولي. فمن الواجب فهم ضرورة استكمال البرنامج الحالي وبنجاح مما يسمح لمصر بالاستناد إليه فيما هو أهم وأكثر شمولًا وعمقًا من هذا البرنامج الذي ركز بطبيعته على ما يجيده الصندوق.
تعبير مجازي على حالة مصر، بأنها ذهبت لدكتور عيون في حين أنها قد تعاني من مشكلة أخرى في الركبة، ولذلك لا يجوز لوم طبيب العيون على أنه لم يعالج الركبة، وقد يرشح هذا الدكتور طبيبًا آخر يستطيع معالجة الركبة.
أحمد رضوان: وهل يتعارض الذهاب إلى طبيب عيون وطبيب آخر يعالج الركبة في الوقت نفسه؟
د. محمود محيي الدين: هذا الخطأ يعتبر خطأك نظرًا لأنك لم تذهب إلى الطبيب الثاني أو لم تعالج نفسك داخليًا لهذا الموضوع، لأن برنامج الصندوق متعارف عليه من البداية، وهو اللجوء له في حالة وجود اختلالات مالية ونقدية.
الأمر الثاني الذي لا ثالث له، هو أن صندوق النقد الدولي يعترف بوزير المالية ومحافظ البنك المركزي، أما بقية الوزراء فيتم التحدث معهم بحسب قطاعاتهم، بمعنى إذا كان وزير قطاعي يتم التحدث معه في القضايا المتعلقة بقطاعه في إطار منظوره من خلال الموازنة العامة للدولة.
حين أقدم صندوق النقد الدولي على الدخول في الموضوعات المتعلقة بالبيئة والاستدامة والمناخ مؤخرًا، أطلق برنامجًا خاصًّا لتمويل محدد مرتبط بالتحول الأخضر وتغيرات المناخ، حيث إن المحور الأساسي فيه والمدخل الرئيسي هو الموازنة العامة للدولة، ولا يتعامل مع هذا الموضوع باعتباره مثلًا تفاوض مع صندوق التمويل الأخضر أو البنك الدولي أو مؤسسة بيئية، وإنما هو طبيعة عمله المالية والنقدية.
رضوى إبراهيم: بعيدًا عن الإصلاحات المنفذة بالتنسيق مع الصندوق، ما هي الإصلاحات الأخرى التي من المفترض تنفيذها؟
د. محمود محيي الدين: برنامج صندوق النقد الدولي تطلب بالفعل إجراء إصلاحات مالية ونقدية مع تولية الدولة الموضوعات الخاصة بالنمو والأبعاد الاجتماعية والرعاية الخاصة اهتمامًا خاصًّا، والقيام بذلك الدور من خلال الشراكة مع شركاء التنمية في الأمور الداخلية.
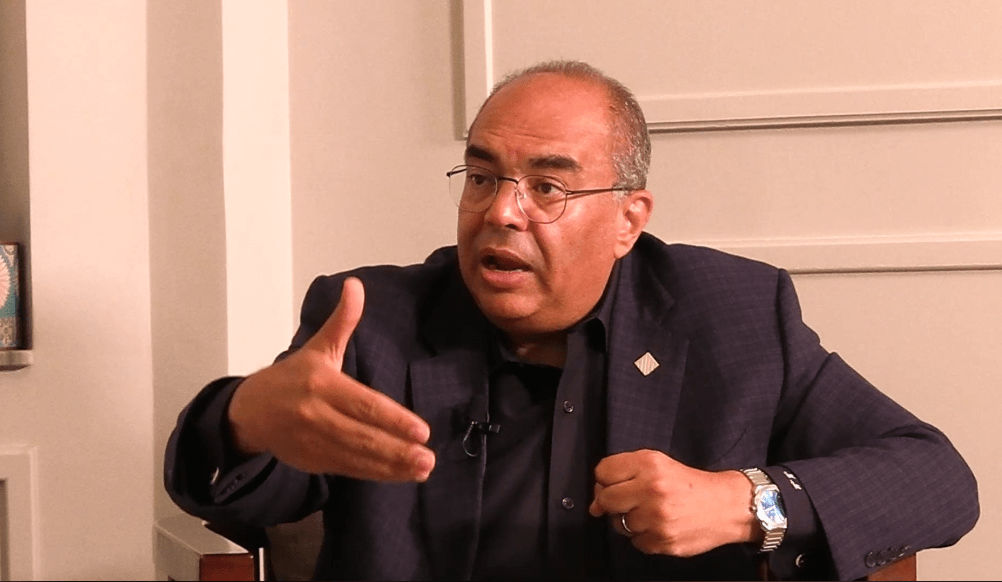
الصندوق لا يتمتع بمزايا نسبية في الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية
من واقع تجربة عملي داخل صندوق النقد الدولي وفي الخارج، أقول إن الصندوق لا يتمتع بمزايا نسبية في هذا الموضوع، ويعتمد على جهات أخرى في الأمور المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية والمؤسسية.
ولذلك يقوم الصندوق بتحويلها إلى أمور يسهل عليه فهمها إلى مردود الإصلاحات الهيكلية والمالية على الموازنة العامة للدولة نظرًا لأنهم يجيدون عملهم بشكل محترف.
الصندوق يختزل الإصلاحات المالية والهيكلية في برنامج الطروحات
وبالتالي يختزل الصندوق هذه الإصلاحات المالية والهيكلية في برنامج الطروحات، مع عدم تركيزه على تصدير الإيجابيات المأمولة، ومنها كفاءة الإنتاج ومزيد من التشغيل والتنافسية الدولية.
وفي الواقع كل هذه الأمور مهمة ولكنها لا تعني الصندوق، إنما يركز على الآثار الواقعة على الموازنة العامة للدولة وفرص استقدام استثمارات أجنبية، بما يسمح بمساندتها لبرنامج التمويل.
بالرجوع إلى حديثك عن الذهاب إلى طبيب عيون، كان من المفترض الذهاب لأطباء آخرين، وقد يعطيك طبيب العيون دواء له أثر سلبي، فمن الواجب معالجته، فقد يكون هناك آثار اجتماعية واقتصادية على مجال معين أو فرص التشغيل، في حين أن برامج الصندوق تعتبر مقيدة لأنها تهتم بمسألة تقييد الطلب لإحكام الموازنة العامة للدولة قدر المستطاع.
ياسمين منير: الدكتور محمود نتحدث حاليًا عن تحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية الكلية.. فهل تمكّنت مصر من الوقوف على أرضية صلبة جراء هذا التحسّن من خلال القدرة على تنفيذ الإجراءات الإصلاحية التي تتحدث عنها نظرًا لأننا نتحدث عن برنامج إصلاح حاليًا يمتد لحوالي 10 سنوات.
د. محمود محيي الدين: برنامج إصلاح محدود في إطار برنامج صندوق النقد الدولي.
ياسمين منير: وهذا الإصلاح المحدود قلل القدرة على السير في الاتجاهات الأخرى وفقًا لما هو مطلوب، فهل مصر أصبحت لديها المساحة الكافية بعد التحسّن النسبي لإجراء الإصلاحات المرجوة، أم قد يحدث خلل آخر في مؤشرات الاقتصاد الكلي؟
د. محمود محيي الدين: بالمثل أيضًا ما قلته لكم عن موضوع طبيب العيون، فأنت ذهبت لهذا الدكتور وجلست معه وعندما عدت إلى البيت أهل بيتك سألولك، ماذا فعلت عند دكتور العيون؟ لتجيب بأن الطبيب قال: «إن نظري تحسّن وستكون العين أكثر قدرة على النظر”، وبذلك تكون قد ركزت اهتمامك واهتمام بيتك والرأي العام بمراجعاتك مع طبيب العيون.
ولكن في هذه الأثناء أبعاد الجسم الأخرى التي تعتبر موضوع البرنامج الأشمل للتنمية، لن تتم أيضا إلا إذا تحسّن الوضع القائم.
وفي الواقع مراجعات المؤشرات الاقتصادية في المراجعة الرابعة أظهرت تحسّنًا نسبيًّا، وهو ما يسمح بمراجعة موضوعات التنمية، ومنها التعليم والرعاية الصحية ومكافة الفقر وعدالة توزيع الدخل والثروة والاستثمارات بتنافسية أعلى لتحقيق مجالات أفضل للتصدير.
وكل هذه الموضوعات ليست من اختصاصات عمل صندوق النقد الدولي، وسيُرحب إذا قامت الدولة بتنفيذها، وأُنبّه إلى أن علاقة الصندوق بمصر ستستمر بعد نوفمبر 2026 إلى أن يسترد أمواله، ومن الطبيعي في إطار أي برنامج تمويلي أن تكون هناك فترة ما بعد البرنامج لرؤية إذا كانت الوتيرة تسير بشكل سليم، وبعد ذلك تكون المراجعة في إطار المادة الرابعة التي يتم سريانها على جميع الدول، وهذه المادة تعتبر من ضمن اتفاقية الصندوق، ومن خلالها يُجري مراجعته لكل المؤشرات الاقتصادية سواء في بلد فقير، مثل تشاد، أو في دولة بدرجة غناء لوكسمبورج.
رضوى إبراهيم: إذا وددنا أن نصيغها في إجراء أو قرار يعالج هذا الجزء، ماذا سيكون هذا الإجراء؟ وهل إذا تم ذلك في وقت سابق كان من الممكن أن يعطل تنفيذ برنامج الإصلاحات مع الصندوق؟
د. محمود محيي الدين: ليس من الضروري أن يعطلها ولكن باعتبارنا لا نستطيع إعادة الزمن إلى ما كان عليه فأمامنا فرصة أخرى اليوم.
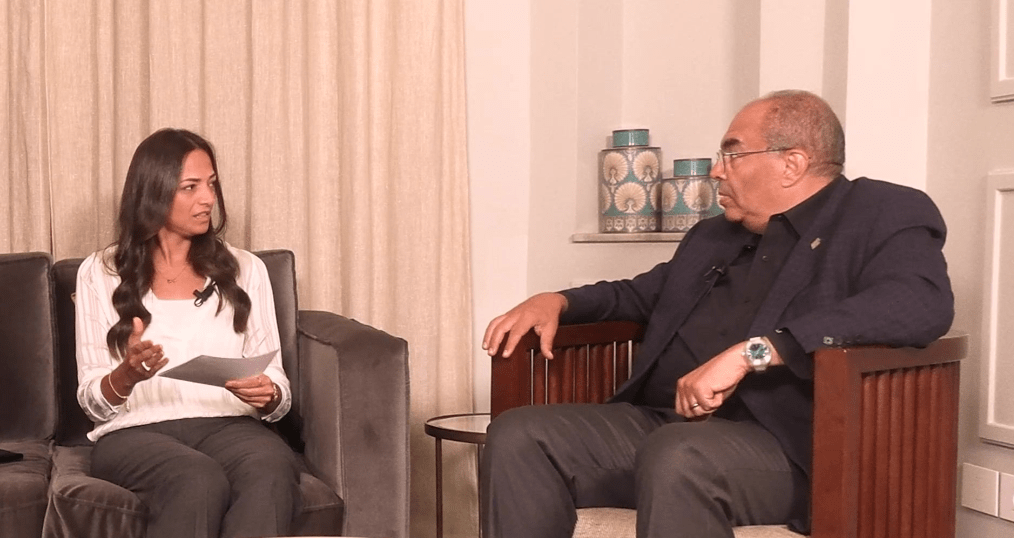
رضوى إبراهيم: وإذا وددنا أن نصيغها في إجراء أو قرار ماذا سيكون؟ وما هو الأسرع الذي سيجعل أهل بيتنا يرون أننا ننفذ أمرًا آخر بخلاف الأمر الذي شغل بالهم ومارس ضغوطًا عليهم؟
المعركة الدولية في التنافسية أصبحت على مجالات العصر
د. محمود محيي الدين: مصر تعرف كيف تدير أمورها الداخلية، ولكن لتنظر إلى المعركة الدولية ما بين الصين والهند والولايات المتحدة وأوروبا، حيث إن المعركة على التنافسية وعلى مَنْ هو الأقوى والأكثر قدرة على النمو بشكل مستمر في مجالات العصر من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والاستدامة، ولكن سأختصر هذه المجالات في عنصرين وهما: التحول الأخضر والتحول الرقمي، وما بين هذين التحولين يُشبه الذي كان يستطيع منذ 200 سنة أن يمتلك الصناعات الثقيلة والماكينات أو الآلات التي تعمل بالبخار، فهو صاحب الثورة الصناعية الأولى.
فبالتالي الذي يحرز تقدمًا ملموسًا في مجالات العصر يكون الأغنى والأكثر سيطرة وقدرة، وأرى أن ممكنات الحركة اليوم تسيطر على مجالات الاستدامة والتحول الأخضر والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
السؤال الأهم، أين تقع مكانة مصر في هذه المجالات؟ في الحقيقة ما زالت تتحدث عن أمور شديدة التقليدية، أما الأمر الذي يجعلني أكثر اطمئنانًا هو مكافحة الفقر من خلال العمل والتشغيل مع وجود برامج للضمان الاجتماعي والمساندة والدعم.
ولكن إتاحة هذه النوعية من البرامج ستكون لمجموعة استثنائية من البشر، وهذه المجموعة موجودة في أي دولة ولم تستطيع الالتحاق بسوق العمل لأسباب مختلفة أو لعدم تمتعها بأجور ملائمة، ولذلك فمن حقهم على الدولة أن تساندهم.
ولكن الأغلبية الغالبة من المجتمع لا يجب أن تعتمد على ضمان أو دعم أو مساندات، نظرًا لأنها يتحقق لها أجور منضبطة تضمن من خلالها عيش حياة منضبطة، وهناك أمور أخرى تدعم الدولة بها عموم الناس أغناهم وأفقرهم، لأن ذلك يدعم المصلحة العامة من خلال توفير الرعاية الصحية المتميزة للجميع.
ومن الجائز في حالة رغبة المواطن في الحصول على خدمة صحية ترفيهية في المستشفيات من خلال دخوله في غرفة فردية بدلًا من دخوله عنبرًا يضم نحو 4 أو 10 مواطنين، ولكن يتعين أن يجد في العنبر خدمة صحية متميزة ولائقة.
ضرورة وجود تعليم تنافسي يناسب فرص وتحديات القرن
وعلى صعيد التعليم، من الواجب أن يجد المواطن تعليمًا راقيًا تنافسيًّا عاليًا يناسب فرص وتحديات القرن الذي نعيشه، أما في حالة رغبة المواطن في إتقان إبنه 3 لغات بدلًا من لغتين ولتكن الصينية والفرنسية، بالإضافة إلى اللغة الأم، حينها يتوجه إلى مدرسة خاصة، كما هو الوضع نفسه في حالة رغبته في إلحاقه بمؤسسة تأهله رياضيًّا بشكل أكبر أو إتقان الموسيقى بشكل أفضل، ولكن في وضعية إلتحاقه بمدرسة عمومية يتعين أن يجد تعليمًا جيدًا، مع توفر مجالات الترفيه الطيبة المتميزة أيضًا.
فكل هذه الأمور في إطار التنمية، بجانب إطار آخر يعتمد على الضرورات الأساسية الخاصة بالاقتصاد الكلي والتي تعتبر الحد الأدنى ليتوافر لدينا اقتصاد كلي بجانب دور وزير المالية في السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة وتقليل الدين العام وتحقيق فائض أولي، وأُنوّه هنا إلى أنني قلت من قبل ما هو الفائض الأولي نظرًا لأن عموم الناس لا تعرفه وهو مؤشر داخلي عند المسؤولين في وزارة المالية.
صعود مؤشر الفائض الأولى إلى السطح بسبب التعامل مع الصندوق
ولكن سأطرح هنا سؤالًا حول لماذا صعد هذا المؤشر إلى السطح؟ بسبب التعامل مع صندوق النقد الدولي الذي يهتم بالفائض الأولي ويعتبره العتبة التي تخطيها الدول للقدرة على تقليل الدين العام.
وبذلك الصندوق يجعل الدول تهتم بنفس اهتماماته من المؤشرات والمصطلحات والألفاظ، في حين أن كأي واحد من عموم الناس يرغب في أمر آخر نهائيًّا، بمعنى إذا كان هناك فقر مدقع فمن المفترض تبني مسار قوي يدعم القضاء على البطالة وتعزيز التوظيف، بجانب تحسين الأجور بشكل يتلاءم مع متطلبات الحياة.
وأرى أن هذه الأمور تتحقق ببرامج للنمو والتنمية والتشغيل من خلال الاستثمار الخاص.
أحمد رضوان: قبل الانتقال إلى فكرة هذا البرنامج الذي من الممكن أن نتحدث عنه بتوسع أكبر أو كما يجب أن يكون، أود التحدث هنا عن دور الدولة في الاقتصاد؟ سأسأل أسئلة سريعة في هذا الموضوع.. هل دور الدولة في الاقتصاد المصري واضح؟
د. محمود محيي الدين: لا.
أحمد رضوان: ما هو الشكل الاقتصادي الذي يميل له؟
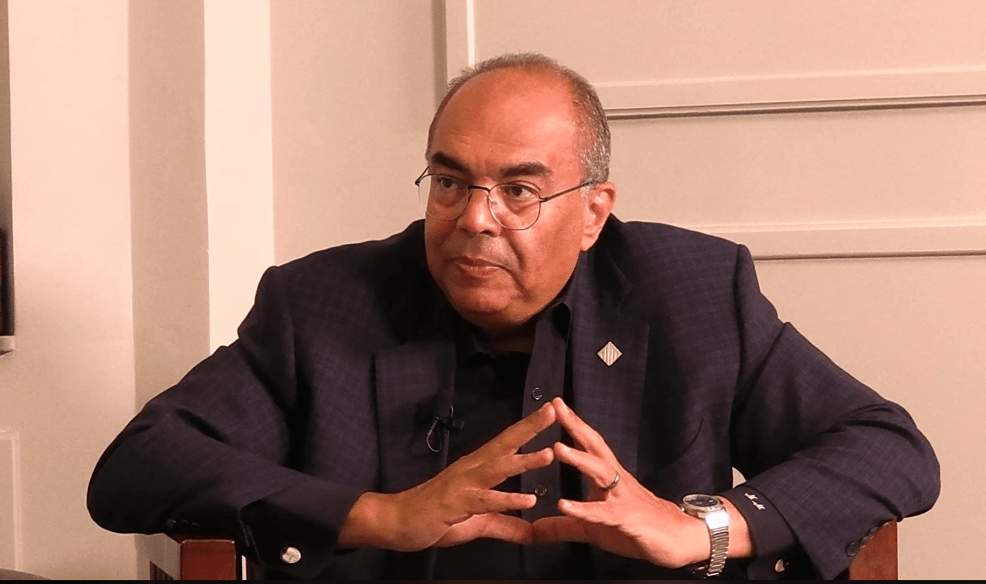
دور الدولة في الاقتصاد المصري واضح وغير واضح
د. محمود محيي الدين: دور الدولة في الاقتصاد المصري يعتبر واضحًا وغير واضح في الوقت نفسه، بمعنى إذا قرأت الورق ستجد أنه من الواضح أن الدولة تتخارج وسوف تكون رقيبة ومشرفة وتحب القطاع الخاص أكتر من محبتها للماء البارد في الصيف الحار.
أحمد رضوان: والواقع؟
د. محمود محيي الدين: الواقع غير ذلك، وهو ما يظهر من خلال الممارسة.
أحمد رضوان: هل الواقع غير ذلك من خلال المؤسسات الحكومية والقطاع العام؟
ضرورة وجود برامج تنفيذية للوثائق المعلنة من الدولة
د. محمود محيي الدين: المسألة هنا تحتاج إلى وجود برامج تنفيذية للوثائق المعلنة، وسأردد نفس كلامي: ليس لدي مشكلة على الإطلاق على مستوى وجود خطط طويلة الأجل أو قصيرة الأجل.
الأمر الآخر، هو أن لقبي الرسمي في الأمم المتحدة تمويل برنامج 2030 على مستوى العالم، ولذلك ليس لدي أي تحفظ على أن تكون أي دولة وباستثناءات محدودة جدًّا إلا ولديها رؤية 2030 وهناك عدد من الدول تأخذها على محمل الجدية من خلال برامج تنفيذية عملية.
وبالمرور عبر البحر الأحمر للوصول إلى أشقائنا في السعودية، نجد هيمنة رؤية 2030 على أولويات العمل الحكومي والقطاع الخاص والقطاع المشترك، فضلًا عن أن المستثمر الأجنبي يتعين أن يقرأها نظرًا لأنه يريد معرفة الشريك الأمثل وتحديد القطاعات المستهدفة للاستثمار.
ولذلك فهي ليست مجرد رؤية طموحات فقط، ولكن هل تحولت إلى برامج تنفيذية تشغيلية؟
رؤية مصر 2030 يتم الاسترشاد بها حكوميًّا ولم تترجم في القطاع الخاص
أما رؤية مصر 2030 فيتم الاسترشاد بها حكوميًّا، ولكن هل تمت ترجمتها في القطاع الخاص؟ في حين أن القطاع الخاص يرغب في تحويلها إلى برنامج تنفيذي عملي، بحيث لا يزاحم في القطاع الاقتصادي الذي يعمل به من خلال إذا كان لديه إمكانية للتوسع في مشروع ما يكون عبر التيسير، أو إذا رغب مستثمر جديد في دخول السوق، حينها يتعين أن يتمتع كل المستثمرين وليس الخاص فقط بالرخصة الذهبية، لتصبح بالعكس مسألة تأسيس شركة جديدة في مصر من أسهل الأمور.
ولكن كيف سيكون هذا المشروع تنافسيًّا على حياة عمر المشروع؟ سأضرب هنا مثالًا على موضوع الرخصة الذهبية بأنه مثل شخص رُزق بطفل فأراد المسؤولون المختصون بالتسجيل في السجل المدني أن يجاملوه، ليتم استخراج شهادة الميلاد سريعًا مع وضعها على ورقة بردية مذهبة بجانب وضعها في إطار للصور وكأنهم يقولون: «مبروك عليك الطفل الجديد بالاسم الجديد».
أحمد رضوان: ولكن سيواجه نفس ما يواجهه أي طفل عادي.
أعتز بفترة عملي في وزارة الاستثمار
د. محمود محيي الدين: أرى أن هذا الطفل ما زال يحتاج إلى طبيب يعالجه ومدرسة يتعلم فيها، أي نحن هنا أمام حياة عمر المشروع وليس التأسيس، وفي الواقع ليس لدي مشكلة في التأسيس فمن المفاخر التي أعتز بها فترة عملي أيام وزارة الاستثمار مع مجموعة العمل الجديرة بالاحترام، وقتها الدكتور زياد بهاء الدين ومجموعة العمل في هيئة الاستثمار أشرفوا على نظام الشباك الواحد وكان محل تنوية وإشادة من مؤسسات مالية دولية في 2005 و2006.
نظام الشباك الواحد كان محل إشادة من مؤسسات مالية دولية
ولكن ما أود قوله هو أن الرخصة الذهبية لا تعتبر عائقًا، بل بالعكس أرى ضرورة في منحها ولكن بعد التأسيس في حياة عمر المشروع مثل حياة هذا الطفل، وبالتالي أتحدث هنا عن تنافسية المشروعات.
وفي الحقيقة أتفاجأ بأن الناس دائمًا تضعني في قالب داعم للطروحات، ولكن في الواقع هذه الطروحات لا تعنيني نهائيًّا، وأرى أن هناك أمرًا آخر شديد الأهمية وهو وجود سوق تنافسية ديناميكية.
وقد قُلت لحضراتكم هذا الكلام من قبل وأن العبرة في التنافسية بين الشركات بغض الطرف عن ملكيتها سواء عامة أو خاصة.
أحمد رضوان: المنافسة العادلة.
المطلوب أرض ملعب تنافسية عادلة تخضع للمعايير الدولية
د. محمود محيي الدين: المسألة التي تحدثت عنها وكتبت فيها الكثير هي تسوية أرض الملعب، وأُشير هنا إلى أن الصندوق وضعها بقوله Leveling the playing field وهذا بلغة الأجانب، ولكن ماذا تعني Leveling the playing field معناها تسوية أرض الملعب، وسأذكر هنا مثالًا ليس معنى أنك زملكاوي فيكون الملعب ضدك والفرق الأخرى تكسب.
تسوية أرض الملعب أهم للقطاع الخاص من تخارجات الحكومة
فمن المفترض أن تتم تسوية أرض الملعب ويشير المعني البسيط لهذا المصطلح إلى أن كل فريق يضم 11 لاعبًا.
رضوى إبراهيم: أعتقد أن القطاع الخاص تضرر من اختصار إعادة صياغة دور الدولة في الاقتصاد وربطها بالتخارجات فقط، لأنها ستظل طوال الوقت محل تقييمات وقد يكون التوقيت ما زال غير ملائم بسبب وجود مفاوضات مباشرة مع بعض الجهات، فإذا وددنا إفساح المجال للقطاع الخاص بجدية بعيدًا عن الرهان على انتظار الظروف الملائمة للتخارجات التي تعيد صياغة دور الدولة، ماذا نفعل؟
وجود سوق تنافسية ديناميكية أمر شديد الأهمية
د. محمود محيي الدين: سؤالكِ يُؤكد كلامي، فالعبرة بالتنافس وليس بالتخارج.
رضوى إبراهيم: كيف يتم ترجمته في إجراءات؟
د. محمود محيي الدين: منذ سنة 1961 قبل أن تولدوا جميعًا بسنوات بعيدة، تدخلت الدولة في مشروعات، بعضها كان قد جاء بالتأميم، وإلى هذه اللحظة ورغم كل البرامج التي تم تفعيلها من تخارجات بدأت بشائرها باهتمام القطاع الخاص من الانفتاح الاقتصادي في 1974 ثم برنامج للتخارج في إطار الخصخصة مع حكومة الدكتور عاطف صدقي في بداية التسعينيات، بجانب محاولات مختلفة على مدار هذه السنوات بما يتجاوز 65 سنة، إلا أن نفس المشروعات ما زالت موجودة.
الحديث المُطوّل عن التخارجات يبقينا دون أثر يذكر على النشاط الاقتصادي
ولذلك فالحديث المُطوّل عن التخارجات يبقينا عشرات السنوات القادمة دون وجود أثر يذكر على النشاط الاقتصادي، وهو ما يبرز أهمية وضع قواعد تسوية أرض الملعب ليدفع الكُل ضرائب وجمارك مع عدم وجود مزايا تفضيلية للبعض عن الآخرين في الحصول على رأس المال أو الأرض أو الترخيص.
ضرورة قصوى لتفعيل قواعد تسوية أرض الملعب
كما يقوم الكُل بتشغيل العمالة وفقًا لقواعد تسوية أرض الملعب، لنجد بعدها أن مسألة الدخول والاندماجات والتخارج أمر طبيعي، ومن الطبيعي أيضًا الترحيب في حالة تحقيق شركة ربحًا حتى إذا كانت تابعة لملكية الدولة أو دخول شركة أجنبية من فيتنام أو كوريا السوق المصرية على سبيل المثال، فإذا صمدت في المنافسة سيعود ذلك بالنفع على الدولة أما إذا أخفقت ستتعرض للإفلاس وقد تكون محل للاستحواذات، فهذا هو نموذج العمل المطلوب.
ولكن الإطالة في الحديث عن برنامج الطروحات وتسليط الضوء على المخرجات بصورة متكررة من وضع قائمة من 20 شركة وإتمام طرح 3 منها واستقدام مؤسسة التمويل الدولية للتقييم والإشارة فكل هذه الخطوات تعتبر جيدة، إلا أن ما يهمني بصراحة شديدة هو التنافس على أرض الملعب لأنه الحلقة الأهم، خاصةً وأن التخارج يعتبر مكونًا بسيطًا جدًّا.
في كرة القدم، هناك أندية تابعة للكثير من المؤسسات في الدولة، وجميعها عندما تنزل الملعب، تعلب بفريق يضم 11 لاعبًا مثل باقي الأندية، فمَنْ يفوز مِن هذه الفرق يكون وفقًا لكفاءته ومَنْ يفشل نتمنى أن يحالفه الحظ مع وجود فرص أخرى.
ياسمين منير: بالحديث عن إرث الدولة الخاص بالأصول الكثيرة، وبالرغم من وجود برنامج للتخارج، إلا أنه قد تكون هناك صعوبة في هذه التخارجات فيما يتعلق بالتقييم.
الصعوبة لا تكمن في الشق الخاص بتقييم أصول الدولة فقط
هناك مصالح أخرى متعلقة ببقاء الوضع كما هو عليه
د. محمود محيي الدين: الصعوبة لا تكمن في الشق الخاص بالتقييم فقط، إنما هناك مصالح أخرى متعلقة ببقاء الوضع على ما هو عليه مما قد يُقيد هذه العملية، ولذلك مسألة الإرادة السياسية مهمة للغاية ولا أتحدث هنا على حالة مصر فقط.
أكملي سؤالكِ.
ياسمين منير: من وجهة نظرك ما هو أسلوب التعامل الأمثل مع هذه الأصول إذا تم التعامل على أن التخارج ليس أساس مثلًا خصخصة الإدارة بشكل ما لرفع الكفاءة أو دمج أصول أو الطرح في البورصة باعتباره هدفًا قوميًّا بشكل مختلف؟
محفظة قطاع الأعمال تضم شركات شديدة التميز وأبرزها تداول الحاويات
د. محمود محيي الدين: سأذكر هنا تجربة خضتها في مصر في ظل ظروف لم تكن الأيسر بالضرورة في التعامل مع محفظة قطاع الأعمال العام، ففي هذا الوقت كان لدينا شركات شديدة التميز، ومنها شركات تداول الحاويات.
متابعة الناس للبورصة ووجود مؤشر يومي للأداء من أبرز أهداف الطرح
فمسألة الطرح في البورصة وقتها كانت تدور الحصة حول 20 إلى 30% من هذه الشركات حتى يتشارك بقية عموم الناس في قاعدة الملكية، وكان الأهم بالنسبة ليّ كوزير معني بالاستثمار وقطاع الأعمال العام، أن تتابع الناس البورصة، ويكون لدينا مؤشر يومي عن الأداء، بحيث أن أي إجراء تفعله الشركة وليكن تعيين مدير جديد ناجح أو إبرام اتفاقية مع شركة أخرى أو اتفاق على توريد مجموعة من المراكب الجديدة، ينعكس ذلك الإجراء على أداء السهم بالصعود.أما في حالة حدوث ربكة في مجال من المجالات على رصيف من الأرصفة سيهبط حينها السهم، وبذلك سيتواجد لدينا مؤشرات للأداء.
وبالحديث عن مؤشرات الأداء، ليس من الضروري مراجعة الحسابات والقوائم المالية عن آخر 18 شهرًا في عام 2010، علمًا بأن هذه الأوراق كانت خاضعة للأزمة المالية في 2008.
فالمسألة هنا أن هذه الكيانات المملوكة للدولة ومنها شركات تداول الحاويات، دمياط والإسكندرية وبورسعيد، كانت شركات رابحة ومتميزة للغاية وقد تكون أكثر تميزًا.
وفي وقت تولي حقيبة وزارة الاستثمار أيضًا، كانت شركة السكر والصناعات التكاملية شهدت ضخًّا للاستثمارات، وهو ما حولها من تحقيقها أرباح محدودة وخسائر في بعض الأوقات إلى نقلة نوعية في الأداء، ودخلت في مشروعات ومشاركات جديدة.
وفي المقابل، كانت هناك شركات لا يمكن أن تحقق نقلة نوعية ولذلك تم اللجوء إلى حلول الدمج والاستحواذ أو التخارج أو إداراتها من خلال القطاع الخاص، وأتحدث هنا عن ربح اقتصادي ولا أقصد الفارق بين الإيرادات والنفقات بمعنى العائد على رأس المال والأصول.
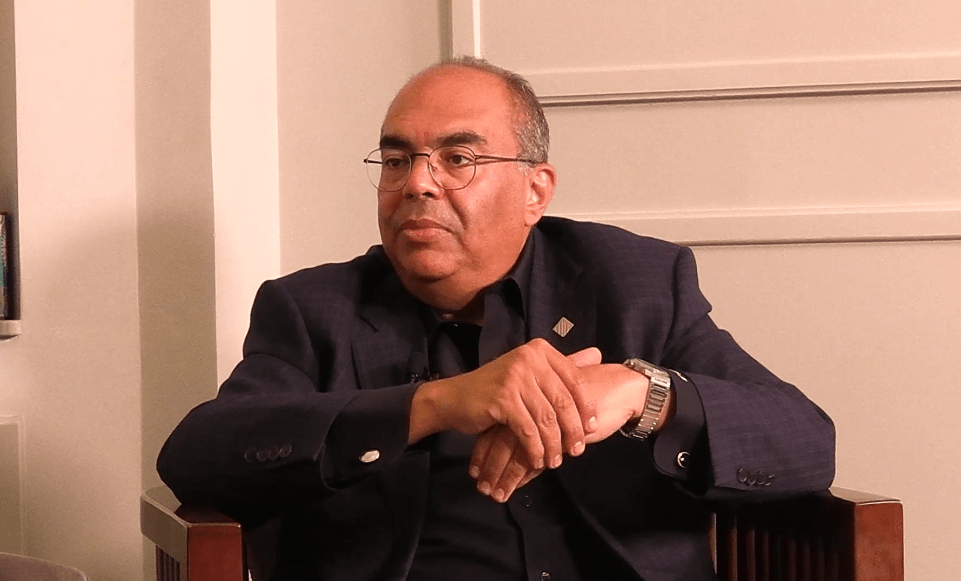
بعض البنوك العامة حققت نقلات نوعية في ظل أرض ملعب متساوية
ولذلك هناك حاجة لتطبيق نموذج مشابه لإشارات المرور، بمعنى إذا حققت شركة تابعة لملكية الدولة كفاءة في الأداء فليس لدي أي مشكلة على الإطلاق في هذا الإطار، وهناك بعض البنوك العامة حققت نقلات نوعية في مؤشرات الربح تجاوزت فيها بعض البنوك الخاصة والمشتركة وفقًا لقواعد الملعب.
رضوى إبراهيم: رغم حالة التباطؤ التي شهدتها حركة الطروحات الحكومية في الآونة الأخيرة، إلا أن ثمة نماذج محدودة جرى تنفيذها بالفعل. لكن ما الذي حال دون تحقيق المستهدف منها؟ هل يرجع ذلك إلى أسلوب الطرح الذي اعتمد في جزء منه على اتفاقات مسبقة مع مشترين محددين قبل نزول الكيان إلى السوق، أم أن السبب يرتبط بطبيعة الأوراق المالية المطروحة نفسها؟
طول فترة التقييم وتغير اتجاهات السوق أحد أسباب تعثر الطروحات
د. محمود محيي الدين: الأمر يحتاج إلى النظر إليه حالة بحالة، قد يكون السبب في بعض الحالات مزيجًا من عدة اعتبارات، منها على سبيل المثال طول فترة التقييم التي قد تستغرق وقتًا أطول مما ينبغي، بحيث إنه مع الانتهاء من التقييم قد يتغير اتجاه السوق بشكل لا يسمح بتنفيذ الطرح في التوقيت المناسب.
نتائج الفحص النافي للجهالة قد تكشف اختلافات بين رؤية المستثمر وجهة الطرح
وفي أحيان أخرى، قد يكمن السبب في نتائج الفحص النافي للجهالة، حيث قد ترى الجهة الطارحة أن الأمور سليمة، بينما يكتشف المستثمر وجود ملاحظات أو اعتبارات أخرى تختلف رؤيته.
جوهر برنامج الطروحات محل تقدير لكن الأهم إخضاع الشركات للمنافسة الكاملة
لكن في النهاية، يظل جوهر البرنامج بكل مكوناته محل تقدير، غير أن المقام الأهم بالفعل هو ضرورة إخضاع هذه الشركات لقواعد المنافسة الكاملة، وهو ما يستدعي بالضرورة طرحها في البورصة لزيادة الشفافية وتعزيز الحوكمة.
ياسمين منير: هل ترى أن ذلك يمكن أن يتحقق من خلال زيادات في رؤوس الأموال؟
د. محمود محيي الدين: هذا وارد بالفعل، سواء من خلال زيادات رأسمالية أو غيرها من الأدوات، شريطة أن تكون لدى الشركات قوائم مالية معتمدة ومعترف بها.
ياسمين منير: ما أقصده أن تتم هذه الزيادات بما يمنح الشركات دفعة إضافية، بحيث تتحول إلى كيانات أكثر تنافسية.
ملكية الدولة ليست عائقًا إذا توافرت كفاءة الإدارة
د. محمود محيي الدين: اسمحي لي أن أؤكد نقطة مهمة، أنا لا أرى أن ملكية الدولة للشركة في حد ذاتها هي العائق إذا كانت الشركة تدير أمورها بشكل جيد.
الفوسفات المغربية وأرامكو نموذجان ناجحان لشركات حكومية تدار بكفاءة
لدينا أمثلة بارزة على شركات مملوكة للدولة وتدار بكفاءة عالية، مثل شركة الفوسفات المغربية التي تعد نموذجًا يحتذى به، وأيضًا شركة أرامكو السعودية التي قبل الطرح كانت مملوكة بالكامل للدولة لكنها كانت تعمل بانضباط ودقة أشبه بالساعة، وملتزمة باعتبارات ومعايير دولية.
إذن، ما أطالب به هو ببساطة تهيئة «أرض الملعب» على أساس تنافسي عادل يخضع للمعايير والممارسات الدولية، وبعدها لا يهم إن كان المالك عامًّا أو خاصًّا أو مختلطًا، وهذه هي العبرة في النهاية.
التركيز فقط على القوائم المالية والطرح يعيدنا لحلقة مفرغة
ما أحاول أن أوضحه لكم ولقرائكم ومشاهديكم هو أننا عندما نحصر أنفسنا في دائرة ضيقة تقتصر على المطالبة بتقديم القوائم المالية، ثم عرضها على مؤسسة بعينها، يليها تنفيذ طرح يتعثر أو يفشل فنعود مرة أخرى لنقطة البداية، فإننا نكون بصدد حلقة مفرغة لا مخرج منها.
أحمد رضوان: وقد يكون النجاح في هذه الحالة محدودًا أو ليس بالإنجاز الكبير المنتظر
د. محمود محيي الدين: بالضبط. دعني أضع الأمر بصورة أوضح وأنتم متابعين للأمر جيدًا وأنا أتابع ما تكتبونه، افترضوا جدلًا أنه جرى طرح كل الشركات المستهدفة وبمضاعفات أعلى مما هو مطروح الآن. ماذا ستكون النتيجة؟
نجاح الطروحات وحده لا يكفي لرفع النمو من 2.5% إلى 7% أو جذب استثمارات نوعية
نعم، قد نحقق تقدمًا على مستوى هذه الشركات نفسها، وقد تنعكس إيجابيًّا على صورة الدولة أمام المؤسسات الدولية، لكن هل هذا كافٍ ليضع الاقتصاد على مسار الانطلاق الحقيقي، ويرفع معدلات النمو من 2.5% إلى 7% مثلًا، ويجذب استثمارات أجنبية نوعية ويعزز الكفاءة الكلية.
رضوى إبراهيم: مثلما كان الحديث لسنوات عن المطارات، والحكومة مؤخرًا أعلنت نيتها طرح إدارتها
د. محمود محيي الدين: هذا المفروض أن يكون مطروحًا منذ البداية.
رضوى إبراهيم: نعم جاء متأخرًا، وإذا انتقلنا لقطاع الكهرباء، هل آن الأوان لاتخاذ خطوة جريئة في هذا القطاع أيضًا، خاصة أن الأمر لم يعد فارقًا إذا كان تحت إدارة الحكومة أو القطاع الخاص؟
العبرة ليست بالطرح بل بآلية الرقابة في قطاع الكهرباء
د. محمود محيي الدين: نعم، هذا وارد، بل وأن مسألة طرح شركات توزيع الكهرباء ليست جديدة، فقد طُرحت بالفعل أيام حكومة الدكتور كمال الجنزوري الأولى، حين كان هناك اتجاه لطرح الشركات السبع الخاصة بتوزيع الكهرباء. لكن العبرة هنا ليست بمجرد الطرح ذاته، وإنما بآلية الرقابة.
الخطر الحقيقي هو تحميل المستهلك كامل التكلفة الناتجة عن سوء الإدارة
فعندما تفتح مجالًا يتعلق بمنافع عامة مثل الكهرباء، يصبح عنصر الرقابة هو الأساس. والخطر الحقيقي في هذا السياق يكمن في أن تتحول المعادلة إلى تحميل المستهلك كامل التكلفة دون النظر إلى ما إذا كانت هذه التكلفة ناتجة عن إدارة رشيدة أو عن ممارسات غير اقتصادية.
السعر العالمي للكهرباء ليس معيارًا كافيًا بل يجب ربطه بالكفاءة وخفض التكاليف
على سبيل المثال: قد يقال للمستهلك إن تكلفة الأتوبيس 10 وحدات، بينما المعايير الدولية تثبت أن التكلفة الفعلية لا تتجاوز 3 وحدات إذا تم التشغيل وفقًا لقواعد الكفاءة، حيث يعمل السائق ومعه عامل مساعد وعامل آخر للصيانة. لكن في حال وجود بيروقراطية أو تضخم في العمالة، فإن التكلفة تصبح مشوهة وغير اقتصادية.
تضخم العمالة والبيروقراطية يشوهان التكلفة ويضاعفان الأعباء على المستهلك
وإذا انتقلنا بهذا المنطق إلى قطاع الكهرباء، نجد أن تحميل القطاع بتكاليف ناتجة عن بيروقراطية أو سوء إدارة ثم نقلها إلى المستهلك في شكل أسعار مرتفعة لا يمثل عدالة اقتصادية. المطلوب هنا هو ضبط التكاليف وفقًا لقواعد المنافسة الحقيقية وتطبيق معايير الكفاءة، لا الاكتفاء بمفهوم «السعر العالمي» الذي قد يكون أحيانًا أقل لا أكثر، لأن بلوغه يأتي نتيجة إدارة رشيدة وتخفيض منظم للتكاليف.

ياسمين منير: في إطار الحديث عن دور الدولة، أود أن أتطرق إلى الصندوق السيادي. نحن في مصر أسسنا صندوقًا سياديًّا بفلسفة تختلف عن النماذج التقليدية في الخارج، حيث رُوعي أن يكون له دور فاعل في إدارة الأصول وإشراك القطاع الخاص. برأيكم، ما الدور الأمثل للصندوق السيادي خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل المراجعة الجارية لدوره وآلية تعامله مع الأصول؟
وجود أكثر من صندوق سيادي لمصر فكرة جيدة إذا أديرت وفق المعايير الدولية
د. محمود محيي الدين: فكرة وجود صناديق سيادية متعددة لمصر، وليس صندوقًا واحدًا، هي فكرة جيدة ومطبقة بالفعل في عدد من الدول، شريطة أن تدار وفق القواعد والمعايير الدولية. هنا يجب التمييز بين نوعين: الأول هو الصندوق السيادي بالمعنى المتعارف عليه عالميًا، والذي يُقوَّم بالعملات الأجنبية ( الدولار)، أو قد يستثمر في مشروعات تدر عائدًا بالنقد الأجنبي. وقد يكون هذا الاستثمار في الداخل، مثل الدخول في إدارة مطار أو مشروع سياحي أو ميناء للتجارة الدولية يحقق إيرادات بالدولار، أو في الخارج عبر استثمارات إستراتيجية متنوعة. هذا هو النموذج الذي تخضع معاييره لمبادئ «سانتياجو» التي تحدد كيفية تعريف وإدارة الصناديق السيادية.
صندوق الملكية الشعبية يختلف عن السيادي التقليدي ويشبه شركة قابضة كبرى لإدارة الأصول المحلية
أما النوع الآخر فهو ما نوقش لدينا منذ سنوات تحت مسمى «الملكية الشعبية» أو «صندوق الأجيال القادمة»، وهو بطبيعته يختلف عن الصندوق السيادي التقليدي. هذا الصندوق لا يهدف إلى الاستثمار الخارجي أو جلب النقد الأجنبي، وإنما يقوم بدور أقرب إلى شركة قابضة عملاقة تدير محفظة من الأصول المحلية القائمة بالفعل. يمكن أن يُطلق عليه «السوبر هولدينج كومباني» أو «أم الشركات القابضة».
ياسمين منير: إذن يمكن أن نطلق عليه «قابضة القوابض».
د. محمود محيي الدين: نعم، بالضبط. ومعه شركات تابعة أيضًا. لكن حينما تطورت الأمور –وكان ذلك اقتراحي، وليس مجرد نصيحة– فقد طُلب مني الرأي من الوزير المعني آنذاك ومستشاره، فأوضحت له بضرورة التمييز بين أمرين أساسيين. لدينا ما يُسمى بصندوق للأجيال القادمة يدير محافظ استثمارية، ولدينا في الوقت نفسه شركات قابضة عديدة. فإذا كان الصندوق سيأخذ نفس الأصول، فما الميزة التي ستفرقه عن هذه الشركات القابضة؟ هل سنقول إننا سنأتي بعناصر أكثر كفاءة؟ حسنًا، ضعوا هذه الكفاءات في الشركات القابضة نفسها.
لا جدوى من نقل نفس الأصول من الشركات القابضة إلى الصندوق
لا يصح أن ننقل نفس الأصول من كيان إلى آخر، فذلك أشبه بمن يخرج شيئًا من الجيب الأيمن ليضعه في الأيسر، بينما الجيب الأيسر مثقوب يتسرب منه المال، في حين يحقق الآخر أرباحًا طفيفة، لكن في نهاية المطاف السترة نفسها مثقوبة. ببساطة، نحن بحاجة إلى إعادة ضبط وترتيب الأمور.
المطلوب إعادة ضبط وترتيب الأمور بدلًا من إعادة تدوير نفس الأصول
النقطة الأخرى، والتي طرحتها في نفس الفترة –وكنت قد تحدثت عنها في حوار مع صحيفة المصري اليوم حين أُنشئ الصندوق السيادي– هي أن مصر في تقديري تحتاج إلى أكثر من صندوق سيادي، بحيث يكون هناك صندوق آخر يُدار بالتنسيق مع البنك المركزي ليكمل دوره في إدارة الاحتياطيات من النقد الأجنبي.
مصر تحتاج إلى أكثر من صندوق سيادي.. أحدها بالتنسيق مع المركزي لإدارة جزء من الاحتياطيات الأجنبية
نحن حاليًا ندير الاحتياطيات النقدية على النحو التقليدي الذي تتبعه معظم الدول النامية: حين يتوافر فائض نقوم بزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي ونضعه في أدوات مالية عالية السيولة منخفضة العائد، ثم إذا واجهنا صدمة خارجية تضرب سعر الصرف نتدخل باستخدام هذا الاحتياطي في سوق النقد الأجنبي. وقد تكرر هذا المشهد مرارًا عبر عدة صدمات متعاقبة.
أفضل فترة شهدت تراكمًا كبيرًا للاحتياطيات الأجنبية كانت في أعقاب حكومة الدكتور عاطف صدقي، إذ بلغ عدد الأشهر المغطاة بالاحتياطي من النقد الأجنبي مستويات هي الأعلى ربما في تاريخ مصر، لكنها تبخرت سريعًا عقب أزمات 1997 و1998 مع حادث الأقصر وانهيار أسواق ناشئة وتراجع أسعار النفط. بمعنى آخر، نحن نراكم لسنوات ثم نفقد هذه المكتسبات في غضون أسابيع.
الأفضل استثمار الفوائض في صندوق شبيه بتجربة سنغافورة والنرويج ودول الخليج
ثم تكرر المشهد ذاته في فترة حكومة الدكتور أحمد نظيف، حيث زاد الاحتياطي بشكل ملحوظ، لكنه تلاشى بفعل الأزمات الاقتصادية التي أعقبت ثورة يناير وما صاحبها من اضطرابات. إذن، نحن نجمع الاحتياطي في محافظ عالية السيولة قليلة العائد، لكنه يذوب مع أول أزمة. من الأفضل إذن أن نضع هذا الفائض في صندوق استثماري، على غرار ما قامت به دول مثل سنغافورة، النرويج، وعدد من الدول الخليجية، بحيث يُستخدم التراكم في أوقات الرواج ويُسحب منه عند الحاجة لدعم الاقتصاد –وليس من أجل تثبيت سعر الصرف– بل لتحقيق استقرار اقتصادي أوسع.
التجربة النرويجية نموذج في الشفافية.. بينما الصندوق المصري يفتقر لبيانات واضحة
وبالتالي، فإن دعوتي الأولى هي لمراجعة شاملة للأداء. لدينا الآن سنوات كافية لتقييم حصيلة عمل الصندوق. فإذا سألتني مثلًا عن الصندوق النرويجي الآن، يمكنني ببساطة أن أبحث عبر الهاتف فأجد جميع المؤشرات والأرقام منشورة بشفافية. لكن إذا حاولت أن أبحث عن الصندوق السيادي المصري، فقليلًا ما يذكرون، غالبًا ما تتعلق بصفقة أرض أو شركة هنا أو تفاوض مع طرف هناك.
الصندوق السيادي المصري يُدار بشكل أقرب لشركة إدارة أصول لا كصندوق سيادي بالمعايير الدولية
نحن بحاجة إلى قدر أعلى من المعرفة بشأن الأداء، وإلى مستوى أعلى من الشفافية في مؤشرات الصندوق. بالإضافة إلى ذلك، رغم تسميته بالصندوق السيادي، إلا أن الواقع يشير إلى أنه يُدار أقرب إلى كونه شركة لإدارة الأصول.
أحمد رضوان: شركة قابضة.
د. محمود محيي الدين: الكيان الثاني الذي أعنيه هو ذاك الذي يجب أن يُدار بالنقد الأجنبي، ليكون سندًا لدور البنك المركزي في إدارة احتياطيات النقد الأجنبي. وأود أن أوضح هنا نقطة مهمة، إذ قد يظن البعض أن الفكرة تعني المساس بالاحتياطي القائم أو إهداره، وهذا غير صحيح على الإطلاق. ما أطرحه هو أن يستمر البنك المركزي في إدارة احتياطياته وفق الأغراض المقررة لضمان الاستقرار النقدي، بينما يُخصص ما يزيد على تلك الاحتياجات –أي الفائض– لتوجيهه ضمن إطار هذا الصندوق.
نحن لا نعيد اختراع العجلة، بل نستفيد من تجارب قائمة أثبتت نجاحها. هناك نماذج عالمية راسخة في هذا المجال: من سنغافورة وكوريا الجنوبية إلى النرويج والصين، مرورًا بالعديد من الدول الخليجية والعربية، وصولًا إلى بعض دول أمريكا اللاتينية.
رضوى إبراهيم: ماذا عن البيئة التشريعية المنظمة للاستثمار في مصر؟ هل نحن بحاجة إلى مراجعة التشريعات القائمة أم إلى إصدار قوانين جديدة بالكامل؟
د. محمود محيي الدين: اسمحي لي أن أوضح شيئًا مهمًّا، فهذا الموضوع يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالسؤال المحوري الذي طرحتموه حول دور الدولة. فإذا تحولت الدولة من دورها الطبيعي كمنظم وحكم في السوق إلى لاعب مباشر على الأرض، فسنجد بالضرورة ارتباكًا في منظومة التشريع الاقتصادي.
الدور الأمثل للدولة هو التشريع والرقابة.. لا منافسة القطاع الخاص
الدور الأمثل للدولة هو أن تضطلع بوظائفها كمشرع عبر البرلمان، وكجهة رقابية تتابع تنفيذ التشريعات وتقيّم الأداء. أما إذا نظرت الدولة لنفسها كلاعب اقتصادي رئيسي، فسوف تميل إلى صياغة استثناءات لمصلحتها أو تخشى من تطبيق قواعد عامة قد تضر بها، وهو ما يخلّ بموضوعية الإطار التشريعي ويضعف تنافسيته. هذه هي النقطة الأولى.
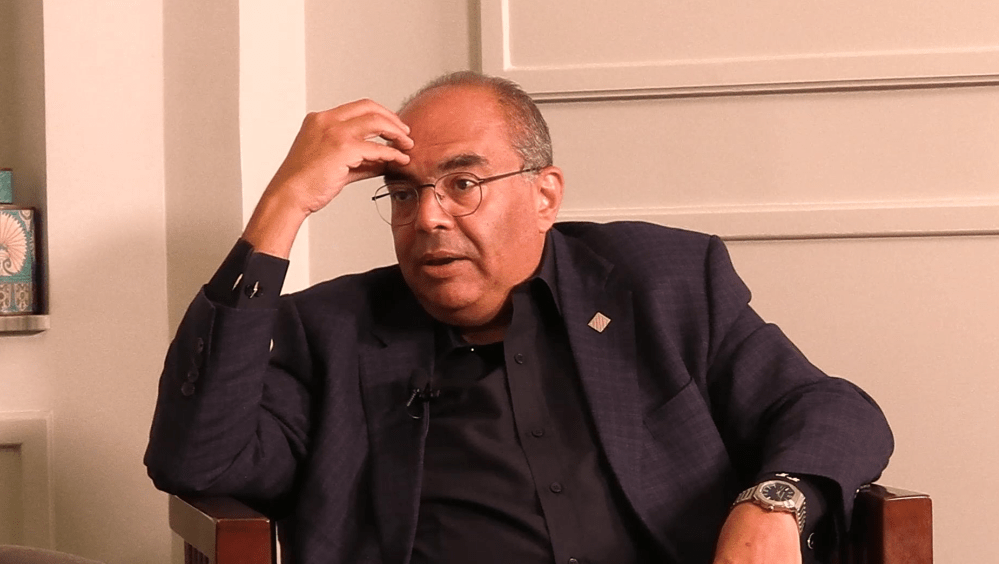
لدينا تشريعات معتبرة لكن المرحلة الحالية تتطلب أطرًا حديثة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والاستدامة
النقطة الثانية، أنه لدينا بالفعل حزمة من التشريعات الاقتصادية المعتبرة، وأنا شخصيًا سعيد جدًا بأنني كنت طرفًا –مع آخرين– في صياغة بعض هذه الأطر. أذكر منها تطوير سوق المال، والقانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي –والذي شهد تعديلات لاحقة لكنه يحتاج اليوم إلى مراجعة شاملة– بالإضافة إلى منظومة حماية المستهلك، ومنظومة حماية المنافسة، وتشريعات التمويل العقاري التي كانت مناسبة لمرحلتها وتحتاج إلى البناء عليها، فضلًا عن قانون الاستثمار. هذه الأسس قائمة، لكن المرحلة الحالية تفرض علينا أن نضيف إليها أبعادًا جديدة تتعلق بالتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة بما يشمل التحول الأخضر، وهو ما يتطلب بدوره تشريعات ولوائح تنظيمية حديثة متوافقة مع هذه التطورات.
الصين والهند تثبتان أن المنافسة شرسة والتطور التكنولوجي أسرع مما نتصور
وهنا ينبغي أن ننظر إلى التجربة الصينية التي حققت في سنوات معدودة –لا عقود– قفزات جعلتها ثاني أكبر اقتصاد عالمي، بينما تتقدم الهند بخطى سريعة لتزاحمها، في حين تظل الولايات المتحدة في الصدارة. التحدي الذي يفرضه «التنين الصيني» يوضح أن المنافسة شرسة وأن التطور التكنولوجي يسير بوتيرة أسرع مما نتصور.
دور الدولة المستقبلي يجب أن يتركز على حماية المواطنين من الصدمات وتعزيز التنافسية
أنا أستفيد من هذا الأمر بالعودة إلى سؤالك، إذا نظرنا إلى دور الدولة في المستقبل، فإنه يجب أن يتركز على حماية المواطنين من الصدمات الاقتصادية، وعلى تطوير الأسواق وتعزيز التنافسية. لكن عند دخول الدولة إلى مجالات جديدة –كقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة– ينبغي أن يكون دورها في وضع الأطر التشريعية والتنظيمية وتهيئة البيئة الاستثمارية، بينما يُترك التنفيذ والتشغيل للقطاع الخاص.
مشروع بنبان للطاقة الشمسية نموذج ناجح للشراكة بين القطاعين العام والخاص
لدينا تجربة ناجحة في مصر في مشروع «بنبان» للطاقة الشمسية، الذي شكّل نموذجًا محترمًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص. على الدولة أن تبني على هذا النجاح، لا أن تزاحم القطاع الخاص فيه.
تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة انخفضت بأكثر من 90% ما يستلزم مرونة استثمارية
لماذا؟ لأن طبيعة الحكومة –كغيرها من الحكومات– أنها جهاز بيروقراطي، معقّد في آليات اتخاذ القرار، وبطيء في التفاعل مع المستجدات. بينما التكنولوجيا في قطاع الطاقة المتجددة –على سبيل المثال– تتغير بوتيرة مذهلة، حيث انخفضت تكلفة إنتاج الكيلووات من الكهرباء بأكثر من 90%، وبعض التقديرات تقول 95 أو حتى 97%. معنى ذلك أن أي قرار استثماري تتخذه الحكومة اليوم قد يصبح متجاوزًا اقتصاديًّا بعد أشهر قليلة فقط من اعتماده.
القطاع الخاص أقدر على استيعاب المخاطر والتأقلم مع التطور التكنولوجي
أما القطاع الخاص، فله القدرة على استيعاب هذه المخاطر والتأقلم مع التطور التكنولوجي بسرعة، لأنه ببساطة يملك الحافز للبقاء في السوق وتحقيق ربحية، ولديه كذلك الدافع للحفاظ على كفاءته لأنه إن أخطأ في استثمار أو اشترى معدات غير صالحة فلن يتمسك بها لمجرد أنه أنفق عليها أو أرسل بعثة مكونة من 20 شخصًا لشرائها من ألمانيا.
رضوى إبراهيم: لكن يظل لدى القطاع الخاص إشكالية في هذه النقطة، فهو في الغالب يطلب أن تلتزم الحكومة مسبقًا باتفاقية لشراء المنتج.
أحمد رضوان: كما حدث في مشروع بنبان.
رضوى إبراهيم: وكذلك في مشروعات تحلية المياه، حيث شكّل هذا الشرط مأزقًا كبيرًا.
مأزق ضمان المشتري للمنتج لا يقتصر على مصر بل يمتد لأسواق عالمية
د. محمود محيي الدين: صحيح، فهذا بالفعل مأزق قائم، لكنه ليس قاصرًا على مصر. فالقطاع الخاص، حتى لو اتجه إلى سنغافورة أو كوريا أو حتى إلى غانا، فإنه يطلب ما يُعرف باتفاقيات شراء المنتج أو الـ (Offtake Agreements) السبب ببساطة أن المستثمر حين يضخ استثمارات ضخمة في مشروعات إستراتيجية كالكهرباء أو المياه، يحتاج إلى ضمان وجود مشتري ثابت ومستقر للمنتج.
المستثمر في مشروعات استراتيجية كالكهرباء والمياه يحتاج إلى اتفاقيات شراء المنتج
أحمد رضوان: في النهاية، الحكومة هي المشتري وهي الموزع.
د. محمود محيي الدين: بالضبط.
رضوى إبراهيم: ولكن، ألا توجد حلول بديلة لهذه الإشكالية؟
د. محمود محيي الدين: لا، في هذه الحالة لا توجد حلول أخرى. في قطاعات بعينها قد يكون هناك بدائل أو حلول مبتكرة، مثل صناعة الأحذية أو السلع الاستهلاكية، حيث تقوم المنافسة على تمييز المنتج أو العلامة التجارية، ويتحمل المستثمر مخاطر الدخول إلى السوق ومزاحمة الآخرين. لكن عندما نتحدث عن سلع أو خدمات أساسية –كالكهرباء أو المياه– فالوضع مختلف تمامًا. هنا نحن أمام منتج يتعلق بطريقة نقله وتسعيره ورقابته، وكل ذلك يخضع بالضرورة لهيمنة الحكومة.
لا بدائل في قطاعات أساسية كالكهرباء والمياه حيث تظل الحكومة الطرف المهيمن
وما حدث في قطاع الكهرباء على سبيل المثال، بالتعاون مع وزارة الكهرباء في حينه، يُدرس اليوم كنموذج إيجابي لما تضمنه من دروس مستفادة، وحتى على مستوى التطوير التشريعي والرقابي. فعندما يُقال للدولة «طوّري منظومتك التشريعية والرقابية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص»، قد يأتي الرد: «عندما يأتي القطاع الخاص».
بمجرد أن بدأ القطاع الخاص يشارك في هذه التجربة، ظهرت مطالب جديدة: المستثمر يريد مرونة أكبر للتوسع، وفي المقابل يظهر صوت آخر من مؤسسات حماية المستهلك ليؤكد أن الأمر لا يمكن أن يُترك للقطاع الخاص وحده.
الدور الحقيقي للحكومة هو أن تكون حكمًا محايدًا يضمن التوازن بين حقوق المستثمرين وحقوق المستهلكين
وهنا يتحدد الدور الحقيقي للحكومة: أن تكون حكمًا محايدًا لا ينحاز تلقائيًا إلى القطاع الخاص، بل تضمن انضباط السوق بما يكفل التوازن بين جميع الأطراف. فالقطاع الخاص –سواء كان محليًّا أو عربيًّا أو أجنبيًّا– له حقوق، لكن المستهلك أيضًا له حقوق أصيلة يجب حمايتها.
أحمد رضوان: حسنًا، نحن نود أن نتناول مسألة تنافسية الاقتصاد المصري في الإطار الإقليمي المحيط بنا. لقد تحدثنا قليلًا عن دور الدولة في الاقتصاد والمساحة المتاحة أمام القطاع الخاص، ولكن من منظورنا كصحفيين نشعر أن المنافسة مع الدول المجاورة أصبحت أكثر صعوبة.
د. محمود محيي الدين: حين نتحدث عن «المحيط»، فنحن لا نقصد فقط الأشقاء في دول الخليج.
أحمد رضوان: بل نحن نعني السعودية والمغرب وتركيا، وأيضًا أسواق إفريقيا.
على الدولة أن تهيئ البيئة الاستثمارية وتترك التنفيذ للقطاع الخاص
د. محمود محيي الدين: يمكن النظر إلى مصر وفق دوائرها الجغرافية؛ فأي منطقة تستطيع أن تصل إليها من مصر في حدود خمس ساعات طيران تُعد نطاقها الاقتصادي الإقليمي الأقرب، وهو المجال الأقرب للمنافسة.
أحمد رضوان: لا أريد أن أحصر النقاش في ما يتوجب فعله تحديدًا، وإنما أسأل عن المزايا التي يمكن أن نستلهمها من تجارب هذه الدول. ماذا فعلت هذه الاقتصادات؟ وهل يمكن لمصر أن تقتبس هذه النماذج بسهولة؟ هل يمكن مثلًا تكرار هذه التجارب في الصناعات الثقيلة أو صناعة السيارات؟ وكيف يمكننا التعامل مع ذلك؟
د. محمود محيي الدين: لا يمكن للحكومة أن تنظر إلى الأمور من زاويتها وحدها. فلو أدركت بالفعل حجم الأنشطة والفرص الكامنة في السوق وفي القطاع الخاص، لكانت تركت مكاتبها ونزلت لممارسة النشاط الاقتصادي مباشرة. والحقيقة أنها لا تستطيع أن تجمع بين الأمرين؛ فلا يصح أن تكون في الوقت ذاته حكومة ووزارة وهيمنة وسيطرة ولاعبة في السوق، فهذا أمر غير مقبول ولا معمول به في أي مكان.
قد توجد بعض الاستثناءات في دول شقيقة بعينها، لكن القاعدة العامة أن دور الحكومة يقتصر على رسم السياسات، إدارة المؤسسات العامة، والقيام بالوظائف الرقابية، بينما يُترك للقطاع الخاص القيام بدور الفاعل الأساسي في السوق. نعم، هناك بعض المجالات المحددة التي قد تبقى في إطار «احتكارات الدولة»، لكن ذلك يرتبط فقط بالأبعاد الأمنية والإستراتيجية الدقيقة، وليس بالتوسع في توصيف كل نشاط على أنه «إستراتيجي» لمجرد استخدامه في سياق معين.
لا يكفي الاعتماد على التاريخ وعبقرية المكان بل المطلوب استثمار الموقع بقدرات تسويقية وكفاءة تنافسية
أما ما يتعلق بالمجال الاقتصادي التنافسي، فالمطلوب هو إتاحة مساحة حقيقية للدولة كي تُفعِّل ديناميكيات قادرة على المنافسة إقليميًّا ودوليًّا. الأمثلة في هذا السياق كثيرة، لكن ما أود التأكيد عليه أنه لا يكفي أن تستند مصر إلى تاريخها العريق أو إلى موقعها الجغرافي الفريد الذي وصفه جمال حمدان بـ»عبقرية المكان». السؤال الأهم: هل استثمرت مصر هذه الميزة فعلًا؟
قد تمتلك أفضل موقع تجاري في المنطقة، لكن ضعف القدرات التسويقية قد يحوله إلى أسوأ موقع من حيث العائد الاقتصادي. وعلى النقيض، قد تجد دولة أخرى في منطقة نائية، لكنها تمتلك قدرات تمكنها من النجاح وتستفيد من موقعها إلى أقصى درجة.
أحمد رضوان: نعم فهناك دول أخرى في مناطق معرضة للزلازل مثلًا، لكنها بفضل قدراتها وإدارتها الناجحة تحقق نتائج مبهرة.
د. محمود محيي الدين: القضية هنا ليست في المكان وحده، ولا في التاريخ الذي يجب أن يُبنى عليه لا أن يُختصم منه، لكن المؤسف أنّنا في كثير من الأحيان نخصم من هذا الرصيد. ثم إنني أضيف لك بُعدًا آخر على درجة كبيرة من الأهمية، وهو مسألة التنوع الاقتصادي والقرب الجغرافي.
المزايا النسبية لا تكفي.. المطلوب خلق مزايا تنافسية حقيقية
ولعلي، مع تقديري ومحبتي لكل البلدان العربية، أستشهد بمثالين لبلدين شقيقين. أحد الزائرين في مطلع السبعينيات قصد بلدين في العام نفسه؛ زار الأشقاء في ليبيا، وزار الأشقاء في الإمارات، وكلاهما كان في بدايات مسار جديد، في ظل صعود أهمية البترول آنذاك. فسُئل: أي البلدين أقدر على الانطلاق؟ فأجاب: لا شك ليبيا. لماذا؟ لأنها على بُعد ساعة زمن من روما، وساعتين فقط من اليونان أو إسبانيا وغيرها من الأسواق الأوروبية. موقعها إستراتيجي على البحر المتوسط، وقريبة من سوق ضخم مجاور هو مصر بما تمتلكه من عمالة وبنية بشرية. أما الإمارات فعدد سكانها آنذاك أقل، وموقعها بدا متطرفًا جغرافيًا. فكان الانطباع السائد أن فرصها محدودة، وأن مسارها لن يكون يسيرًا.
الإمارات خلقت لنفسها مكانة رغم محدودية السكان وبعد الموقع
لكن مرّت السنوات، وجاء الشخص نفسه بعد عقود طويلة ليجد أنّ المعادلة انقلبت تمامًا؛ فقد صنعت دبي لنفسها مكانة لم تكن موجودة. فميناء «جبل علي» على سبيل المثال أعاد رسم خرائط الحركة التجارية العالمية، إذ جعل السفن تُغيّر مسارها الطبيعي لتدخل الخليج العربي، إما لتفريغ حمولاتها أو للتزوّد بالوقود، لا لمجرد الترفيه وإنما لتحقيق منافع اقتصادية واضحة، وذلك بفضل ما أتيح لها من مرافق وبنية تحتية مساندة.

وهنا تبرز الفكرة الجوهرية: حتى وإن لم تسعفك عبقرية المكان بما يُعرف بالمزايا النسبية، يمكنك أن تخلق لنفسك مزايا تنافسية، وهي الأهم. أي أن تقول للمستثمر أو الفاعل الاقتصادي: تعالَ تجد ما يسرك من بيئة استثمارية وتشريعات ومرافق وخدمات. هذا هو التحدي الحقيقي.
مصر لم تستغل طاقات موانئها البحرية في النقل وتداول الحاويات
ومصر تملك مواقع بحرية فريدة على البحرين الأحمر والمتوسط، بموانئ ذات طاقات هائلة، لكن هذه المواقع لم تُستغل بالكفاءة المطلوبة في مجالات النقل البحري وتداول الحاويات. ولو تحقق ذلك، لكان من شأنه إحداث نقلات نوعية في الاقتصاد المصري.
أحمد رضوان: دعني أطرح أسئلة سريعة، فيما يتعلق بمشروع الملكية الشعبية الذي تم طرحه وقت توليكم حقيبة وزارة الاستثمار، هل ترى أنه ما زال يحتفظ بالحيوية التي تجعله قابلًا للتطبيق الآن؟
مشروع الملكية الشعبية يتيح للمواطنين المشاركة المباشرة في الاستثمار
د. محمود محيي الدين: مشروع الملكية الشعبية يتضمن عدة مكونات. أحد هذه المكونات يتمثل في تشجيع الاستثمار المباشر لعموم المواطنين، حتى ولو كانت إمكانياتهم المالية محدودة، بحيث تتاح لهم فرصة المشاركة المباشرة في الملكية، بعيدًا عن النموذج القائم على ملكية الدولة الكاملة أو التصور بأن الدولة تملك كل شيء. لا، هذا ليس نموذج ملكية الدولة، بل هو ملكية للشعب تُدار من خلال آليات جماعية مؤسسية.
طرح حصص 20 – 30% في البورصة أحد آليات الملكية الشعبية
وأنا أؤكد أن هذا الأمر ينبغي أن يكون متاحًا على نطاق واسع، وأن يتوافر له إطار من الشفافية والمشاركة المباشرة، ولو عبر حصص يتم طرحها للتداول في البورصات بنسبة 20% أو 30%، فهذا أحد الأبعاد التي نعمل عليها.
تقييم الأداء يجب أن يكون بمؤشرات يومية
البعد الآخر يتمثل في أن تقييم الأداء لن يتحقق إلا من خلال مؤشرات واضحة ومستمرة، بل يومية وساعية، لقياس أداء الشركات.
حفظ حقوق الأجيال القادمة أولوية.. لا يمكن تسليمهم مؤسسات خاوية
أما البعد الثالث، فهو حفظ حقوق الأجيال القادمة، لا بأن نُسلِّم لهم أعجاز نخل خاوية أو مؤسسات فقدت فاعليتها ونقول: «كانت صرحًا». نعم، قد كانت صرحًا، لكن ماذا عن حاضرها وأدائها الآن؟ هناك بالفعل شركات ومؤسسات كبرى ما زالت قائمة وتعمل بكفاءة، لكننا لا يمكن أن نتجاهل أن هناك استثناءات متكررة في بعض القطاعات تستدعي مراجعة دقيقة.
النشاط الاقتصادي يجب أن يحقق أرباحًا ويوفر وظائف بعيدًا عن الأيديولوجيا
والأمر كله بعيد عن الأيديولوجيا، فهذا نشاط اقتصادي في جوهره، يجب أن يحقق أرباحًا، ويجب أن يوفر فرص عمل، ويجب ألّا يستمر بحيث يتحمل المجتمع كله كلفة خسائره بينما لا يستفيد منه إلا قلة محدودة.
أحمد رضوان: إذن، هذا المشروع ما زال قابلًا للتطبيق؟
مشروع الملكية الشعبية قابل للتطبيق بصيغ متنوعة وبعد مراجعات
د. محمود محيي الدين: نعم، لكن بصيغ متنوعة.
أحمد رضوان: وبمراجعات؟
د. محمود محيي الدين: نعم، نحن نتحدث عن تجربة مرَّ عليها عشرون عامًا. وبالطبع لا يمكن أن تُعاد اليوم بالآليات ذاتها، إذ تراكمت خبرات الزمن والتجربة، وظهرت أدوات أفضل وأكثر تطورًا، بل وطرق جديدة للتداول. في ذلك الحين، كنا نتساءل: كيف يمكن أن نتيح لعشرات الملايين من المصريين المشاركة في التداول؟ أما اليوم، فهناك شركات عالمية يتداول عبر منصاتها مئات الملايين من المستثمرين حول العالم. فما قولك في ذلك؟
أحمد رضوان: هناك الآن الملكية الجزئية للعقار.
منصات عالمية اليوم تتيح لمئات الملايين من المستثمرين التداول حول العالم
د. محمود محيي الدين: نعم، بالضبط.
رضوى إبراهيم: لكن وقتها لم تكن مثل هذه الآليات موجودة.
د. محمود محيي الدين: كانت موجودة، لكننا كنا ـفي الحقيقةـ نسبق عصرنا في اعتماد مثل هذا النظام.
رضوى إبراهيم: صحيح، هذا حقيقي، والزمن أثبت ذلك.
ياسمين منير: نحن أمام طرحٍ سردية اقتصادية وطنية جديدة. كيف تقيِّم الملامح المبدئية التي تم الإعلان عنها حتى الآن؟ شهدنا من قبل أطرًا وخططًا، مثل «رؤية مصر 2030»، وسياسة ملكية الدولة، والخطط الخمسية، فضلًا عن برنامج الحكومة. والفكرة أن هذه السردية الجديدة يُفترض أن تكون بمثابة المظلّة الجامعة لتلك المبادرات، بحيث تُوضع تحتها البرامج التنفيذية بشكل متكامل. كيف ترى ذلك؟
د. محمود محيي الدين: لا أستطيع أن أقدم تقييمًا حقيقيًّا إلا بعد الاطلاع على الصورة الكاملة مكتملة الأركان، وهذا لن يتضح إلا بعد نحو شهرين من الآن.
ياسمين منير: وما توصياتك في هذا الإطار؟
السردية الوطنية لا تكفي ما لم تتحول إلى برنامج تنفيذي واضح بتكليفات محددة
د. محمود محيي الدين: الأهم في تقديري، أن وجود وثيقة متكاملة في شكلها ومضمونها لا يكفي؛ بل ينبغي أن تُترجم هذه الوثيقة إلى برنامج تنفيذي واضح، يتضمن تكليفات محددة لكل جهة مسؤولة عن التنفيذ، وفق آلية صارمة للمحاسبة والمراجعة، مع تحديد توقيتات زمنية دقيقة، وتوفير مصادر تمويل واضحة.
المطلوب مراجعات ربع سنوية لأداء القطاعات
وإذا كان ثمة فائدة مرجوة من علاقتنا مع صندوق النقد الدولي، فهي في الخبرة التي اكتسبناها من تركيزه على جانبي المالية العامة والسياسة النقدية. المطلوب أن نستفيد من هذه الخبرة ونبني عليها، بحيث تُجرى مراجعات دورية ربع سنوية لأداء كل قطاع على حدة: التعليم، الصحة، الزراعة، الصناعة… مع قياس ما تحقق من مستهدفات بدلًا من أن يُترك التقييم لموعد بعيد مثل عام 2030.
عملية التخطيط أهم من الخطة نفسها ويجب أن تكون شاملة وتشاركية
أما النقطة الأخرى، فهي أن الخطط وحدها لا تكفي. ولعل ما قاله الرئيس الأمريكي أيزنهاور يُجسد هذا المعنى: «كل شخص يمكن أن يمتلك خطة، لكن الأهم من الخطة هو عملية التخطيط ذاتها». والمقصود أن العملية التخطيطية يجب أن تكون شاملة وتشاركية، تضم جميع الأطراف المعنية من داخل المنظومة الحكومية ومن القطاع الخاص، بحيث لا تقتصر على جلسات استماع شكلية، بل تتحول إلى عملية تطوير حقيقية. ولنا أن نتخيل كيف يمكن للتقنيات الحديثة، كالذكاء الاصطناعي، أن تُظهر الفارق بين «الوثيقة قبل» و»الوثيقة بعد» في صياغتها وتطويرها، فلا تكون مجرد نصوص جامدة، وإنما نتاج حوار متجدد ومتفاعل.
كذلك، يجب أن تتوافر لهذه الوثيقة مقومات التنفيذ من تمويل، ومنظومات تكنولوجية مساندة، وقدرات مؤسسية مؤهلة، وإطار تشريعي ورقابي محفّز لعمل القطاع الخاص. فقد استمعنا إلى حديث إيجابي عن دور هذا القطاع، وسمعنا تأكيدات متكررة على أهميته، وهو ما كنت أنادي به منذ أكثر من عشر سنوات.
معالجة الاختلالات المالية والنقدية وحدها لا تكفي لتحقيق نقلة تنموية أو مواجهة الفقر
وكنت قد أوضحت منذ بدء برنامج الصندوق أن معالجة الاختلالات المالية والنقدية، رغم أهميتها، لا تكفي وحدها لإحداث نقلة تنموية حقيقية، ولا تستطيع بمفردها أن تُعالج مشكلات الفقر. قلت هذا منذ عقد من الزمن عند انطلاق البرنامج، وأعيد تأكيده اليوم بعد مرور عشر سنوات كاملة.
رضوى إبراهيم: دكتور محمود، هل لا تزال لديكم رسائل للحكومة بعيدًا عن النقاط التي أثرناها في هذا الحوار؟ ثم أود أن نختم برسائلكم الموجهة إلى القطاع الخاص. نحن دافعنا كثيرًا عن القطاع الخاص، وناقشنا ما الذي ينبغي على الحكومة أن تفعله لدعمه، ولكن ما الذي على القطاع الخاص ذاته أن يُراجعه، إذ ربما أساء التقدير أو التحرك، وما الذي يمكن أن يُلفت نظره لتحسين أدائه والوضع العام؟
القطاع الخاص لا يقتصر على كبار رجال الأعمال بل يقوم أساسًا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة
د. محمود محيي الدين: حسنًا، نبدأ بالقطاع الخاص. بدايةً، ما هو القطاع الخاص الذي نتحدث عنه؟ ومن الممكن أن تكون الإجابة رسالة لكم أيضًا على اعتبار أنكم مهتمون بهذا القطاع. علينا أن نُدرك أن القطاع الخاص الذي نتحدث عنه ليس مقتصرًا على القيادات البارزة أو النخب أو كبار رجال الأعمال المعروفين في مجالاتهم. فغالبًا ما يُختزل الحديث عن القطاع الخاص في هذه النماذج، بينما الواقع أن قوام الاقتصاد في الأساس يقوم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومع ذلك، قلما نجد حوارًا جادًّا أو منتظمًا مع التجمعات الممثلة لهذه المشروعات، على الرغم من أنها تتحرك بالفعل في السوق، وقد تُسهم بخيرها أو تضر إذا أُهملت، لكن لا أحد يُوليها القدر الكافي من الاهتمام أو يعرف عنها الكثير.
ومن هنا تأتي أهمية اتحادات الصناعات واتحاد الغرف التجارية، فهي بمثابة المظلة الجامعة لهذه الكيانات، ومن خلال عضوياتها نستطيع أن نطمئن إلى حال القطاع الخاص على نحو أكثر شمولًا وعدلًا، بدلًا من قصر النظر على كبار الفاعلين وحدهم.
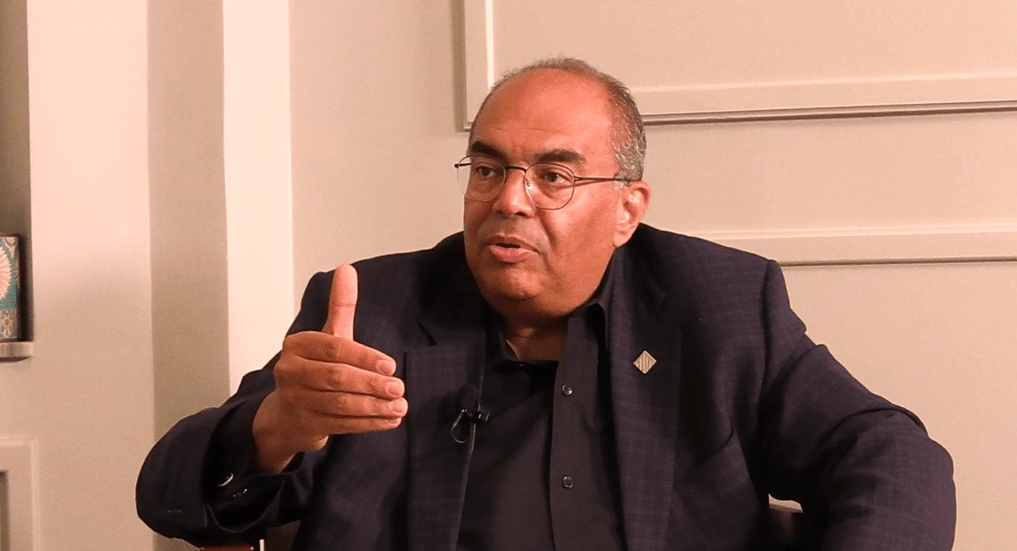
لا يمكن مطالبة القطاع الخاص بمغامرات غير محسوبة أو بترك هدف الربح الأساسي
لا يمكن أن نُطالب القطاع الخاص بأن يخوض مغامرات أو يتحمل مخاطر غير محسوبة، كما لا يمكن أن نطالبه بأن يتخلى عن هدفه الأساسي المتمثل في تحقيق الربح؛ فبدون ذلك لن يتمكّن من البقاء في السوق. إذا لم يجد جدوى اقتصادية أو ربحية اليوم، فلن يكون موجودًا غدًا، بل قد ينسحب تمامًا في غضون عام واحد.
تحميل القطاع الخاص أعباء اجتماعية تفوق طاقته غير منطقي
ومن غير المنطقي أيضًا تحميل القطاع الخاص مسؤوليات اجتماعية تفوق طاقته، أو مطالبته بأن يحل محل الحكومة في أدوارها الجوهرية، فالمسؤولية الاجتماعية للشركات مهمة، لكنها لا يمكن أن تكون بديلًا عن الدور الذي يجب أن تقوم به الدولة عبر الموازنة العامة وأدواتها.
المسؤولية الاجتماعية للشركات مهمة لكنها لا تعوّض دور الدولة
رضوى إبراهيم: هل كان من المفترض أن يكون القطاع الخاص أكثر إصرارًا؟
د. محمود محيي الدين: أكثر إصرارًا على ماذا تحديدًا؟
رضوى إبراهيم: أعني على الاستمرار في التوسع داخل السوق المحلية، بدلًا من اللجوء مباشرةً إلى حلول التوسع الخارجي حتى يتمكّن المستثمرون من الاستمرار.
التوسع الخارجي للشركات محمود إذا كان مدفوعًا بفرص جذب لا بعوامل طرد
د. محمود محيي الدين: لا، بدايةً مسألة التوسع الخارجي أمر محمود إذا لم يكن مدفوعًا بعوامل الطرد، وإنما قائم على الجذب وفرص التوسع الطبيعية. فإذا بلغ المشروع في السوق المحلية حدّه الأمثل أو طاقته القصوى، فلا بأس أن ينطلق إلى الخارج، كما نرى نحن أنفسنا نستضيف استثمارات كبرى لشركات كورية وأمريكية وصينية. ذلك في جوهره توسع خارجي يعود بالنفع على الشركة الأم ومشروعاتها.
لكن في المقابل، نحن بحاجة دائمة إلى أن تتعمق هذه المشروعات وتتسع داخليًّا أيضًا. ولدينا نماذج رائدة جديرة بالاحتفاء، مثل مجموعة العربي، التي بدأت من مشروع متواضع ومحل صغير، ثم تحولت إلى إمبراطورية إنتاجية ضخمة. ولنا أن نتأمل صعوبة الشراكات التي عقدتها المجموعة مع شركات يابانية أو كورية؛ إذ أن هذه الشراكات تتطلب شريكًا محليًّا يعتمد عليه ويتمتع بالانضباط والدقة، وهو ما نجحت فيه بالفعل. وهذه النماذج تعكس قطاعًا خاصًّا عصاميًّا منضبطًا يحتاج إلى المساندة.
الصناعي أحمد عز وجّه رسالة للاتحاد الأوروبي بأن الحماية المفرطة ليست الحل وأن الشراكة أفضل
كما أن هناك مشروعات ليست مجرد معادلة قطاع خاص مقابل قطاع حكومي. على سبيل المثال، كان هناك حديث مهم نُشر للمهندس أحمد عز في صحيفة “فايننشال تايمز”، وهو أحد أبرز الصناعيين في مصر. تحدث فيه عن أن مصلحة مصر وصناعتها تتقاطع مع مصالحها في مواجهة التعنت الأوروبي، خصوصًا في قطاع يُعد من أهم الصناعات التي نفخر بها. وقد وجّه رسالة مباشرة إلى الاتحاد الأوروبي قائلًا: إن الحماية المفرطة ليست هي الحل، بل إن الشراكة الاقتصادية المتوازنة أفضل للجانبين. فالمصنّع المصري هنا يستخدم تكنولوجيا أوروبية متقدمة لإنتاج سلع يصدّرها إلى أوروبا نفسها، فكيف يُواجه بالقيود الحمائية بدلًا من التعاون؟
المصنّع المصري يستخدم تكنولوجيا أوروبية لتصدير منتجاته إلى أوروبا نفسها
هذا النموذج لا يُمثل خروجًا للصناعة المصرية عن إطارها الوطني، بل على العكس، يعكس توسعًا داخليًّا يفتح المجال للتصدير للأسواق الخارجية. ومن هنا تأتي رسالتي للحكومة: بدلاً من أن تنشئ مشروعًا موازيًا أو منافسًا لمثل هذه الكيانات الصناعية، وبدلًا من أن تفترض أن مجرد تحقيق القطاع الخاص لأرباح في صناعة ما -مثل صناعة الحديد- يعني أن على الدولة أن تنافسه فيها، ثم تُفاجأ لاحقًا بأن هذه الصناعة لها خصوصية وخبرة متراكمة، وأن الحسابات المالية الواقعية قد تُظهر خسائر، الأفضل أن تدرك الدولة أن هذا المسار لا يخدم المصلحة العامة. المطلوب إذن هو تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص لخدمة عموم المواطنين.
رضوى إبراهيم: هل تعاملنا بالصورة الصحيحة مع ملف ريادة الأعمال؟
د.محمود محيي الدين: في كثير من الحالات كان التعامل موفقًا، وشهدنا مبادرات جيدة ومتميزة بالفعل. أنا على سبيل المثال التقيت بنماذج رائعة من رواد الأعمال في ما يُعرف بـ”الجريك كامبس” داخل الجامعة الأمريكية. هؤلاء الشباب الذين يعملون على التطبيقات كانوا قد سبقوا غيرهم في الحديث عن الذكاء الاصطناعي قبل أن يصبح موضوعًا شائعًا، وابتكروا حلولًا عبقرية. بعضهم استمر داخل مصر ونجح في التوسع.
الأفضل تعزيز الشراكة بين العام والخاص بدلًا من خلق كيانات حكومية موازية قد تُمنى بالخسائر
وأتذكر حين زرتهم، سألتهم: هل تحتاجون شيئًا من الحكومة؟ حتى إذا ما التقيت بأحد الوزراء أنقل طلباتكم. فجاء ردهم واضحًا: «لا، نحن لا نريد شيئًا سوى أن تتركونا وشأننا. كل ما نطلبه هو انتظام في خدمة الكهرباء، وتوسّع كبير في إمكانات التخزين الرقمي، لأن هذه الصناعة قائمة على سرعة الإنترنت وقدرة عالية للتخزين الرقمي. هذا فقط ما نحتاجه من الدولة، أما الدعم المباشر أو المساندة فلا نريدها. نريد فقط أن نُترك نعمل بسلام.”
أحمد رضوان: على مقياس من 1 إلى 10، حيث تمثل الـ 10 قمة التفاؤل والـ 1 الحد الأدنى، إلى أي مدى تشعر بالتفاؤل تجاه مسار الاقتصاد المصري، بما يشمله من تحركات الحكومة، والقطاع الخاص، والإطار التشريعي، وبيئة الاستثمار؟
د.محمود محيي الدين: أنا متفائل حتمًا، لأسباب قد لا تكون جميعها مستغلة إلى أقصى حد حتى الآن.
أحمد رضوان: على أي درجة؟
د.محمود محيي الدين: أقول لك بوضوح: 10 من 10. أنا متفائل بعشرة كاملة.
ياسمين منير: حتى في ظل هذه التغيرات الاقتصادية والاضطرابات القائمة؟
د.محمود محيي الدين: نعم، رغم كل التغيرات الاقتصادية. ولسبب واحد أعتبره جوهريًّا وأختم به، وهو ما أعمل عليه حاليًا. نحن تعلمنا الاقتصاد ودرّسناه وفق مناهج القرن التاسع عشر والعشرين، لكن الاقتصاد الجديد يقوم على البشر والأفكار وأشياء أخرى مكملة مما تحدثنا عنه. المشكلة أننا لم نتحدث بما يكفي عن البشر ولا عن الأفكار، وانشغلنا فقط بالأشياء الأخرى.
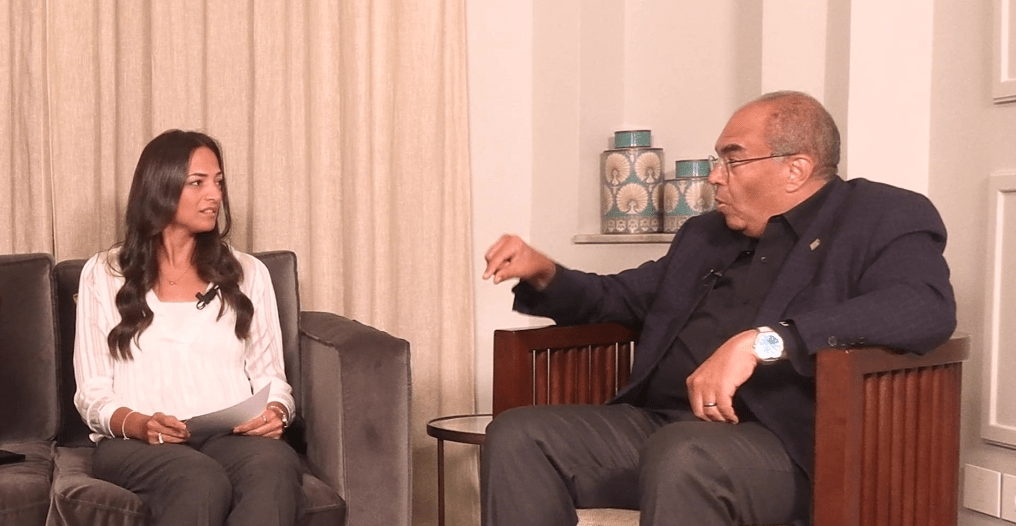
رضوى إبراهيم: لأنها هي التي كانت تعطّلنا.
د.محمود محيي الدين: نعم، ولكن عليك أن تدرك أن لديك زخمًا بشريًّا هائلًا وقوة معتبرة في هذا البلد. وللأسف كثيرًا ما يُختزل الحديث في صيحات التحذير: «الزيادة السكانية» و»التعداد السكاني» وما إلى ذلك. بينما الحقيقة أنك تمتلك عددًا من البشر يغبطك عليه الصديق ويحسدك عليه المنافس.
رضوى إبراهيم: إضافة إلى أن التركيبة السكانية يغلب عليها عنصر الشباب.
د.محمود محيي الدين: بالضبط، لدينا تركيبة سكانية شبابية، ومعها الطبيعة المصرية المتفردة؛ طبيعة لا تعرف الجمود، فهي بطبيعتها تسعى دومًا للابتكار، وللتطوير، ولخلق الجديد.
أحمد رضوان:هناك شغف فطري بالتعليم والتعلم.
د.محمود محيي الدين: بالضبط، وهذا هو الأساس الذي يجب البناء عليه. نحن الآن أمام عالم جديد يتشكل حول الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. وقد لمست ذلك بوضوح في المبادرة المعتبرة التي جرت برعاية فخامة الرئيس، وهي مبادرة المشروعات الخضراء الذكية. فعلى الرغم من التحديات الاقتصادية المعقدة التي واجهتها البلاد في أعوام 2022 و2023 و2024، تقدّم أكثر من 18 ألف مشروع من مختلف الأحجام والأنماط، ومن جميع المحافظات السبع والعشرين. مشروعات بأفكار خلاقة؛ بعضها بدأ بالفعل في السوق ويشهد توسعًا، وبعضها يتطلع للتواجد في أسواق إفريقيا وآسيا وأوروبا.
وفي ظل هذه الظروف، رأينا مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، يقود الكثير منها شباب ونساء، وتهتم جميعها بخدمة البعد البيئي والاجتماعي. هذه التجربة تقول بوضوح إن هذا البلد لا توقفه معوقات أو عراقيل إلا إذا اختار الاستسلام لها. فالمقومات متوافرة: تنوع بشري هائل، أفكار مبتكرة، وطاقات كامنة، وما تبقى فهو «أشياء أخرى» تأتي حين تتجسد الإرادة الحقيقية للتغيير.
أحمد رضوان: نحن في غاية السعادة بهذا الحوار، بل ونشعر أننا لم نكتفِ بعد، لكننا ندرك حجم التزاماتك، ولذا مضطرون لإنهاء جلستنا.
د.محمود محيي الدين: إلى حوار آخر بإذن الله.
أحمد رضوان: على أمل أن يكون قريبًا.
د.محمود محيي الدين: عندها ستكون أفعال وأسئلة جديدة. وأرى أن لديكم بالفعل أسئلة لم تُطرح بعد، يمكن أن نعود إليها في لقاء لاحق، ربما بعد الإعلان عن السردية الوطنية وبرنامجها التنفيذي، لنتبين إن كان برنامجًا جادًّا راسخًا، أو أنه ما زال بحاجة إلى مزيد من التطوير.
رضوى إبراهيم: نعتبر هذا وعدًا إذن.
أحمد رضوان: نشكر الدكتور محمود محيي الدين، وإلى لقاء آخر في صالون حابي.