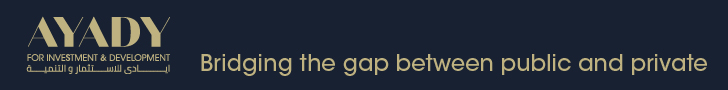د. محمود محيي الدين يكتب.. عن إصلاح مسارات التعافي المعوجة
بقلم محمود محيي الدين الخبير الاقتصادي المصري نقلا عن الشرق الأوسط – هكذا اجتمعت مجموعة الدول السبع في قمة ضمت قادتها في كورنوال المطلة على الساحل الجنوبي الغربي لإنجلترا على مدار ثلاثة أيام. وجاءت القمة الأخيرة بعد فترة من تعثر هذه الاجتماعات في السنوات الماضية وعجزها عن التوصل لنتائج تُذكر، حتى انتهت إحداها في عام 2019 بدون بيان مشترك لفشلها في الاتفاق حول موقف موحد من قضايا التجارة العالمية.
وقد كانت نشأة المجموعة في أوج الحرب الباردة لتتبنى سياسات مشتركة في مواجهة الاتحاد السوفياتي والمعسكر الشرقي ولتتيح لمؤسسيها فرصاً للتعاون والتنسيق في مواجهة الركود المصاحب بتضخم خصوصاً بعد ارتفاع أسعار البترول في أعقاب ما اتخذته منظمة أوبك من إجراءات لحظر تصدير النفط إبان حرب أكتوبر 1973.

أسست المجموعة ست دول في عام 1975 وهي الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان وإيطاليا وألمانيا الغربية، ثم انضمت لهم كندا كدولة سابعة بعد عام، ثم شارك في اجتماعاتها الاتحاد الأوروبي منذ عام 1981.
وعند بداية هذه المجموعة، التي كانت توصف بالسبع الصناعية الكبرى، كان نصيبها من الاقتصاد العالمي يتجاوز 70 في المائة، أما اليوم فنصيبها يقل عن 45 في المائة منه بعد تصاعد نمو الصين والهند وغيرهما من دول الجنوب والأسواق الناشئة؛ ووفقاً لمعادل القوى الشرائية فنصيب هذه الدول من الناتج العالمي لا يتجاوز 30 في المائة.
ورغم وصفها بالصناعية فنسبة إسهام قطاع الصناعة في اقتصادات هذه الدول في تراجع مستمر إذ لا يتجاوز على سبيل المثال 19 في المائة في حالة المملكة المتحدة – الدولة المضيفة لقمة هذا العام.
ما يجمع هذه الدول السبع حقاً هو استنادها إلى مبادئ ديمقراطية مشتركة، أكثر مما تبقى لها من هيمنة اقتصادية تذكر، كما أشار لذلك اللورد جيم أونيل، وهو الاقتصادي البريطاني الذي صاغ مصطلح «البريكس»، الذي يضم الأحرف الأولى من البرازيل وروسيا والهند والصين، في عام 2001 مستشرفا دورهم المتصاعد في الاقتصاد العالمي وهو الذي ما زالت تتمتع به مع تفاوت في الإسهام وبتميز واضح للصين التي تحتل اليوم المركز الثاني في الاقتصاد العالمي والمركز الأول في التجارة وجذب الاستثمارات.
وبالتالي تبدلت أرضية المقارنة لهذه المجموعة كسبع دول صناعية رأسمالية كبرى مقابل المعسكر الشيوعي الشرقي، إلى التركيز على أنها مجموعة ديمقراطية تواجه دولاً ذات نظم أوتوقراطية أو سلطوية وفقاً لما هو صادر عن المجموعة.
عُقدت القمة الأخيرة في أجواء احتفائية بعودة الولايات المتحدة لصدارة المشهد كما وعد رئيسها جو بايدن، وانتهت بصدور تعهدات في مجالات توفير اللقاحات وجهود التعافي من وباء «كورونا»، والتعامل مع أزمة تغيرات المناخ وتعافي كوكب الأرض من العلات البيئية، والتعاون في تعافي الاقتصاد العالمي على النحو الآتي:
أولاً، التعافي الصحي: تعهدت المجموعة بتوفير مليار جرعة من اللقاح للدول النامية ورغم كبر الرقم فإنه لا يلبي الاحتياجات الفعلية والتي قدرتها منظمة الصحة العالمية بمقدار 11 مليار جرعة للسيطرة على الوباء.
كما أن الفترة الزمنية التي سيستغرقها توفير اللقاح المقدرة بثمانية عشر شهراً أطول مما تستهدفه الدوائر الصحية بالوصول لرقم من يتم تلقيحهم فعلياً إلى 40 في المائة بنهاية هذا العام و60 في المائة مع منتصف العام القادم. واستغراق فترة أطول يعني مزيداً من المصابين والضحايا وإرهاقاً للنظم الصحية واحتمالات أكبر لمزيد من تحورات الفيروس المقاوم للقاحات المتعارف عليها وتعطلاً في مجريات الحياة والنشاط الاقتصادي بما يهدد أيضاً ما شهدته مجموعة الدول السبع من تحسن نسبي في مؤشرات صحتها العامة واقتصادها.
كما أن عدم النص صراحة على الإعفاء المؤقت من قيود حماية حقوق الملكية الفكرية لأغراض توفير اللقاح يعوق توفير اللقاحات بتصنيعها في البلدان النامية. ونؤكد هنا ما ذكره مارك لوكوك، منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة بالأمم المتحدة، من أن قيام الدول المتقدمة بتقديم العون في مكافحة الوباء يتضمن ضرورة لحماية لمصالحها وليس فقط من موجبات الإخاء والتعاون الإنساني.
ثانياً، تغيرات المناخ وتعافي الأرض: تشكل عودة الولايات المتحدة لاتفاقية باريس لتغيرات المناخ الموقعة في عام 2015 سنداً مهماً لجهود المجتمع الدولي في هذا الشأن.
وكان من المتوقع أن تقدم القمة المزيد من المساندة الممهدة لإنجاح قمة الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو هذا العام، ولكنها لم تأت بجديد بشأن التعهدات المالية المعلقة منذ قمة كوبنهاغن لعام 2010 لتوفير 100 مليار دولار توجه للدول النامية لتمويل مشروعات إعادة الهيكلة المطلوبة للتصدي لتغيرات المناخ، خصوصاً في مجالات الطاقة والبنية الأساسية والمياه والزراعة والتوافق البيئي لقطاعات الصناعة والنقل.
كما أن الاجتزاء المستمر للاستدامة في قضايا المناخ مع تجاهل قضايا التنوع البيئي والتلوث وعدم تحقيقها في إطار عملي لتحقيق التنمية المستدامة يهدد إمكانية تحقيق أهداف تغيرات المناخ إذا لم يصحبها قضاء على الفقر وسيطرة على عدم العدالة في توزيع الدخول وزيادة البطالة.
وقد حذر تحليل نشرته صحيفة الفاينانشيال تايمز في مطلع هذا الشهر من أن عدم مراعاة تسعير الكربون لقواعد إدارة التحول العادل في الاتحاد الأوروبي، سيؤثر سلباً على الفقراء في دوله وهو ما يؤكد على ما طالبنا به من ضرورة فض الاشتباك غير المبرر بين أهداف التنمية المستدامة من ناحية وأهداف تغيرات المناخ في إطار منضبط من السياسات العامة وتمويلها.
ثالثا استمرار مساندة التعافي الاقتصادي: تشير توقعات البنك الدولي وصندوق البنك الدولي إلى أن نمو الاقتصاد العالمي سيتراوح بين 5.6 في المائة إلى 6 في المائة في هذا العام معوضاً ما خسره العام الماضي بعد ركود وانخفاض النمو إلى سالب 3.3 في المائة.
ولكن هذا النمو سيكون متبايناً معوجاً مصاحباً بمزيد من تفاوت الدخول والثروات وقلة في توليده لفرص العمل بعد زيادة البطالة من جراء الجائحة. وقد أحسنت هذه القمة فيما يلي:
1- تأكيدها على ما بدر من وزراء مالية المجموعة بمساندة إصدار ما يعادل 650 مليار دولار من وحدات حقوق السحب الخاصة تضاف للسيولة الدولية واحتياطيات البنوك المركزية بنسبة 95 في المائة من حصة كل دولة من الدول الأعضاء بصندوق النقد الدولي.
2- تأييدها لتدعيم موارد صندوق مساندة الدول الأقل دخلاً بصندوق النقد الدولي.
3- إعطاؤها إشارة خضراء لإنشاء صندوق جديد يخصص لجهود التعافي ومرونة الاقتصادات واستدامتها في الدول متوسطة الدخل.
4- تدعيمها لجهود التعاون الضريبي بين الدول ووضع حد أدنى للضرائب بمقدار 15 في المائة على الشركات الكبرى دولية النشاط وربطها بمصدر تحقيق الأرباح وليس بمركزها في الدولة الأم. وهي بداية مطلوبة لتفعيل التنسيق المانع لمزيد من تسرب الأموال من الدول النامية إلى الملاذات الضريبية الآمنة سواء بطرق مشروعة أم من خلال الاحتيالات للتهرب الضريبي، هذا بالإضافة إلى تدفقات الأموال غير المشروعة من الدول الأفقر للأغنى.
وقد كان من المأمول أن تسفر هذه القمة عن مساندة فعالة للنظام التجاري الدولي، لكنها اكتفت بذكر عبارات فضفاضة عن تجارة أكثر عدالة وإحالة الأمر لمشاورات مجموعة العشرين، واجتماع وزراء التجارة القادم في نوفمبر (تشرين الثاني) في إطار منظمة التجارة العالمية.
كما لم تعلن القمة أي مبادرة لاحتواء تفاقم المديونيات الدولية أو الإعفاء منها أو التصدي لاحتمالات زيادة مشكلات التعثر وعدم السداد مع زيادة تكاليف الاقتراض، كما لم تشر إلى تطوير مطلوب في آليات إعادة هيكلة الديون المتعثرة وتسويتها.
وقد قوبلت نتائج القمة بمزيج من القبول لبعضها لإيجابيته، والإحباط لتواضع ما انتهت إليه في بعضها الآخر، فضلاً عن التخوف مما ستؤدي إليه توصيات صدرت عنها بشأن الاستقرار الدولي خصوصاً فيما يتعلق بسبل معالجتها للصعود الصيني بما يعنيه من تصاعد للتوجهات الحمائية.
وقد اشتركت هذه القمة مع قمم سابقة من قبل، لأن قراراتها جاءت في شكل تعبيرات إنشائية وتوصيات دون مساندة عملية أو مالية إلا قليلاً، بما يتطلبه ذلك من متابعة لآليات التنفيذ. بما يؤكد أن عبء تصحيح مسارات التعافي المشار إليها يعتمد في نهاية الأمر على قدرة كل دولة في تعبئة إمكانياتها الوطنية وتفعيل مشاركاتها التنموية سواء مع مجموعة الدول السبع أم غيرها.