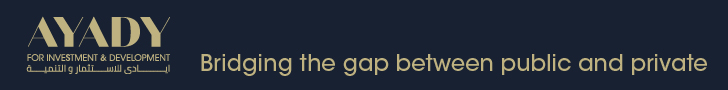بقلم د. محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي
تباينت ردود الأفعال بعد اتفاق الأحد الماضي، بين رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي ونظرائها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على قواعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد، في التاسع والعشرين من مارس من العام المقبل.

فقد أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن حزنها لرحيل بريطانيا من الاتحاد، وهو ما شاركها في التعبير عنه باقي الزعماء الأوروبيين بكلمات مختلفة، دارت حول «ورقة الطلاق التي وقعت في يوم الأحد القاتم».
لكن ذاك الأحد ستتلوه أيام وآحاد أخرى، قاتمة وغير قاتمة، ستحاول خلالها حكومات الاتحاد الأوروبي إقناع برلماناتها بأنها وصلت للاتفاق الأفضل لهذا الانفصال. وسيحاول البرلمانيون استقاء رأي ناخبيهم بشأنه لأهميته، إذ يعتبر تصويت مجلس العموم البريطاني في 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أهم تصويت يتم في التاريخ المعاصر للمجلس العتيد.
المناصرون للاتفاق من البريطانيين مقتنعون بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاق، أفضل من الخروج بلا اتفاق، وهو ما أكدته دراسات كثيرة، وإن اختلفت تقديراتها، من أن الخروج بشروط يتم التفاوض عليها، أقل عبئاً من ترك الأمر للتخارج وفقاً لترتيبات منظمة التجارة العالمية.
ومن المناصرين للاتفاق من يعتقد بأن بريطانيا يمكنها الاستفادة من المنافع الاقتصادية للسوق الموحدة، من خلال ترتيبات التجارة الحرة، دون تحمل أعباء سياسية أو موضوعات خلافية، مثل السياسات الزراعية، أو تدخل المفوضية الأوروبية وبيروقراطيتها الضخمة في الشؤون المحلية وأمور السيادة.
أما الرافضون للاتفاق فهم فرق مختلفة، وإن اتفقت على رفض الاتفاق. ففريق لا يعترف بأن الخيار هو فقط بين خروج باتفاق أو خروج من دون اتفاق، فهناك في اعتقادهم خيار البقاء من خلال إجراء استفتاء آخر.
وهناك فريق يتحفظ على تفاصيل الاتفاق، وفريق آخر يرى أن هذا الاتفاق لا يرتب إلا قواعد الانفصال وتكلفته، وكان من الواجب أن يتم التفاوض على بنوده مع بنود التعاون في المستقبل بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. يعضد هذا ما قد يكتنفه تطبيق إجراءات بعض الملفات البينية التي تخص بريطانيا مع دولة بعينها أكثر من غيرها من دول الاتحاد، مثل ملف الحدود مع آيرلندا، وملف صيد الأسماك مع فرنسا، وملف الوضع الخاص لجبل طارق مع إسبانيا، فضلاً عن بعض الملفات الأخرى التي تتطرق لموضوعات محلية سياسية واقتصادية، قد تثار مستقبلاً.
ربما يكون تعليق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد اتفاق يوم الأحد، بقوله بأن «أوروبا هشة» وبأن «الاتحاد الأوروبي يجب ألا يؤخذ كمعطاة»، مدخلاً للنقاش حول الاتحاد الأوروبي نفسه ومستقبل أوروبا. فلأسباب اقتصادية طرح سؤال من سنوات، وفي وقت سابق على ملحمة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، فيما عرف إعلامياً بـ«الجركزيت» عن احتمالات خروج اليونان من الاتحاد، لعدم وفائها بمتطلباته، ولحاجتها لعملة وطنية تمنحها مرونة في صياغة سياستها النقدية، لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وقد أسهم العون الضخم الذي حصلت عليه اليونان في غلق، أو على الأقل إرجاء النقاش حول هذا الأمر. وظهرت أعراض أو تهديدات الخروج من الاتحاد الأوروبي من حين لآخر؛ خاصة مع المناسبات الانتخابية المختلفة، ولم يعد الأمر يتعلق بالأمور الاقتصادية.
ولعله من المفيد القول بأن الاتحاد الأوروبي هو مشروع سياسي بالأساس، خرج من خبرة ويلات الحرب العالمية الثانية، بأن يجعل السلام قوياً مستقراً بين قوى أوروبية تصارعت، وحارب بعضها بعضاً، وخلفت ضحايا من عشرات الملايين من البشر، ودمرت ما استغرق إعادة بنائه سنوات طويلة. وأسفرت الحرب عن نظام دولي جديد، لم تعد لأي دولة أوروبية منفردة فيه مكانتها في الصدارة العالمية التي كانت لها قبله.
وفي تقديمي لكتاب قمت بترجمته للغة العربية، تحت عنوان «أوروبا: تاريخ وجيز»، للمؤلف الأسترالي جون هيرست، وصفت في هذا التقديم ما يأتي من كلمات لما آلت إليه الأوضاع في أوروبا المعاصرة، بإجراء مقارنة بين مقدمة تقرير الاتحاد الأوروبي عن «استراتيجية الأمن الأوروبي» الصادر في عام 2003، ومقدمة تقريره الصادر في عام 2016. ففي التقرير الأول تقول مقدمته: «لم تكن أوروبا أبداً أكثر رخاء أو أمناً أو حرية».
وعلى النقيض من ذلك يذكر التقرير الثاني، الصادر بعد ثلاثة عشر عاماً من التقرير الأول، أن أوروبا «تعيش (أزمة وجود) سواء في داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه، فاتحادنا مهدد، ومشروعنا الذي حقق سلاماً غير مسبوق ورخاء وديمقراطية، أمسى محل تساؤل بشأن مستقبله».
إن هذا التقرير يسرد أسباب هذا التراجع العنيف والاختلاف البين، ويقدم تفسيراً لمخاوف الرئيس الفرنسي الحالي. فبعد الأزمة المالية العالمية، التي اندلعت في عام 2008، فقدت أوروبا عقداً كاملاً من النمو، وتعرضت لأحداث إرهابية في عمق أرضها، هذا فضلاً عن مخاطر أزمة تغيرات المناخ، وتحديات أخرى لعل من أهمها التحديات الجيوسياسية والمنافسة في إطار العولمة.
وتعاني أوروبا من مشكلتين هيكليتين: الأولى ترتبط بالتركيبة السكانية التي تنزع متوسطات الأعمار فيها إلى الكبَر، وقد عالجت الهجرة إلى أوروبا، وكذلك نزوح اللاجئين إليها هذه المشكلة جزئياً، كما حققت فوائد اقتصادية نتيجة لزيادة الطلب وإكساب سوق العمل بعض المرونة.
لكن هناك تأثيرات اجتماعية وثقافية يبالغ البعض في استغلالها سياسياً، خاصة مع تصاعد تأثير اليمين المتطرف. ولك أن تقرأ مثلاً كتاب دوغلاس موراي، تحت عنوان «الموت الغريب لأوروبا» الذي يعرب فيه عن هواجس من تداعيات تدفق المهاجرين، التي لخصها باستشهاده الدرامي بمعضلة «سفينة ثيسيوس» في الفلسفة الإغريقية، والتي تناقش مسألة الهوية. إذ تضرب هذه المعضلة مثلاً بسفينة بُدلت أجزاؤها القديمة بأخرى جديدة، فهل تظل هي نفسها السفينة القديمة؟ أم هي جديدة تماماً لا علاقة لها بالأصل، وإن أقيمت على هيكله القديم؟ وستظل عملية إحداث توازن بين المكاسب والتكاليف الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية للهجرة، أمراً شاغلاً للسياسة الأوروبية الداخلية والخارجية.
أما المشكلة الثانية فهي تتعلق بتراجع الإنتاجية، وانخفاض كفاءة كثير من المشروعات وقطاعات الإنتاج في أوروبا. وهي مشكلة تتفاقم مع مرور الوقت؛ حيث ترتفع تكلفة الإنتاج والأجور، من دون زيادة مناسبة في العائد والقيمة المضافة، خاصة بالمقارنة مع الدول البازغة اقتصادياً، وما تفرضه تحديات الثورة الصناعية الجديدة المرتبطة بمنجزات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وإحلال آلات متطورة التقنية وأقل تكلفة وأكثر إنتاجية، محل عمال أكفاء ومهنيين مهرة.
استعرض تيموثي سنيدر، أستاذ التاريخ بجامعة «ييل» الأميركية، في كتابه الأخير عن دروس من القرن العشرين، كيف أن التاريخ الأوروبي يظهر إمكانية «انقسام المجتمعات وانهيار الديمقراطيات وسقوط القيم، ليصبح عموم الناس يوماً فيجدون أنفسهم واقفين أمام حفر الموت والبنادق بأيديهم».
ويحذر سنيدر من التوهم بأن الديمقراطيات المعاصرة تحمي مواطنيها تلقائياً من هذه التهديدات؛ بل يجب العمل جماعياً على حماية مؤسسات الدولة حتى لا تسقط سريعاً واحدة تلو الأخرى، مثلما حدث من قبل، وكان يظن بها قدرة فذة على الصمود والثبات. وبمثل هذه الكلمات تتردد بقوة على المسامع مقولة الفيلسوف الألماني هيغل: «إننا نعلم من التاريخ أننا لا نتعلم منه».